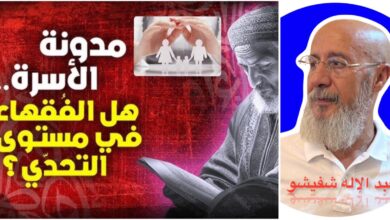سباعية العد العكسي (3) التعاقد حول الملكية البرلمانية تأمين قرن من الزمن السياسي للأجيال المقبلة
في قلب الاوضاع 52 بقلم أحمد الخمسي

مستهلكو الأخبار قد يتسلّون أو يحزنون حسب الحدث، ثم عندما تنهار أعصابهم، ينتقلون إلى موقع آخر أو قناة أخرى أو قد يغادرون الواقع الافتراضي للمشي قليلا في الزقاق نحو أقرب دكان لاقتناء قنينة كوكاكولا.
أما صناع الأوطان وبناة الأنظمة وحاملو هموم الشعوب، فيراجعون الخرائط ويبحثون في المكتبات عن وسائل إثبات لصلاحية تعاقد سياسي طويل الأمد.
فبناء منظومة سياسية حول الملكية البرلمانية اليوم تقتضي مراجعة النفسيات والحيثيات والصراعات والثقافات التي بنى عليها الاتحاد الاشتراكي المبدأ والموقف سنة 1978. فالدولة ليست هي نفس الدولة واليسار في سنة 2023 ليس هو يسار سنة 1978. خصوصا وقد خُيّل ساعتها أن أوربا مهبط الحلول، كما كان تأثر اليسار بالغرب لم يشهد بعد زلزال الاتحاد السوفياتي الذي انهار بعد عشر سنوات من ذلك.
ومن يُبقِي على الخصومة المزمنة بين الدولة والمجتمع اليساري، الموروثة عن خطاب القرن العشرين الباباغاوي فليتذكر أن فرنسا الأبية اليوم هي التي تقود اليسار لا الحزب الاشترا كي ولا الحزب الشيوعي.
***
ليست الملكية المغربية مجرد طارئ على الساحة السياسية مثل عائلات تبوأت العرش بداية القرن 19 أو العشرين ثم ذهبت مع الرياح. خديوي مصر (1800-1952)، السنوسي في ليبيا (1953-1969)، شاهٍ شاه إيران (1925-1979)، هيلاسي لاسي إثيوبيا (1927-1974)، بل مؤسسة صيغت في البداية من الذهب الأمازيغي والفضة العربية، بحيث تتناسل العائلات الحاكمة من هذا المزيج الضارب في عمق الزمن قرونا. بل تقمصت العصبية القبلية الامازيغية الصنهاجية المرابطية والمصمودية الموحدية والزناتية المرينية الصيغة الثالثة من دياليكتيك التوحيد المشرقي الاسلامي، وعندما اسنتفذت العصبية دورها وطاقتها جددت دماءها من نفس نبع المدينة المنورة تحت يافطة الاشراف من صلب السفح الشرقي للأطلس بتافيلالت لتضخ طاقة الدفاع عن الكيان ثنائي المعدن، بحيث امتد النفوذ وعموده الفقري السيادة السياسية، من سراقسطة شمال اسبانيا إلى تومبوكتو جنوب مالي، ومن آسفي على المحيط الاطلسي إلى برقة. وبين برقة وبرشلونة الكاطالانية “برشة، برشة” مسافة بآلاف الكيلومترات. مؤسسهما قرطاجني واحد، ووارثه مغربي.
مثل الاديان الثلاثة، أصبحت الامبراطورية الشريفة الصيغة الثالثة للامبراطوريات السابقة= الفراعنة بداية التاريخ القديم، والرومان بعدهم، وفي آخر القرون الوسطى أصبح المغرب اللاعب الثالث رفقة الاسبان والعثمانيين، ما بين البحور الملونة، الحية والميتة، في المشرق، إلى سواحل الأبيض المتوسط، انتهاء ببحر الظلمات الاطلسي.
***
ألّف أحدهم كتابا تحت عنوان “دراسة تحليلية للثورات”، قضى سنوات لدراسة الثورات الأربع التي جرت من 1668 (“الثورة المجيدة” البريطانية) ثم الأمريكية (1776) ثم الفرنسية (1789) ثم أخيرا الروسية (1917). من التفاصيل، أن أقدمهم(البريطانية)، أكثرهم توازنا (بين سيادة الدولة وسيادة الشعب)، وأسبقهم إلى حسم مسألة الإصلاح الديني، وحيث استمر الحراك الشعبي مرة كل ثماني سنوات، خلال عشرة قرون.
***
عندما حلت اتفاقيات ويستفاليا لتبعد فضول الكنيسة عن شؤون الدولة الوطنية، كانت انجلترا غير معنية، لأنها شعبيا ورسميا من قبل أرست كنيستها الوطنية أصبح الملك الانجليزي أميرا للمؤمنين فيها بعيدا عن تدخل البابا من خارج الحدود. من هذه الزاوية يمكن إجراء مقارنة مع المغرب الذي تمكن من إرساء المذهب المالكي حيث السلطان أمير المؤمنين بحيث صعب على الخليفة العثماني المس بالسيادة المغربية.
ويوم تأثر الملك الانجليزي بجبروت جاره الفرنسي، لويس الرابع عشر، انزلق نحو المذهب المسيحي الكاثوليكي غير الوطني، وترك مذهب شعبه البروتستانتي، فثار عليه شعبه. فكانت “الثورة المجيدة”. ، السلطان اسماعيل الذي كان يحكم ساعتها، لم يحرر فقط طنجة من الانجليز، بل كان له- حسب دوكاستري- موقف من “الثورة المجيدة” لفائدة الشعب الانجليزي ضد جاك الثاني.
***
نحن الذين استهلك مثقفونا الحداثيون القراءة الفرنسية ذات الخلفيات الاستعمارية لغسل دماغنا قبل هزمنا عسكريا من بعد، بقينا إلى اليوم، نرى نظامنا الملكي، بالمنظار اليعقوبي، الذي يرى أن لا ديمقراطية سوى مع الجمهورية، واليعقوبيون الفرنسيون في ذلك خلطوا بين الشوفينية الوطنية التي جعلتهم ينقلون الصيغة الامريكية قصد معاداة أنجلترا في كل شيء. علما أن الرأي العام الفرنسي، يفضل الملك هنري الرابع على كل رؤساء فرنسا وملوكها. كما أن ملوك فرنسا اقترفوا في حق شعبهم ما لم يقترف لا في انجلترا ولا في المغرب قط. عاشت فرنسا ثمانية حروب أهلية خلال القرن 16، بحيث ارتكب الملك شارل التاسع مذبحة في حق الفرنسيين، عُرفت بِلَيْلَةِ الخناجر وليلة سان بيرطولومي (1574)، مات بعدها بسنتين بسبب أزمة الضمير، من فرط ما سال من الدماء في شوارع باريس تلك الليلة غدرا.
يذكر دوكاستري رسالة بعثها السلطان اسماعيل العلوي المغربي إلى الملك الانجليزي (جاك الثاني) الذي ثار عليه شعبه في “الثورة المجيدة” ويلومه على خروجيه عن مذهب شعبه.
***
بالتأمل في مثلث المغرب وانجلترا وفرنسا نهاية القرن 17، عند المقارنة، نجد ما يلي=
في فرنسا كان الملك لويس الرابع عشر دكتاتوريا نموذجيا، بحيث ألغى (1685)العقد الاجتماعي الذي يرسي التسامح بين الاغلبية والاقلية (مجمع وفتوى نانط 1598 ). وفرض المنفى على 10 في المائة من السكان. والقرينة السيادية والفقهية التي تؤكد صواب موقف السلطان اسماعيل، هو أن الملك هنري الرابع لما أصبح بموجب قواعد وراثة الملك في فرنسا وليّا للعهد، خضع للموقف النظري الذي عبر عنه السلطان اسماعيل فيما بعد، القاضي أن يصبح الملك على مذهب شعبه، فخضع الأمير هنري ولي العهد لمراسيم الكاثوليكية المذهب الرئيسي في فرنسا، بعدما كان بروتستانتيا، وبذلك استكمل شروط ولي العهد الشرعي الذي من حقه تقلد مهمة الجالس على عرش فرنسا. ومباشرة عقد مجمع نانط (1598)، وأرسى عقد التسامح بين الأغلبية الكاثوليكية، والأقلية البروتستانتية، والمساواة في الحقوق والواجبات.
أنجلترا التي كانت تعيش من قبل توازنها الوطني تململ ملكها وخرج عن مذهب الشعب ففقد العرش هاربا الى المنفى الفرنسي عند الملك الذي نفى عُشُرَ مواطنيه. عبر رسالة السلطان اسماعيل وملخصها بشهادة دوكاستري، أن سلطان المغرب قدّم للملك البريطاني المنفي بسبب ثورة شعبه عليه نصيحة العودة إلى مذهب شعبه.
***
بهذا الحدث السند التاريخي، تكون سيادة الدولة المغربية منذ ذلك الحين من سيادة الشعب. ولأن اتفاقيات ويستفاليا الأوربية (1648)، قد أقرت مبدأ “الناس على دين ملوكها”، كان المغرب متقدما خطوة نحو السيادة الشعبية لأن نظامه استند على مبدأ “السلاطين على دين شعوبهم”. هذا التقدم التاريخي الذي استند عليه الملوك العلويين، لا يمكن لكبرياء الاستعمار الفرنسي أن يعترف به عبر التحاليل العامة في الفكر السياسي الفرنسي المأزوم اليوم. لكن الإدارة الاستعمارية لم يغب عنها هذا الرسوخ التاريخي بين العرش والشعب. لذلك أرسلت هوبير ليوطي الذي جرّبَ – من قبلُ- الإدارة الاستعمارية في بلد من بلدان جنوب شرق آسيا= الكامبودج. حيث لم يتمكن الفكر السياسي الجمهوري اليعقوبي الفرنسي من إضعاف العلاقة الوطيدة بين الشعب والملك.
***
ولأن هذا الأمر في السيادة كان محسوما، لوحظ أن المغاربة لا ينقلبون على شرعية الأسرة الحاكمة لأن أمراءها يلتزمون جميعا بمذهب الشعب، المذهب المالكي. والأحداث التاريخية تؤكد هذه القاعدة. فرغم تمدد أزمة الحكم نصف قرن بعد وفاة السلطان اسماعيل، لم يمس الشعب شرعية عترته من بعده. وأما الحالة الثانية الدالّة على نفس التوجه التعاقدي، ففي عهد السلطان سليمان، رغم انهزامه العسكري أمام قبائل زايان، لم ينقلب الناس على شرعية السلطان، واختار السلطان من يقود الاستمرارية بعده. ومع ذلك كان السلطان سليمان، بفضل تفقهه في الشريعة التي منها كانت القوانين تستمد، حاجج علماء فاس بصدد فتوى عنصرية تمييزية ضد المغاربة اليهود بحيث أصدر العلماء الفقهاء فتوى تحرم (=تمنع قانونيا) ممارسة المغاربة اليهود للتجارة، فسرد عليهم جواز التجارة لكل أبناء المغرب، بدليل وفاة الرسول، ودروعه رهينة عند السموأل.
***
فمن تقاليد السيادة الشعبية إنتاج قواعد النظام العام، ومن الاختصاصات المسندة إلى السلطان سيادة الأمة (الدولة+ الشعب). وضمنها يؤدي السلطان مهمة الحَكَم بين فرقاء السيادة الشعبية، فيجتهد كي يفسر قواعد النظام العام بما يرفع الضرر عن الجزء المتضرر من أبناء الشعب. وهذا التدخل الذي قام به السلطان سليمان، ليلغي فتوى (= نص تشريعي من أهل الحل والعقد) الفقهاء، تجد صوابها في كتاب الدماغ الذي أفرز العقل العادل في الثورة الأمريكية، طوماس بين(= الفطرة السليمة). الذي يختار الباحثون من كتابه المعادلة التالية التي تلخص الترابط الأبدي بين المجتمع والدولة = يسعي الناس لتأليف المجتمع بهدف صناعة الخير، وعندما يختلفون فيما بينهم يؤلفون الدولة لحل النزاع فيما بينهم. فيصبح دور الدولة دور الحَكَم بين المتنازعين. وكلما ترسّخت أقدمية الحاكمين كلما أصبحت مهارتهم في نزع فتيل الفتنة أكثر فاعلية، لأنهم يعلمون بمختلف ما يسميه العروي بالنوازع، التي تدعو الناس إلى الاختلاف فيما بينهم، حالات ظلم، رغبات ثأر دفينة، نزوع نحو تداول النفوذ المناطقي بين النخب المحلية….
***
وبالعودة للقرن 19، لقد تطورت الاحداث الاقليمية بحيث اختل ميزان القوى المحيط بالسيادة الوطنية (وهي جزء من المنطقة المتوسطية العربية الاسلامية) في السياق الذي تمكن فيه النظام البرجوازي الفرنسي من تصدير مشاكله باحتلال الجزائر. ولأن الخلافة العثمانية سقطت في التناقض= من جهة، كانت تحرض باي الجزائر لممارسة الضغط على الغرب (عبر القرصنة) لتخفيف ضغط الغرب على الاستانة في اليونان والبلقان. ومن جهة ثانية، اختل التوازن بين نطاق السيادة العثمانية والغرب، فتنصلت الخلافة من مسؤوليتها في الدفاع عن الجزائر، وقد انزلق الاختلال بين الخلافة وبين الغرب نحو الحدود الشرقية للمغرب.
وجد سلطان المغرب نفسه أمام مسؤولية أخلاقية لمساندة شعب لم يكن رسميا من مسؤولية المغرب الدفاع عنه، بالمعنى السيادي الحرفي من زاوية المفهوم الحديث للسيادة. ولما جرّب الأمير عبد القادر مبادرة تأسيس إمارة غرب الجزائر لضمان الدعم المغربي، حاجج سلطان المغرب ونافسه في السيادة -غير المكتملة في جميع الأحوال- على قبائل رعوية تتنقل بين بحكم البحث عن الكلأ، بين التراب الجزائري والتراب المغربي، وقد تعود بعض تلك القبائل على الدعاء لسلطان المغرب وليس للخليفة العثماني.
***
وليس من الصدفة أن يجد المغرب نفسه وجها لوجه مع الغرب في سياق هزيمة العثمانيين في الحالتين= حالة اسلي (1844)بعيد انهزام العثمانيين أمام الغرب في اليونان (1829) وفي الجزائر(1830) وأمام محمد علي (1840)، وحالة حرب تطوان(1859) بعيد انهزام العثمانيين في حرب شبه جزيرة القرم (1856). وقد قطفت انجلترا مكتسبات قانونية ماسّة بالسيادة المغربية بلا حرب في نفس السنة. وقد أصبح ضباط الغرب يعلقون على صدورهم ميداليات المجد باسم المغرب= بوجو كونط ديسلي، أودونيل ضون دي تطوان.
بسبب تقلص نطاق السيادة العثمانية في الجزائر وفي البلقان، انقلبت موازين القوى في البحرالمتوسط، تجسدت في بنود الاتفاقية مع انجلترا. هكذا، وجد المغرب نفسه خلال النصف الثاني من القرن 19، بين العوامل الداخلية، سيادة يحرسها سلاطين ذوي حزم وخبرة في التحايل على الأطماع الغربية، وميزان قوى منهار في المحيط الاقليمي، يجعل سقف السياسة الدولية يسقط فوق رأس المغرب.
***
مقابل هذا العامل الخارجي الثقيل على كلكل الحصان المغربي الأصيل، ترك الفارس، يلقي نظرتين، نظرة إلى الخارج ونظرة إلى الداخل.
لقد تعمق الشرخ الثقافي داخل الطبقة الوسطى خلال القرن 19، في المجتمع العتيق. بحيث كان التجار يسافرون الى منشيستر(حيث الحداثة) للتبضع بينما كان الفقهاء يذهبون الى المشرق قصد الحج فيجدون صعود الوهابية بخلفية مختلفة حنبلية منغلقة ترث الاحتراز من الصليبيين وهو عصر ابن تيمية من قبل، وقد تلقفه ورثة ابن حنبل السابق عليه في عسير. مما دفع التجار الى طلب الحماية من الاوربيين هروبا من تزمت الفقهاء وضمانة لمصالحهم مع الغرب الآتي لا محالة لاحتلال المغرب.
العمل المشرقي الذي ظل طيلة القرون، يجدد نظرة المغاربة إلى الدين وتأطيره لواجبات المغاربة، عبر الذهاب السنوي إلى الحج. بحيث كانت التأثيرات المشرقية الثقيلة تفسّر لماذا لم يتمكن المغرب من استثمار البعثات العلمية مثل اليابان. ولقد جرت هذه المقارنة بكثير من الخفة والسطحية. فاعتبار الفاعل الزمني المتراكم ثم السقوط في الحيرة أهمل الطبيعة القارية وشبكة العلاقات المتحركة والمتجددة للمغرب مع المشرق كان لها وقع مغرٍ لدى المحافظين المغاربة من العلماء. بينما يمتاز اليابان كونه أرخبيلا بحريا، سمته الدينية تقديس الاجداد من البشر تختلف عن تشابك الميتافيزيقا في حياة الأديان السماوية الثلاث.
فقد اضطر أهل عسير، منطقة آل سعود إلى تولية شريف ادريسي مغربي للنظر في شؤونهم القضائية والثقافية الشرعية قبل بروز الوهابية. وبعد بروز الوهابية استنجد أهل عسير بوفد الحجاج المغاربة في موسم الحج لنصرتهم في مسألة شرعية الوهابية ضد الهجوم المصري والعثماني عليهم خلال عهد السلطان المغربي سليمان، وذلك مثل التلميذ الذي يعرض أمام الفقهاء العارفين ما لديه من معارف شرعية. بحيث بقيت الخلطة المذهبية المغربية ذات تأثير مذهل لدى أهل الجزيرة العربية، إذ يعجبون من كون السلطة علوية وفي نفس الوقت حارسة مذهب إمام المدينة المنورة وهو العربي الوحيد بين أئمة السنة الأربعة، الإمام مالك بن أنس.
من هذا الرسوخ الصلب لاستمرار المحافظة الدينية لدى أهل الحل والعقد في المغرب، يئس التجار المغاربة وهم زبناء الغرب الحديث. ومن هذه المفارقة داخل المجتمع المغربي انفتحت شقوق الحماية القنصلية في جدار السيادة الوطنية، أكدت هول الضغط على النظام السياسي المغربي. ساعتها على إدراك مهام التحديث بالجملة من فوق على طريقة الميجي الياباني، فأخذت قطرات ماء الحماية القنصلية بالتقسيط تفتت صخرة السيادة الوطنية.
***
ولأن فرنسا ذات باع طويل منذ عهد نابليون بداية القرن 19، في تشكيل المجموعات العلمية لدراسة البلد الذي تستهدفه بالاستعمار، فقد استوعبت فوات زمن الاستعمار المباشر، فاستلهمت سابقة الحماية التي اشتركت فيها مع انجلترا لحماية اليونان من الاستعمار العثماني (1829)، طبقت الفكرة في تونس مماثلة لحالة اليونان. حماية تونس من فوق. بينما ابتدعت حماية دولة المغرب من الهجوم من تحت، مما جعلها تبتكر ثنائية “بلاد المخزن وبلاد السيبة”.
***
لماذا جرى فوات عهد الاستعمار المباشر دونما حاجة إلى عقد مسبق مع الدولة المحلية؟ لأن انهزام فرنسا أمام ألمانيا جعل فرنسا تحسب حساب الجار الالماني القوي، منذ سنة 1870، أي عشر سنوات قبل احتلال تونس.
هكذا بقيت شرعية المخزن قائمة رسميا، ولكن مع تجميد السيادة الوطنية في العلاقات الخارجية، مقابل اشتراط توقيع السلطان على كل الظهائر، وعندما تغيرت ظروف توصل السلطان بالأحداث العالمية المؤثرة، بعد ظهور المذياع، وهو ما لم يكن متوفرا للسلطان يوسف في صراعه مع المقيم العام ستيغ، توفرت للسطان محمد بن يوسف، متسع بناء رأيه الخاص، وبعد انهيار السمعة الفرنسية مع خضوعها للنازية، بدأ السلطان محمد بن يوسف يعلم بما يحيق لغير الاوربيين المسيحيين داخل أوربا منذ صعود هيتلر (1933)، إذ يذكر علال الفاسي في الحركات الاستقلالية، أن السلطان بن يوسف طلب لقاءه في نفس السنة، ووعده أن مهمة السلطان استرجاع ما أضاعه المسؤولون السابقون بصدد السيادة الوطنية.
فهم التاريخ، كما يشير الى ذلك علال الفاسي في مقدمة كتابه “النقد الذاتي”، حيوي بالنسبة لوعي مجتمع بما يجري من حوله بناء على دروس ما جرى في السابق واستخلاص الكيفية التي عبرها حافظ السابقون أو فرطوا في مقتضيات الاستقلال و ثنائية الحرية والسلطة. فلا سيادة بلا سلطة ولا سيادة بلا حرية.
نتابع في الحلقة الرابعة.