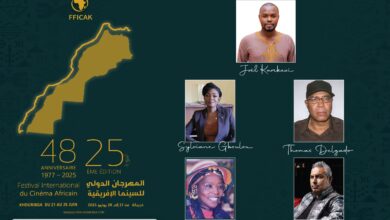“الأسرار من محلها/ الجزائر” (2) بين سندان “الـعـشـق الـمـمـنوع”ومطرقة “المنفى الاضطراري”و سؤال في التاريخ السياسي الراهن- ذ.عبد الواحد حمزة
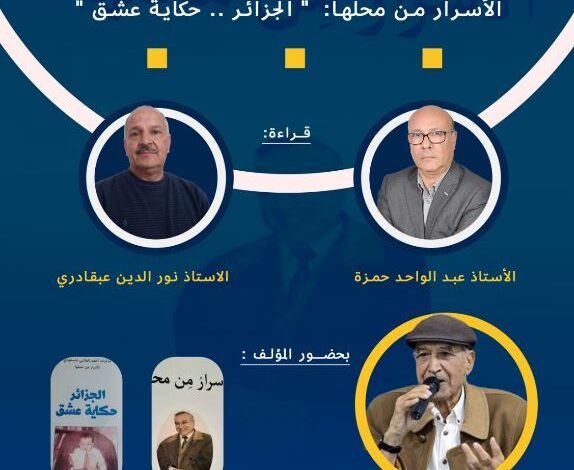
أقترح عنوانا / مدخلا/ تقديما عاما وشبكة لقراءة عمل الأستاذ الفاضل، على أن أترك جزءا آخرا يغوص في ما يطفح به العمل ذاته من ترحال بين زوايا متعددة ومتشابكة حول اللغة والذاكرة والجسد، وبتلك الطاقة الإبداعية المتوهجة في البناء السردي للكتاب، والتي وظف فيها المؤلف كل إمكانيات الأدب المتـشعبة، سأتركه للأستاذ والرفيق عبقادري نور الدين، فهو أهل لها وأقدر بها (…) !
وعليه سنعالج في هذه المداخلة: الأولى، في الإشكال الأدبي والسياسي الراهن، معرجا عن تيمات –مفصلية -مفضلة حول أسرار السياسة والمنفى والسجن… والمكان والزمان كمجالات لصراع دائم في حياة وفي كتابة المؤلف، والذي يطرحه كتاب الجزائر حكاية عشق للأستاذ المناضل أحمد الطالبي المسعودي؛ والثانية بعض الأسئلة الراهنة الحارقة وما يحبل به واقع المنطقة من خراب محتمل.
-في الإشكال الأدبي والسياسي الراهن
ما أقترحه من عنوان أولي لقراءتي في الجزء الثاني من ثلاثية الأستاذ هو: “الأسرار من محلها (2) بين سندان “العشق الممنوع” و”مطرقة النفي الاضطراري”، وسؤال في التاريخ الراهن، وسأحاول التبيان والتعليل والحجاج في هذه الفرضية الراهنة الحارقة…
وعليه، يمكن اعتبار عمل أحمد الطالبي في إطار من ساهموا في تحديد المقاربة التاريخية بحيث تناول مواضيع تنتمي إلى التاريخ “المباشر” من زاوية الشاهد – المعني بالأمر أو الفاعل، وإن كان قد عمل على التوثيق أكثر مما أنتج مقاربة خاصة للأحداث وإعمال للعقل النظري فيها، أو تناول مواضيع تاريخية سياسية، كتيمات محددة.
ونحن في هذا الصدد لما نسائل المتون التي تفضل بها أحمد الطالبي، تجميعا وتوثيقا دقيقا، انطلاقا من أسئلة حارقة راهنة حول التاريخ القريب للمنطقة المغاربية ولبلدان المغارب منها (الجزائر / المغرب …)، خاصة أن الأرشيف السياسي للمنافي والسجون واللجوءات (…) أصبح متاحا –نسبيا- وأن تطور مناهج البحث التاريخي أصبحت تمكن من رصد “مسافة زمنية “سلسة، كل ما ينقصها ويلزمها هو ” الجرأة الفكرية” للتنسيب ولتعميق الفرضيات والإشكالات، فممارسة حرية التعبير للمؤرخ والشاهد على الحقبة قيد التمحيص (انظر ع الأحد السبتي خاصة “التاريخ القريب ومسافة المؤرخ”، ص 209-217).
وللتذكير، فقد سبق لنا في الحزب الاشتراكي الموحد/ فرع تمارة أن قدمنا قراءة مزدوجة – رفقة الرفيق عبقادري نور الدين وفي حضور الأستاذ أحمد الطالبي وتدخله المشرف، وهي تدخلات لم تنشر بعد حول الجزء الأول من ثلاثية المؤلف، تحت العنوان الشامل المانع المشوق والحامل في إبانه – لكثير من الوعود والتوقعات التي تحبل بها الأمكنة: إنه “الأسرار من محلها” (2022)، حيث يدور هذا الجزء الأول حول “سوس العالمة” والبقية تأتي (..) .
ما هو بين أيدينا – اليوم – هو الجزء الثاني من ملحمة المؤلف وهو جزئ جاء في وقته، كما أنه ذو راهنية قصوى، وإن كان له ما يميزه في الأدب والتاريخ السياسي للمغاربة على وجه الخصوص، بما يعطيه من وثائق صارمة وبوح الأديب الحالم ومن إبداع (…)، فإنه أولا وقبل كل شيء هو عمل لا يريد أن يخطئ هدفه: التوجه إلى الجيل الجديد من الشباب ليصل الماضي بالحاضر وبالمستقبل (…)، و ليسائلهم – قبل غيرهم- عن جدوى الحياة.
له ما يميزه في الأدب – بأنواعه- ولتموضعه في التاريخ الحي لمغرب اليوم، ولجزائر اليوم، وللمنطقة برمتها – اليوم، وإن كان يغطي حقبة النزاع والنظر والتأسيس “لـلدولة المغربية العصرية”. إنه الصراع الذي حسم – عندنا – لصالح دولة المخزن – ضمن ملابسات ومصالح دولية وإقليمية متقاطعة (…)، ليفتح باب السجون و المنافي والشتات والترحال الدائم نحو العالم (الجزائر– فرنسا – مصر…)، ولتفتح أغوار جهنم والاعتقال والتعذيب والاحتجاز الجبري لكل من خالف مطمح القصر الملكي، حيث عرفت بلادنا “سنوات جمر ورصاص”، لم يتوقف أزيزها بعد، كما لم تندمل جراح ضحاياها بالكامل بعد (…)، رغم ما قامت به هيأة الإنصاف والمصالحة من توصيات واعدة، بقيت حبرا على ورق، إذ أظهرت اعتقالات الإسلاميين/ السلفيين/ الجهاديين- حينها- في تحد سافر لحقوق الإنسان الكونية، وكذا الأحداث اللاحقة، استمرار دولة – المخزن في نهج نفس غَيِّ الأسلوب السلطوي في تدبير “الشأن العام”.
لقد قبل “التقدمي الكارطوني” بالمقايضة، متظاهرا بالطهارة،- وكعادته- وفي وقت كان فيه مكبلا بقوانين مرحلة انتقال للحكم (انظر اللعبي ع اللطيف (1980)) يوميات قلعة المنفى، رسائل السجن 1972-1980 المغرب)، ولعب “الجهاز القامع ” دوره المعتاد، كما أن ” الإنسان القديم” ظل قابعا في داخل “المقموع”، ليشارك الجميع لعبة بيع وشراء الصمت ، فهل استطاعت تجربة الأستاذ أحمد الطالبي في الكتابة وفي الحياة أن تتحرر وإلى أي حد – من شرنقة القمع والمنفى والانتقال اللانهائي ولعبة الصمت وكشف سر الفنجان؟ هل استطاع صاحب كتاب “سوس العالمة” (مذكرات الطالبي (1)) أن يصلح أو أن يتحرر من ثقل ثقافة المعسول وتكوين جامعة بن يسف للتعليم الأصيل بمراكش؟
وهل لازال للعنف ما يبرره اليوم وللخيار الثوري من إمكان وراهنية أمام إنسداد أفق التغيير الديموقراطي السلمي وتعقد لعبة الأمم ؟ هل لفرضية العنف الثوري ما يبررها اليوم، خاصة، وأنه لعب ولعله يلعب بشكل أو بآخر دورا (عنف مادي/ عنف رمزي، كما قال ذلك بورديو، أو “الدمار الخلاق” حسب المحافظين / النيولبراليون الجدد، الخ) في تحريك الآسن وفي خدمة من يهدد به أو يقوم به من قوى مسيطرة أو “قوى مضادة ” عبر العالم؟
هل هناك ما يبرر”عنف الدول المشروع” ومن أثر داهم لـ “أثر الفراشة/ “لـعبة الدومينو” وللطوفانات على واقع ومستقبل الأمم، المغرب، الجزائر(…)، مثلا، أو إبادة الأمم ( إبادة جماعية في الشرق، وفلسطين اليوم بالذات، وفي قلب إفريقيا وآسيا، وقبلها في أمريكا، بالذات؟ أي دور تلعبه القوى الاستعمارية الجديدة، وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا- مستعمرينا القدامى- وحلفائها المحليين، على تفخيخ وافتعال وتلغيم وتدمير البنى الاجتماعية الوطنية- القطرية- أكان في المغرب أو الجزائر، أو غيرهما من البلدان المتخلفة والتابعة لمراكز القرار العولمي، حتى لا تقوم لهذه الأقطار المتأخرة قائمة في بناء ذاتها- أقطارها- وفي بناء المغارب والمغرب العربي الكبير- العالم – على طريق التقدم والحضارة والاستقلال والسيادة الوطنية الفعلية؟.
هل في تجربة حزب ” الخيار الثوري”، ويعتبر أحمد الطالبي مَنْ سـَمَّى الحزب بهذا الاسم، توجد نظرية في الثورة، أم كان يحكمها العملية والنفعية / البراغماتية: العنف يولد العنف المضاد، عنف الثورة ضد عنف المخزن؟
السر والمنفى … وحرقة السؤال
(…) وعليه يمكن تقديم قراءة سريعة للعمل الثاني من هذه المذكرات، من خلال مفهومي “السر” و”المنفى”، مع الانتباه إلى ما يمكن أن تثيره أو تحبل به المنطقة سياسيا من موضوعات مشتركة وأسئلة راهنة حارقة. ويمكن اعتبار طرح أسئلة راهنة شائكة مجازفة لضعف ” المسافة الزمنية” ولصعوبة التدقيق في أصحية الأحداث السياسية والأمنية.
ومن جميل الصدف تعرض الكاتب لمواد تاريخ ميداني سياسي مشترك جمع حركة ” الاختيار الثوري” و”منظمة 23 مارس” (ص 159-ص 164)، حيث أثار المحضر المشترك بإحدى اجتماعات التيارين لمؤهلات مناضلي كل منهما، فيما يتعلق بتتبع الوضع السياسي والدود على تثمين العلاقات، مغربيا وجزائريا، وكذا فيما يخص مراقبة تحركات الأطراف المعنية، بمن فيهم العملاء وحماية المنفيين من عدوان الوشاية والتعذيب والسجون الملازمة لذلك، وذكر بتفاعل كلا التنظيم- مع احترام التقديران السياسيان لبعضهما البعض- في المجتمع ومع مناضلي الجزائر التاريخيين.
وإن لم يفصح محتوى التقرير المشترك عن سر أجندة الاجتماع، خارج الرصد والتتبع واللجوء السياسي، وهي هموم تقنية – سياسية، وظل للموضوع السياسي الجوهري، من تحالفات وغيرها، ” قناع” هو جزء منه، فلم يفتهما رصد وتحليل وتنسيق الخطى في أمور تتعلق بمسار القضية الوطنية.
كما ذكر بـ” المنفيين الجدد” الذين سيصلون بالجزائر بعد 1973، على إثر أحداث العنف التي شهدتها بعض مناطق المغرب، بعد الكثير من المعاناة الشخصية والجماعية التراجيدية، وأخص الكاتب لجوء مجموعة 23 مارس إلى الجزائر بعد اعتقال حرزني سنة 1972، وهو أحد مؤسسي اليسار المغرب الجديد، والذي انتقل بعدئذ إلى “الحركة من أجل الديمقراطيين” وتحمل مسؤولية وزارية في دولة المخزن، وهو واحد ممن مروا خفافا في سراديب الحزب، ومنهم من بقي إلى اليوم ضمن هياكله، كالفقيد- حكيم اليسار الرفيق إبراهيم ياسين، وكذا محمد السمهاري ومصطفى مسداد وأحمد الحجامي…
والحال أن المفهومان (“السر” و”المنفى”) جزء من كل، من شبكة أعرض وأوسع وأعمق لدى المؤلف، وقد سبق وأن قدمنا جزء منها وسنـنـشرها كاملة – لاحقا – مساهمة منا في تأمل “صرح القيمة والفعل” وفي بناء الوطن / الأرض واللغة والثقافة والإنسان (…)، وهو الأمر الذي دشنه الكاتب، في ” زمن الشك” الذي نحياه اليوم، حيث ” لم يعد للحرية من رمز” وحيث “لم يبق للمجتمع من قدوة” (الكباص ع. الصمد (2023) في مقدمة للكتاب تحت عنوان “الذاكرة منهج المكان في المقاومة”.
(…) وحيث أصبح العشق ممنوعا، طلع علينا الكاتب بجدوى العشق، لأنه من صميم الحياة، طلع بحكاية عشق الجزائر/ الجوار. ولأننا نعرف طينة الرجل، فلم يخطر لنا على بال -وهو كذلك- أن عشقه ذلك هو عشق لنظام الجزائر / لجنرالاته، وإنما هو حب لشعبه في الفعل والتنسيق واللقاء (…)، وهو يعلم – قبلنا – كيف انقلبت عليه ” الجزائر – الرسمية”، فنكلت به، مغيبة إياه في أقبية التعذيب والاعتقال (…).
وهو يعلم أيضا – قبلنا – كيف ضاق به طوق الحرية في بلده الأصل –المغرب، ليجد الجزائر ملجأ يحتمي به من بطش واستبداد دولة – المخزن، فكان بحق بين مطرقة وسندان (…) ودوامة ترحال و”هروب شجاعة” لا منتهي، وأضحت الكتابة لديه ملاذه الأخير ، بعد أن طرح جانبا مسدسه، وأن لا حقيقة صريحة دون ستارها، حسب قول نيتشه، فلم يشفع له حبه لشعب الجزائر طغيان دولة عسكرية، تأتمر بمصالح مراكز قرار خارج عنها ( فرنسا…)، فالعشق والعاطفة والحب والتماهي … كلمات لا محل لها في عنف الدولة المشروع، إذ هي تتأسس على القوة قبل المشروعية والإيديولوجيا…
المكان والزمان، مجالان لصراع دائم… في الحياة والكتابة
الكتاب مجال لتصريف صدمات مكلفة لمفاجئاته ومصائده وتربصاته. إننا أمام نص مارق- ضال في السياسة، بامتياز، نص مرتحل متنقل بين أمكنة وأزمنة متناثرة، متعقب لأصداء ذاكرة هاربة وملتبسة، لجغرافيات أجساد و إرادات وأحلام وخيبات وحنين، فشهادة للتاريخ ومكسب للأدب، أدب الشهادة والاعتراف، وحيث الأمكنة ممارسة لصراع دائم (….).
كما أن الزمان لديه “صراع في الذاكرة” وهذه الأخيرة – بالذات- مزيج للمكان في المقاومة للنسيان وضد الشعبوية المستشرية –اليوم- بالذات، بين الإخوة الأعداء / “خاوا خاوا”، خصومة منفلته – أو هكذا أُرِيدَ لَهَا أن تكون – اليوم- بين السياسيين المغاربيين. لكن ألا يمكن أن تكون- بالضبط- فرصة للبناء وللحوار والتفاعل بين الشعوب من أجل مصير مشترك وتعاون وتكامل مثمران، ليقطع الطريق أمام مصالح الغرب، وفي مقدمتها – “ماما فرنسا” المهيمنة على حكام متواطئين وقدرات المنطقة.
يضع النص الكاتب / الإنسان في محك الصراع الدائم مع يقينياته المتأرجحة مع الاختبارات المتقلبة والقاسية وأمام نتائج ومردودية مؤجلة للمعنى وللإدراك في الزمن الطويل “الما- بعد كولونيالي”.
تبدو الكتابة لدى المؤلف تجربة في النفي واللجوء، وفي حب الوطن لمواطنيه، في المنفى كسبيل وحيد للعودة، وفي الشقاء الصادق أو “الوعي الشقي” (عبد الكبير الخطيبي) وفي الجحود الملتبس، حيث الوطن ضريبة قاسية ومكلفة ينتعش فيها المكان من دمار الجسد. إنه ركام قصص عن التنكر والإهدار والحسرة والخراب والتمزق والنبذ (…).
كما أن المكان اختراع هائل – عنده – لا يأخذ النجاح فيه إلا حيزا صغيرا في مسلسل لا نهائي من الفشل والمعاودة والمكابرة. إنه التاريخ، النفي، أو”نفي النفي” أو الدحض، على حد تعبير كارل بوبر أو هيجل أو ماركس أو ابن خلدون في الجدل المادي أو دورة الأمم الحتمية نحو الصعود، فالخراب.
أما المكان عنده – أكانت المدن، وهران أو باريس –لاحقا- أو مربع السجن، فهو حكاية دائمة منتصرة للآخر وعنه، إنه الدخول في مغامرة الندرة الرفيعة للحدث المُوَقَّع من لا أحد على جسد من يكتب، فهو يوشمه ويلسعه لسعا بلهيب موقف أو موقع، واع أو غير واع. إنه يعير ضميره المتكلم لأصحاب حق ليتكلموا عن مأساتهم الخاصة في النفي واللجوء، وكذا في مأساة العودة للمغرب / الوطن (نخب سياسية أو اقتصادية…)، فكانت حلقة الهروب المفزعة في أن لا مناص من قدر الجحيم وتنويعاته المنقحة باستمرار.
يأتي المنفى الاضطراري، اختيار جحيم لجوء غَادِرٍ هربا من أرض- وطن له عليك حق، ليتحرر من لعنة الاستنطاق اللا متناهي ومن المراقبة المطلقة حسب تعبير فوكو، والتي لم يعمل الذكاء الاصطناعي اليوم إلا على تعميقها وخنق الأفراد والجماعات (…)، لنتعلم من وصايا الكتاب المضمرة أشياء كثيرة، وإن إلى حين.
إن فكرة “الحرية صعبة الهضم” في الفضاء المغاربي- العربي- الإسلامي، وطريق المستقبل والحرية فيه قد لا يتقاطعان بالمرة، وأن جزائر الثورة والأمل هي بالمفارقة ودائما – جزائر الخيبة والاختطاف والتعذيب والسجن والمآسي الجماعية، أيضا. ولنتعلم، كذلك، أن التاريخ لا يشبه أصله، إذ هو دائم التحريف ومن الجدير بالكتابة والتأليف، كالمذكرات مثلا، أن توارب تصويبه، ولنتعلم – ككل الشباب وكل الفاعلين والنشطاء المناضلين – اليوم- أن مهمة الثورة والتغيير والإصلاح هي دائما أن تصنع الخرافة من خلال التضحية، أن تبني صرح الحرية والعدالة والقدوة (…).
(…) ولنتعلم أن المكان دائما هو مبتكر الحقيقة، وأن الترحال بين زواياه المتعددة هو القاعدة التي تعطي معنى للحياة، إذ هي مباحث للذاكرة واللغة والمتون المستعصية على التنميط، وأن الاستقرار موت للحركة وإشاعة مغرضة ضد الحياة، وأن الإبداع عالم لا حدود له، ما دام أفقه هو القارة الإنسانية اللامتناهية الأطراف، وحيث شوكة المنفى لا تزال تنخر لحم الملايين من الشتات المغاربي، ما يزيد على عشرة ملايين (10) وتدمي المعيش اليومي والعقل التاريخي للمئات من الأحرار، وليصبح الأسر مكون ثابت لواقعنا السياسي المغاربي- المغربي (صحفيون، مدونون/ات …). إنه تحدي مستمر وراهن لا يمكن التغافل عنه إلا إذا نحن من موقعنا في المغرب و في المنطقة قَبِلْنَا – قليلا أو كثيرا- شخصيا أو عموما – بالمشاركة الضمنية أو المفضوحة، في أبشع تجارة رق ممكنة: شراء وبيع الصمت.
أسئلة راهنة حارقة أو الخراب على الأبواب
إن الاستعداء المتبادل على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجارتين – اليوم- أفضع وأخطر من الحروب الباردة للبارحة (حرب الرمال 1963)، والذي للأنظمة ولمخابراتها من كلا الضفتين اليد الطولى فيه، حيث يعبئ اليوتوبرز- أكانوا “جمهوريين” – قالوا- أو “ملكيين”، وتحتضن كلا الجهتين “هيئات انفصالية” لَهُوَّ أمر في غاية الخطورة، يؤجج النزاع في المنطقة، ويضرب استقرار البلدين في الصميم، ليضعهما تحت وصاية فعلية مستبطنة أو ظاهرة للعيان- للاستعمار الفرنسي –الجديد – الغير المباشر (والذي كان منذ الاستقلالات الشكلية لبلادينا ولا يزال) غيره، بأساليب أخرى وجديدة، برع فيها “المخزن الجديد” عندنا والجنرالات” عندهم ضمن لعبة الأمم العظمى، أيما براعة “واهية” ! (…) أمام التطور الموضوعي الحاصل في ثنايا البنيات والسلوكات للمغاربة والمغارب…. والتحول الحاصل في العالم بعد أزمات الرأسمالية والامبريالية العالمية ( أزمة 2008وتداعياتها على أقطار ومراكز وهوامش الدنيا ، طوفان الأقصى لسابع أكتوبر 2023،…)
إنه الجوار/الجغرافيا والتاريخ السياسي الراهن الذي أدخل الطالبي أحمد بالضبط إلى السجن، وكأن في الأمر توافق وتواطئ سافر مع مَنْ هرب من بين أيديهم في بلاده – الأصل. كثيرا ما نعت المؤلف – منفيا- الجوار “بعدو المغرب” ساخرا، وهو يعلم أن العشق “السيامي” للشعبين، لبعضهما البعض، لا يمكن لواش أن يفسده، كما يقول أمير الشعراء،(مسؤولين مغاربة مروا في حكومات الجزائر، ومسؤولين جزائريين مروا في القصر، تحت أنظار القوى العظمى، فرنسا تحديدا)، مهما عملت القوى العظمى على إفساده، ومهما تطلب إنشاء الدول القطرية من ضرورة السيادة الوطنية “الهجينة” وحلفائها في المنطقة، ومهما عمل الاستعمار الجديد – الغير المباشر، فرنسا النيوكولونيالية وغيرها من الأطماع الأجنبية – على طعنه من الخلف.
ومما لا شك فيه أن الطالبي- المناضل والإنسان- دخل عوالم المنافي – الجزائر وسجن البرواكية نموذجا – ليخرج آخرا، لتصبح الكتابة لديه قرينة للصلاة، من “معدن واحد” كما يقول الكباص ع. الصمد، مرجع سابق. فـ”ليس دخول الحمام بحال خروجو” !، كما يقول المثال الدارج: ففضلا عن ثنيه عن حبه الأول/ الخيار الثوري وعن طرح دكتوراه في زمانها، فكان ذلك نوع من ملهاة وتنويع وإبدال لحبه الأول، ولو إلى حين، عمل كعادته العصامية على استغلال مكان وزمان السجن / المنفى لتكوين نفسه وذاته وتنويع إبداعه. لقد أدرك –مما لاشك فيه – المعنى العميق لمكان وزمان اسمه “السجن” حيث يتم تحويل من يدخله من إنسان ليخرجه فارغا وممحيا عن آخره، وحيث يعمل على أن يلغي كيانه الذي به كان، وبه حلم، وعشق وأحب وغامر، وحمل السلاح وخبَّر.
لقد كان بإمكانه أن يستمر متطورا في عالم الخارج، عالم الحياة والواقع (أنظر يمنى العيد في مقدمة رسائل السجن لعبد اللطيف اللعبي، مرجع سابق). لقد علم كيف يتراجع المكان في السجن.. يضيق.. تنمحي فروقات الأحجام والأشكال والألوان وتغور المعاني، بقدر ما يكبر الوطن في القلب والإحساس. فقط الجدران ذاتها ومعها يتكرر الزمن.. يلتغي (…) يتكرر كل شيء ويلغي حدوده ليعيش المسجون موته/حياة في حدودها الدنيا، وليحقق السجن وظيفته “العَدْم دون القتل”، وليخرج الطالبي من تجربة ومحنة المنفى والسجن منتصب القامة، يآكل الطعام ويمشي في الأسواق، ويكتب للتاريخ وللإبداع وللشباب، قبل وبعد غيرهم.
(…)بتبصره في عالم الواقع، ولكي يرقى في عالم الحياة، كان لابد للطالبي من أن ينشط ويعطي، لا مفر له كإنسان من العمل باتجاه الناس وباتجاه الواقع نفسه، والقوى الحية، ومن الحب والعشق ما قتل ! وهو في العالم المعزول “سجن البرواكية” حيث يهيئ الحكام المتواطئين لموت الحياة البطيء فيه، وَمَنْ على شاكلته، كان له أن يقبض على سر لعبة الموت الخفية، لعبة الموت التي يضمرها الحَجْر ليرى أين يختبئ الموت وليدرك أن الحياة ممكنة حياة النمو والعطاء والتغيير. إنه لا يريد أن يموت، لن يصير مجرد كائن حي، لن يقتلوه، فأخذ على نفسه أن يموت فارغا – كما يقول دولون، لأنه لن يتراجع عن بناء صرح القيم والكتابة، ما بقي له كشاهد وكاتب ومؤرخ… إنه عاشق الحرية والحياة العادلة لكل الناس.
لقد بدأ في تنفيذ السر منذ عمله الأول – بالصدفة – عمله التقديمي لما سيأتي من بعد. إنه الكتابة – الثلاثية- لكسر طوق العزلة، ومد يد الجسور إلى العالم الخارجي الواسع، عالم الحياة والأحبة، عالم الواقع والناس، ولتنهزم لعبة السجن المفترى عليها ولعبة المنفى الخفية (…)، فهل يُعْقَل أن تكون حياة المنفى والسجن غنية على هذا القدر من الغنى، كما تقول يمنى العيد (مرجع سابق)، وكيف يتأتى للطالبي أن يتفنن في إعادة خلق المكان، ويشرف على ما آلت إليه الأوضاع، اليوم ؟
لازال إتفاق سايسبيكو (1916، بودابيست)، جاثما ومتربصا بالمنطقة وبالمغرب، فخطر التجزئة وارد في جميع الاتجاهات. فهل سيدفع احتضان أول تمثيليته ريفية رسمية بالجزائر الشقيقة المغرب إلى نهج نفس الأسلوب الدبلوماسي – السياسي ” المتهور”، بإعلان تمثيلية للقبائل في المغرب، وإن سبق واستقبل رئيس الحكومة المؤقتة للقبائل – المعلنة في أوربا – استقبال رؤساء زعماء الدول …؟ هل هي أمور من صميم الحروب التي تستحق أن تدار …. أم أن الأمر لا يعدو انزلاقات وعبث ما بعده عبث يتراشقه البلدان؟
ألا يكفي المغرب جبهة الجنوب المفتوحة مع البوليزاريو، ليضيف إليها جبهة في الشمال مع الريف ؟ ألن يعمل ذلك إلا على تسميم روابط الأخوة بين الشعبين، لا النظامين، ولن يدفع الاستعداء المتبادل إلا على شحد العداوات والشقاق والتجزئة وفي ذلك حِكَمٌ ومصالح للقوى العظمى المهيمنة ولأذنابها في المنطقة؟ أليس الأمر لعب بالبارود، وأن الاستقواء بإسرائيل – المهزومة والمنبوذة بعد طوفان الأقصى للسابع من أكتوبر (2023) – على الجوار وكذا الاستجداء والتسلح من إيران لصالح الجزائر، لن يخدم المنطقة المغاربية والعربية – الإسلامية في شيء، فيما هو يخدم مصالح الغرب الإمبريالي ؟
إنه لأمر غير مرغوب فيه أن يتم الإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية في باب الريف المغربي، أو السماح بإنتاج السلاح ببلادنا، ولا حتى السماح باستعماله، بعد أن احتكرت الدولة المغربية المدنية “الدفاع”، بعد أن تسلم نواته الأولى من يد جيش التحرير المغربي غداة استقلال المغرب – السياسي(….)، فمنع تداول السلاح بين المدنيين والتحكم الحصري فيه من طرف دولة المخزن، ولأنها لا تنتج اليوم- وبعد سلاحها الوطني، فهي تستورده بأموال وقروض باهظة، أو قد تسمح للأجنبي بإنتاجه في بلدنا، وهي بذلك ترهن سيادته واستقلاله وأمنه، آنيا وإستراتيجيا. فكيف يمكن مقارعة الخصوم بسلاحهم المستورد !؟.
لن تكون تمثيلية الريف في الجزائر، فيما هي ليست لا “قنصلية” ولا “حكومة منفى” أو جمهورية للريف وإن تدفع إلى ذلك دفعا من بعض الانفصاليين، في الخارج قبل الداخل، إلا سحابة عابرة أو ذرة رماد ورمل في العيون تؤجل خلاص حركة التحرر المغاربية، ولم يشفع وضع صورة البطل محمد بنعبد الكريم الخطابي في مقر إقامة تلك التمثيلية، من طرف من احتضنهم، باحتشام، الجزائر- العاصمة، لأن مغاربة الريف الحقيقيين هُمْ من على أرض المغرب، شمالها وفي كل مكان، وأبناءهم/ القادة في المعتقل السياسي المغربي. مَنْ لَهُ شرعية الإنتماء والدفاع عن الريف هم الزفزافي ورفاقه، وباقي أحرار المغرب، أو القادة الجدد النابعين من قلب الحراكات والديناميات المستقبلية، وليس غيرهم من الانفصاليين المحتشمين اليوم، بالخارج، والذين يلعبون لعبة تقسيم، لا المغرب فقط، وهو ما لا معنى له، إذ هو ذو تاريخ خاص به، وإنما يستعرون تقسيم الجزائر إلى دويلات، أولا وأخيرا.
لقد عَرَّف اللعبى “المخزن” بذلك الخبير في تقنيات الإخضاع ومحو الذاكرة، العارف الماهر ببلطجة الخوف، وبما يرتبط بها من إذلال وتحقير وعنهجة. لقد أخذ لحسابه وبتحسينه، نظام القرن الوسيط الذي ورثه والذي يقتضي أن يبدل أناسا أحرارا بأناس “رعايا” إلى الأبد. هذا النظام العمودي الأخطبوطي، يخدمه جيش بيئس أخلاقيا مكون من مخبرين ووسطاء وغيرهم، بحيث لا شيء يمكن أن يبقى في حوزة أحد ولا أن يتملكه أحد دون أداء مقابل، مرورا عبر آلية يعتبرها “القائد” بمثابة نموذج للنظام الاجتماعي الطبيعي، بما هو نابع من إرادة إلهية.
إنها آلية تحكم العلاقات بين الناس والعلاقات التي من المفترض أن تكون لهم مع أصحاب القرار من أسفل السلم إلى أعلاه. (…) إنه غول/ مزيج من التقليدوية والاستعباد الجاثم على الإعتاق منذ قرون، والذي أصبح أكثر طغيانا تحت حكم الحسن الثاني (…) ( ص 17 ع. اللطيف اللعبي (2013) مغرب آخر، باريس فرنسا). لاشك أن دستور 2011 غيَّر من الشكل البشع للمخزن/ الغول/ التقليدوي والمستعبد للرعايا، غير أن جوهر الاستبداد ظل هو هو (المخزن الاقتصادي، الزواج المال والسلطة، هيمنة القوى العظمى، خطر التجزئة، دمج السلط الثلاثة ومركزتها…)، خرج من الباب ليدخل من النافذة ، أو العكس تماما، مع تطور تقنيات الإخضاع ومحو الذاكرة بأساليب جديدة.
لعل الذي أصبح يهدد الناس أكثر ليس فقط استبدال الأحرار- بالطبيعة- بالرعايا والعبيد الجدد، وإنما هول ما أصبح يعرف- تهديدا شبه حقيقي- بـ ” الاستبدال الكبير”/ “النظام الأخطبوطي العولمي ” الذي أسقط سيادة الدول الضعيفة، ( استبدال الأغنياء للفقراء وإبعادهم من المراكز إلى الهوامش، في هدر سافر لأصحاب الأرض الأصليين، ولكل سياسة اجتماعية ديمقراطية وشعبية/ سياحة العالم/ إسكان وتمكين الأفارقة من الإقامة/ التطبيع واستقبال الكيان الصهيوني،…). كما أن ثقافة الرعايا لم تسلم بعد من حكم/ براديغم القرون الوسطى والعبودية الجديدة، وهو ما يضع المعضلة الثقافية والسياسية في المغرب من بين مقدمات الانعتاق التحرري الوطني والاجتماعي.
ذ.عبد الواحد حمزة
أستاذ باحث، كاتب عام
الحزب الاشتراكي الموحد، تمارة
24 مارس 2024 تمارة
المراجع:
- أحمد الطالبي المسعودي (2023) الأسرار من ملحها / الجزائر.. حكاية عشق / مذكرات/ المغرب.
- ع. اللطيف اللعبي (1980) رسائل السجن (1972-1980) يوميات قلعة المنفى، المغرب . انظر أيضا مغرب آخر ممكن (2013)، بالفرنسية، باريس-فرنسا.
- ع. السلام بنعبد العالي (2013) البوب – فلسفة، دار توبقال، المغرب.
- ع. الصمد الكباص (2023) “مقدمة، الذاكرة منهج المكان في المقاومة” في كتاب أحمد الطالبي (2023) المغرب.
- يمنى العيد، مقدمة لرسائل السجن لعبد اللطيف اللعبي (1980) بيروت، لبنان.
- عبد الأحد السبتي (2012)، التاريخ والذاكرة، أوراش في تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي، بيروت/ المغرب. انظر خاصة ” التاريخ القريب ومسافة المؤرخ”، صص :209-2017 ، نفس المرجع.