لعبة الاختفاء القسري والطوعي عند أحمد الطالبي المسعودي (I) ذ.عبد الواحد حمزة
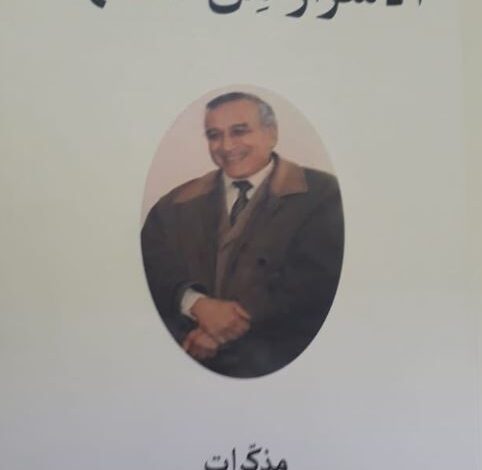
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ** وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمُ
المتنبي، الشاعر الذي قتله بيت شعر وخلده التاريخ
مقدمة: سوس العالمة/ “سوس المُجَهّلة” وضرورة العمل السري الثوري
أشعر بالامتنان والفخر والدهشة وأنا أقرأ وأقدم وأجالس وأناقش مقدمة لعمل جبار قادم[2]… يؤجل ما ننتظره منه، يحاول تقعيده – أولا بأول – إذ هو أكثر من سيرة ذاتية ومن تاريخ محلي ومن تدبر المعاني، مذكرات تهمس وتلوح في الأفق (…). !
وأردت أن ابقي على الرهبة الجميلة / القراءة الأولى والممتعة للأسرار من محلها، بالقرب وبتفاعل أولي مع احمد الطالبي المسعودي، ذو الوجه الطيب والابتسامة المرحة، المعروف بهما. قال فيهما المهدي بنونة (في أبطال بدون مجد – ص 155) علها أجود غطاء يتخفى وراءه رجل خبر الحركية والنشاطية الجامحة – ذات زمان – زمان الجمر والرصاص. وكانت له علاقات مع الفقيه البصري ومحمد دهكون والنمري، رجل تنظيم بامتياز! يجمع بين العملية والسرية والتكتم، وكان أحسن من يؤتمن على وثائق وأموال، وأحيانا كثيرة – أهمس إليه – على “السلاح” (…)!! (ما زال عندك شي كالاش أولا شي فردي، آسي الطالبي!؟). فيبتسم !
وهو ما جعلنا نقدم فرضية عامة لأعمال/ مشروع احمد الطالبي، حول تَخفّيه مرّتين: الاختفاء في المنفى والاختفاء في الكتابة وفي الذاكرة وفي الأسرار. إنه حافظ لسرّين، متربص في منفيين، في إختفائين. وما هو بيدنا – اليوم – ونحن نقدمه ونناقشه – هو “الاختفاء الأول”، في الزمان، أو الذي أراد له أن يكون كذلك! ولو أنه تم الإعداد له بعد حين، لاحقا. وهو ما يعني، أصلا أن “لعبة الاختفاء” قد بدأت!
لتقديم معنى أولي لـ “السر”، اسمحوا لي أن أقدم خلاصة (في نقاش نيتشه، في تمهيده لكتاب “العلم المرح”)، حيث: “اختفاء السر هو ظهوره، ولكن ظهوره كاختفاء. لا يعني ذلك أن السر لا يكشف. إنه لا يكون سرا إلا إذا عرف، لكنه لا يعرف إلا كسر، أي أنه يُعرَف كشيء لا يعرف. هذا المفهوم يرجع للمظهر كل قوته، مثلما يعيد للحجاب/ سُمْكَه وللسطح عمقه. لكن الأهم من ذلك أنه يجعل الأعماق مفعول السطوح، ويجعل التستر بنية للكائن، وليس كتمانا لأسرار، وصونا لجواهر، وحفاظا على ألباب” (بنعبد العالي ع. السلام، البوب – فلسفة ص 125 (2015).
فلنرى إذن كيف أن الطالبي يُظهر أسرارا في ما هو يخفيها، وفي ما هو يُخفيها يظهرها، وهو الشاهد – الواقف على أسرار يريد كشفها. وهو العارف أن الأسرار لا يمكن – اعتبارها – كذلك – إلا إذا عُرفت وفُشيت. إنه المساهم في التعريف بها وفضحها كأسرار، أي التعريف بأشياء وسيرورات لا تُعرف، أو لم يكن لها أن تُعرف!
فكيف إذن، مرة أخرى، يُرجع الطالبي للمظهر كل وقته، وللحجاب والقبعة و”الرزّة” و”البيرية” و”الكاسكيط” و”كسوة المخزن”… سُمكها، وللسطوح عمقها، ويُعطي للتستر بنية، وأن يكون جزءا من الأسرار ذاتها، في نفس الأوقات (…!؟)، ولهذا لن نقتصر على جانبية الرجل الشاب/ الشيخ، وإنما سنحاول إبراز المشروع المسعودي المتكامل، انطلاقا من تيماته الأساسية.
سنتطرق إلى الوقوف على معنى “الأسرار” من محلها “واضمحلال دور المثقف وما تبقى من ذكرى الحركي؛ ثم سنحاول رسم النسق الفكري -الأساس للمذكرات: مقاربة الشيخ والمريد وعسر التجاوز النقدي/ الثوري، وفي الأخير سنقترح بعض معالم النهضة والإصلاح لدى الحركة السلفية – الوطنية المغربية، وما إذا استطاعت أن تؤسس حقا لمسار سياسي وثقافي بديل ومخرج لـ”الفعل الثوري”، الذي بدأت ملامحه الأولى ترتسم منذ سوس العالمة/ سوس المعسول في شخص وشخصية المسعودي الثائر.
وهو ما جعلنا نقسم هذه الدراسة السريعة إلى جزئين:
المقدمات: “طاقية” الأديب و”كاسكيط” الحركي الشاب – الشيخ!.
التيمات الأساس: المواضيع الأساسية في مشروع المسعودي المتكامل.
القسم الأول/ المقدمات: “طاقية”/ “رزة” الأديب و”كاسكيط”/ “بيرية” الحركي الشاب… الشيخ
- كان من الممكن – اليوم، أن أقدم تحليلا هاويا بمضمون الأسرار، على الطريقة التي تجرى بها بحوث تعتمد منهجية “تحليل المضمون” الأدبي أو السياسي، أو غيرهما، في الجامعات، فنحسب عدد الأبيات الشعرية، وما أكثرها، مثلا، وقد نصنفها لربما بطريقة أكثر وأدق مما صنف بها الطالبي نفسه. كما يمكن أن نستطلع شبكة المفاهيم الأساسية التي تحكم هذا المتن، فضلا على ما قام به المؤلف في الفهرس، تعريفا بالمواضيع المطروحة/ التيمات والعناوين المقترحة لما اطلع عليه من آثار، أو أن نستخرج مجموع الأسرار تلك ونعدها واحدة واحدة (…)، أكثر مما هي مسطرة في الفهرسة، أو أن نعمد إلى مقارنة المعلومة بالمعلومة والحجة بالحجة، في اعتماد نفس المنهجية للتقصي التي اعتمدها الأستاذ الطالبي، الخ، إذا ما استطعت!؟
بدأ أحمد الطالبي “لعبته المفضلة” منذ البداية بالذات في العنوان بين ظفرين، حيث يتجلى كإنثناء ما يظهر. إنه فعل الطي ذاته، وليس العنوان ستارا أو غطاء يوضع فوق ما يستر، فما يُظهره السر هو الاختفاء ذاته، وحينما ينكشف السر ويفتضح أمره، فإنه لا يكشف عن شيء، وإنما يكشف عن بنية الاختفاء (نيتشه في كتاب العلم المرح).
وكان من الممكن أيضا أن أعرف قدري – فلست خريجا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية حتى أناقش في الأدب والشعر واللغة وغير ذلك. ولذلك لن أفعل، أنا القادم من “الاقتصاد السياسي والعلوم الاجتماعية”، عموما، وكذا “التدبير والتسيير”، أن أقف بالذات على أبواب خاصة – قد تهمني، أكثر مما تستجيب لمطلب دراسة موضوعية – قدر الإمكان – لمذكرات بدأت بالسياق الثقافي العام للمنطقة، لتغوص – بعد هذا الجزء – في الحركي والسياسي (…).
لكنها مذكرات مسحت أكثر من مجال، وعرجت على شيء من الاقتصاد المحلي وبعض مواضيعه، كأن تشير إلى الأثمان والأسواق وكلفة الورق و”حياة” الكتب وأسرارها وغرائبها، كتدوين الملكية الفكرية والشهود عليها – العارفين والقضاة… – في مجتمع سوسي متصالح مع الكتابة، مجتمع تحدى الكثير من الأحكام المسبقة – اليوم – عن “مغرب لا يقرأ” أو لم يكن يقرأ، بما هي أحكام واهية، لا تصمد أمام مجتمع شغوف بالقراءة والكتابة والدرس والتقييد اليومي المفصل للأحداث، حتى في جزئياتها (…) وكذا تنظيم وسير ووقف المكتبات، وبالخصوص، مكتبة العائلة، (…).
هكذا كان من الممكن أن يوقفني الحديث عن مكانة “الادخار” في المجتمع السوسي وعن المفهوم، نفسه، وان أتأمله في علاقته بالدخل وبالاستثمار وعن اثر الأزمات على ذلك؛ أن أقف عن السنتين ونصف سنة العجاف التي أشارت لهم بعض الهوامش للمخطوطات، وأثر كل ذلك على تعقل “الإنسان السوسي” وتدبره لأمره: الاستفادة من رغد المخصبة لمواجهة المجاعة القادمة، لا محالة! وفي ما إذا كانت دورة الإنتاج في المنطقة دورة بسيطة وأبعد ما تكون تعبيرا عن إعادة إنتاج موسعة للثروة، وما طبيعة ذلك الإنتاج البنيوية ومدى علاقة النمو الفلاحي البسيط وتناوبه مع الركود، الخ.
وحتى على مستوى الفكر الاقتصادي، يمكن التساؤل عن الطبيعة الفيزيوقراطية للنظام العائلي المعيشي الكبير (انظر ملحق حول الادخار)، أو طبيعته المركنتيلية المبنية، حينها، تباعا، على ريع الأرض أو على التجارة، ومدى تفسخ النظام القبلي السوسي وبداية طلائع الرأسمالية (…). وعلى ما يبدو، لم تكن الدورة الاقتصادية مطلع القرن الماضي بعد، “إنتاج نقدي” بعد، وإنما ذات طبيعة إنتاجية فعلية.
كما يمكن مقارنتها بما كانت عليه أوروبا بداية القرن 17 وحتى القسم الأول من القرن 18، تلك الحقبة التي درسها كل من ويليام بيتي وبوا جلبير وكانتيون، لتأتى صنافة فرانسوا كيني (1758) أكثر شمولا من دورات من سبقوه. ويمكن اعتبار هذه الترسيمة من أهم ما أنتجه الفكر الاقتصادي للقرن 18، حيث تدور كلها حول ملكية وملاكي الأرض، من أصحاب الريوع، والطبقة الفلاحية – المنتجة ثم طبقة “الصناع الحرفيين”، الذين كانوا يعتبرونهم – آنذاك – بالطبقة العقيمة (هكذا).
ولازالت هذه الصنافة – مجازفة – ذات أهمية إلى اليوم في البلدان المتأخرة، ومنها المغرب – قسرا – ولو انه لا يمكن عزلها عن “الصنافة – الأساس”: التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية – التابعة والمتخلقة المهيمنة! لما للمضاربة بالأرض، دون الإنتاج الصناعي الفعلي من أهمية.
والحال أن ما قد يهم الطالبي – أكثر – هو أن يكون في ذلك “وصية”! أن يستحث ويستنطق المخطوط ويستنفر الوثيقة القابعة في مكتبة العائلة، فيعيد لها الحياة ويحتفي بعيد ميلاد آخر وجديد لها (هنري ميلر) !
الذي يحيرني هو موقف احمد الطالبي من “الثقافة“، من “الثقافة، بعد حين”؟ هل كان الطالبي يوما مثقفا؟ نعم، بمعنى ما وحتى بمعنى مثقف كبير من عيار إدوارد سعيد حيث المثقف من يزعج السلطة ! واحمد الطالبي كان ممن يزعجها بامتياز. هل كان حمل السلاح يتعارض مع حمل القلم؟ هل كان حمل “الفردي” – في حينه مبررا؟ تمليه الضرورة؟ هل تأجيل توعية الناس كان موفقا، أم لم يكن للسياسيين في ذلك، من بُدّ؟ حتى أن منهم من بارك – من الوطنيين – مشاهدة الملك محمد الخامس في القمر؟. بالنظر إلى ثورة لم تكتمل ( ) أو لـ”ثورة بدون مجد” (المهدي بنونة)، هل كان تقدير زمان ومكان الثورة – حينها – تقديرا سياسيا ملائما؟ هل مخاطبة الهواء والحجر أصبحت – اليوم- أهم من مخاطبة البشر والعقل والفعل؟
الذي يحيرني – اليوم – هو “تنكر” احمد الطالبي المزدوج: تنكره في حمله للسيف وتنكره في حمله للقلم؟ أن يحمل البندقية لما قد يتطلب الأمر حمل القلم، من جهة وحمل القلم للتنقيب عن الأسرار، لما يتطلب الأمر حمل مشعل الثقافة، والتنوير قبل العمل السياسي والحركي، من جهة أخرى؟
أم أنه لم يعد جدوى للعمل السياسي أصلا، وأحرى الحزبي، من جهة أخرى. ما يقلقني هو أن أحمد الطالبي يكاد يخلف العهد والموعد مرتين، أن يتنكر مرتين، أن يكون على الهامش (touche) مرتين، أن يخطئ مرتين (…) وهل سينجح في أن يستدرك بسرعة ضوئية الأخطاء، مع المسافة اليوم؟
أم أن – مما يجب أن نسلم به – للتاريخ مفعوله السري الذي ينفذه في غفلة منا، إذ يعلمنا أن كل شيء مجهز بـ”خطأ”، وأوله ذواتنا، وهل صراحة طرح “سؤال الخطـأ” جدي، (الكباص ع. الصمد،( 2022) ص 7) لملامسة موضوع بحجم “الشرخ التاريخي” (الكباص ع. الصمد ص 7)/ “التأخر التاريخي (ع. الله العروي، الإيديولوجية العربية المعاصرة1967/2011 والعرب والفكر التاريخي، وكذا أصول الحركة الوطنية المغربية…)، كأثر مزدوج للاستعمار ولبنيات المحافظة الشبه-إقطاعية الماقبل رأسمالية والهجينة، في احتكاك مع هيمنة الإمبريالية، الذي يخترقنا كذات جماعية، بين ما نحن عليه وما نتوهمه عن أنفسنا، أي درجة التقدم الحاصل في تجربتنا. ثم لما تقبل بمنطق الذاكرة كـ”قدر”، فلابد أن نقبل أيضا بسداد الدين/ “دين النسيان”، الذي يحدد الذات كنسق من الخسران، فيكون علينا أن نتذكر ونكتب لأننا متورطون سلفا في الدين (كما نبه إلى ذلك الكباص، ص 8) !
هل يمكن للتذكر والكتابة أن يُبلسما جرح النسيان والإنقاذ من الخسران؟ أي طريقة تلك التي نهجها الطالبي بمذكراته حول الأسرار، في الاختفاء: طريقة “الاختفاء الإيديولوجي” أم طريقة “الاختفاء في السر”، هذه الأخيرة، إذ هي حتما “طاقية مختلفة”!
إننا نفترض في قراءتنا السريعة – هاته – أنه – على الأقل في هذا الجزء من عمله الشامل – إنه اختار الجبة/ الجلباب الثانية – طريقة “الاختفاء في السر”، لأن “السر”، كما يقول هايدجر لا يُعرف عن طريق الكشف والتحليل وإنما فقط في الحفاظ عليه، كما هو، بما هو “سر”، ومن الطريقتان في الاختفاء، اختار “نظاما اجتماعيا” متباينا ومختلفا من “أنظمة الحقيقة”. ثم ماذا يعني ذلك وماذا يترتب عنه من مكانة ودور ووظيفة المثقف والثقافة لديه، لِمَا أصبحت تعاني منه أهمية المثقف في الأنظمة المجتمعية التي أصبحت تقوم على الأسرار والكنوز والعجائب والغرائب (…)؟
لعله/ إنه غياب “صوت المثقف” في شهادة لعبد السلام بنعبد العالي (2015) على طول الحقبة التي كتب فيها العروي ع. الله (1999-2007) خواطر الصباح الأخيرة، ولربما إلى اليوم؟
وسينضاف هذا الاختفاء الأدبي الطوعي إلى اختفاء سابق له في الزمان، الاختفاء – السياسي أو المنفى القسري/ بعد السجن لأزمنة الرصاص، ليظهر الطالبي على حقيقته/ المطلقة، عاشق للعبة الاختفاء، الاختفاء المزدوج، إذ هو كل شيء، إذ هو كل شيء إلا أن يأتيك مباشرة! فيما هو يأتي مباشرة – بمعنى ما – لمقارعة الحكم بالعنف الثوري – سابقا- أو لسبر أغوار “سوس العالمة” عبر الوثائق والأحداث والشخوص والأمكنة والأزمنة (…)!
قد يريد الأستاذ أحمد الطالبي أن نناقشه في أربعة تيمات على الأقل:
- الوجد والمعرفة.
- السلطة والمعرفة.
- المرأة السوسية والتأسيس الروحي والمعرفي للأسرة.
- أعلام وأدب وشعر سوس العالمة.
- الانتماء و..الغربة (إلى حين).
لكن الذي يهم – في رأيي – هو الوقوف على ثلاثة مسائل/ أسئلة كبرى، حول الأسرار ومعانيها، حيث السر ظهوره والطالبي جزء منه (نيتشه) وحول نقض علاقة الشيخ بالمريد (حمودي)، وحيث الحركة الوطنية والعمل المسلح (الفقيه البصري وأحمد الطالبي، وكذا قراءة بن بركة والعروي 1965/1967).
القسم الثاني: التيمات الثلاثة الأساس في عمل الطالبي:
سنتطرق إلى الوقوف على معنى “الأسرار” من محلها “واضمحلال دور المثقف وما تبقى من ذكرى الحركي؛ ثم نحاول رسم النسق الفكري -الأساس للمذكرات مقاربة الشيخ والمريد وعسر التجاوز النقدي، وفي الأخير سنقترح بعض معالم النهضة والإصلاح لدى الحركة السلفية – الوطنية المغربية ومخرج “الفعل الثوري”.
الوقوف على معنى “الأسرار” و”الغياب” و”المثقف” وذكرى “الحركي” فيما قيل عنه.
سنحاول القبض على بعض نزوع الطالبي المثقفية – ربما في ما نذر – للوقوف – بعدئذ – على بعض علامات وإرهاصاته الحركية الشابة (…) والمتمردة (…) والغياب القسري (…).
الأسرار من محلها، أو من محلاتها وزمنها أو أزمنتها، إذ أن وجود سوس – ككل وجود – ينوجد في الزمان والمكان، في الزمكان، حكمة أو موعظة، أو “هكذا كلام” وليس أي كلام، وإنما “الكلام المفيد” (ص 93)، والذي بدأ صَدَفَةً منغلقة على نفسها، حاملة لمكنونها، بداية المذكرات لعالِمٍ – عابر، وما هو بعابر، ينطق بحكمة ولا يبالي – إلى آخر صفحات المذكرات، حيث يبدو معسول كلامه جليا لا منغلقا، وحاملا – على طول المتن – أسراراً وأسرار، حكايات وحكايات، دروس ودروس (…)، قد تذكر بيت الشاعر حافظ ابراهيم، مع حفظ المبنى والمعنى والبوح:
أنا سوس في أحشائها الذر كامن
فهل سألوا الغواص/ البحاثة/ المهتم/ الحركي عن صدفاتي
لماذا الحديث عن الأسرار وليس عن الحقيقة؟ أليس الاختفاء نظاما خاصا من أنظمة الحقيقة؟ هل يكفي الوقوف الشخصي على المعلومة لضمان حقيقتها وموضوعيتها وعلميتها؟ أيكفي أن تتسرب المعلومة لمعرفة الأسرار، بما هي أسرار؟ ألا يشكل التستر جوهر السر؟ هل بقي هناك اليوم سر لم ينفضح؟ هل ما زال من دور للمثقف والثقافة؟ أليس التخلي عن الثقافة شرط لملاحقة الأسرار والأخبار والتفاهة و”الثقافة لايت” والفرجة والإشاعة (…)؟ (انظر بنعبد العالي ع. السلام 2015) والبوب (…)!
وما علاقة السر بالإيديولوجيا وبـ”الاختفاء الأديولوجي” (هايدجر، بنعبد العالي، 2008)؟ سوس العالمة؟ وأحيانا يردفها الطالبي بـ “الجاهلة”، أيضا. والحال أننا لم نقف قط في المذكرات ولم نفطن إلى إحدى علامات ذلك “الجهل الممكن والمطبق” – على طول سرد التقصي الأدبي والعلمي، الممتع والصعب، لآثار “سوس العالمة” الكبرى: مراكش طبعا، لكن فاس والرباط وتارودانت (…).
هذا أكيد – لكن الطالبي يعمل من حيث يُخفي– إلا في ما نذر، لمّا يشير مثلا إلى تحرره من إرث العائلة الكبيرة، أن جهل العوام مطبق! وأن لا مجال – الآن وهنا – للخوض فيه، وكأن رفع هذا الجهل الكاسح غير ممكن – إذ هو ليس على قائمة الأجندة الحركية – الآن وهنا! إنها “مسلمة” أو غير “مفكر فيها” حقا.
لم يعد انتماءه يستند إلى نواميس العشيرة، ليعتمد السير على قدميه وليجوب المسافات، فتضمحل الحدود أمامه، ويختفي رنين النسب الموروث والعشائر، وليسلك مرجعيات جديدة يتماهى معها ردحا من الزمن (ص 9)، تعبيرا منه على “قطائع” أكيدة على طول ترحاله الخصب/ الباحث عن الخصب، مما ورثه عن القبيلة والأعلام والجذور (…)، أو هكذا استهل المذكرات في “سيرة مكان” (ص 9)، لكن هل تستقيم القطائع مع الجذور… مع الاستمراريات، وكيف؟
لعله يعلم أن “لا علم دون جهل”، أو أن لا علم إلا بجهل – نسبي أو مطلق – وان لا علم إلا بمصارعة ومكابدة ومواجهة الجهل وثقافة الظلام والاستعباد والاستلاب (انظر مثلا الاستيلاب المتعدد الأوجه الذي يثيره – كمثقف هذه المرة – من المرات القليلة والمتمردة “بالفطرة” على العلاقات الاجتماعية المحافظة – التقليدية و”نظام المشيخة” الكلاسيكي في ما كتبه عن الشيخ والمريد (ص 164) (…).
وهو الذي خبر – أيضا – في ما أشار إليه بعجالة “الفكر المادي – الجدلي” وعمل به، أو عمل بإحدى قراءاته العملية – النشاطية – في الميدان السياسي – والذي لم يشفع له الجرد والتحليل لمكامن ثقافة وأدب وعلوم سوس الكبرى – السلفية منها والسلفية الجديدة والمنفتحة، التوجه مباشرة إلى عوام الناس – خارج النخبة في المدارس وقمم المشيخة – اعتماد التوعية السياسية والتثقيف لـ”قواها الحية” من فقراء وفلاحين ومعدمين وعبيد (…)، وحيث لا يزال المنقول يغلب على المعقول لدى النخبة – التقليدية – نفسها.
وكاد الجانب السياسي من حياة الطالبي أن لا يظهر قط للقارئ، إذ يُشار إليه بالتلميح، ليختفي إلى حين ما سيأتي في أجزاء المذكرات الأخرى، وهذا ما يبدو للذهن! إلا من يقرأ بين السطور و”يفلي” الكلمات والجمل العابرة، في “كلام غير عابر”، مرة لما أثار أهمية التحليل العلمي في التغيير الاجتماعي، وأخرى لما ودع المختار السوسي أو ودع العم الشاعر الحسن البونعماني، دون أن يكشف له عن نيته لاختيار المنفى (وهو الذي شجعه على تسجيل بحثه العالي حول الزوايا في المنطقة)، وأخرى بعد عِلْم – لما كاد العم أن يتدخل له عند الملك الحسن الثاني ليُسهّل رجوعه من المنفى – متى إتفق وأراد ذلك، وحتى لمّا يتحدث عن أعلام سياسيين اليوم – كابن سعيد ايت إيدر أو مصطفى الوالي السيد أو بن بركة وغيرهم، فهو لا يتحدث عنهم بهاته الصفة – السياسية – وإنما بارتباطهم بسوس العالمة، ومن ثمة بخلفياتهم الثقافية، وبما لمدارس سوس من اثر وفضل على تكوينهم الفكري (…)! ويمر (…)!! لنلتقط انتماءه للاتحاد الوطني لطلبة المغرب – حينها – من خلال مسؤوليته النقابية بالمعهد المراكشي أو انتسابه لليسار الطليعي، الخ.
والواقع – وهو معروف عنه على الأقل في الجزء الأول من مشروعه – أنه نذر نفسه داخل موجات الأحداث والعائلات والأمكنة والعلماء. لم يكن يتحدث عن نفسه داخل المذكرات، وإما شاهد عن الأعلام والعلامات، إلى أن قفل في باب ختامي مع علاقته المباشرة مع السوسي المختار، فكان الباب الفريد/ “أنا والمختار”/ الباب الذي يستخلص فيه الأثر لعلاقة واعدة مع واحد من أعلام الفكر السلفي الحديث (ص 237).
كانت الأحداث تروى بسلاسة وانسياب كرونولوجي، تارة وبـ”مسلط عاكس”، تارة أخرى، وكان يشخص الآثار، فيما هو احد توقيعاتها البارزة (انظر الكباص ع. الصمد، ص6). وقد نهج في ذلك أسلوب الصحفي العارف بمجال السرد والصور والشعر والنثر والوجد (…)، وكأن الزمن يقف عند “سوس العالمة”. ولن يستأثر عليه يوما أن يقوم بتصوير المذكرات -كفيلم توثيقي – يقف فيه الراوي موقف المنقب والشاهد وقطعة من السر، تارة طفلا يافعا وأخرى شاب في مطلع العمر والعنفوان، يطل على الأعلام والأحداث والصيرورات، وأخرى مريدا مميزا ومشاكسا ومتعلما، وأخرى مناضلا محتفيا
باليسار الاتحادي الوطني – خاصة بمراكش (..) وسنراه – في الأجزاء الأخرى متصلا برجالات اليسار في الجزائر وباريس (…) الخ.
لم يكن راويا فقط أو ستارا برانيا او غطاء خارجيا لحكايات من تكلموا وحكوا وسردوا، ولكن كان على علاقة –كراوٍ- بما يرويه، ولم يمنعنا من أن نمثله كجزء من القصص والروايات، أي من بنيه ما حكى وما روى، ولمن يمنعنا من النظر إليه كحجاب، كطاقية/ رزة/ جلباب السوسي كـ”جزء من الديكور”، إذ هو سمة من سمات سطوح الحكي والرواية (…)! ولأنه يحاول حفظ “الأسرار كما هي عليها”، ولو لم يشفع له من حكوا عنه (ص278)، أو من “قالوا عن الكتاب” لما عرفنا ما تشوقنا إليه منذ البداية – حركية الرجل – إذ لم يتحدث عن هذه الزاوية – نفسه – إلا باقتضاب وتلميح عابر وشديد: نضاله كطالب بجامعة تُغلب النقل على العقل ومن أجل التنوير، باستجلاب رواد الحركة التقدمية -آنذاك- لرحاب الجامعة، وحدود ذلك في مجتمع عريض – عدا النخبة – لا يقرئ ولا يعي واقعه ومصيره! وانتقاله المُكره والمباشر إلى العمل السري والثوري (…)!
فهل استطاع مغرب الألفية الثالثة الخروج فعلا من القرن التاسع عشر، ومن مثالب النظام التقليدي الشبه-إقطاعي الممتزج بسيطرة الاستعمار الجديد وضرورة التحرر من آثار مدرسة بنيوسف/ مراكش التقليدية الأصيلة، إذ يعتبر الطالبي واحد من أبرز خريجيها؟ وهل تم تثوير مناهجها ومحتوياتها، وكيف ذلك؟ ما هي الأسباب التي حالت دون بلورة برنامج اليسار المغربي في الملموس؟ ولماذا يتشرذم اليسار المغربي؟ وهي أسئلة ظلت تراود الطالبي وتغص حلقه، أثناء النقاش.
لعل الجواب سيعتمد على ما جاء به ابن بركة في الاختيار الثوري، وهو الاسم الذي بصم به الطالبي حركة البصري الثورية، وقد نذهب إلى تقييم عبد الله العروي، لنخلص إلى مدى جدوى البديل الذي يقترحه هذا الأخير لبناء ما أسماه بـ”الاشتراكية العصرية”؟
الآن وقد تعرضنا للموضوعة الأولى، حول الوقوف على معنى “الأسرار” و”الغياب” و”المثقف” وذكرى “الحركي” فيما قيل عنه، بقي أن نتساءل عن رسم النسق الفكري -الأساس للمذكرات الطالبية عبر مقاربة الشيخ والمريد وعسر التجاوز النقدي/ الثوري، وفي الأخير سنقترح بعض معالم النهضة والإصلاح لدى الحركة السلفية – الوطنية المغربية ومخرج “الفعل الثوري” عبر حركة “الاختيار الثوري” (انظر الكتاب الثاني للطالبي حول الجزائر حكاية عشق، ومقالنا التقديمي له)، إذ يمكن قراءتها عبر نقط متعددة (محمد شيكر 2017)، نذكر منها النقد الذاتي، فمسألة توافق والصراع في دائرة مغلقة وإغفال التعريف بالذات والارتجال والاستهتار بالوقت وانعدام الرؤية، من جهة وكذا دراسة البنية الاجتماعية المغربية والأداة الثورية، فالبديل الثوري لدى حركة الاختيار الثوري، من جهة أخرى.
ودعنا ابن سوس العالمة/ سوس المعسول وكله تفاؤل من مستقبل اليسار ببيت شعري جميل. من جهتنا نودعه بمثله صاعين، إذ في جرأته لحمل السلاح أو القلم، حق في الطالبي قول المتنبي، حيث شعر:
الخيل والليل والبيداء تعرفني ** والسيف والرمح والقرطاس والقلم
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي ** وأسمعت كلمـاتي من به صـممُ
ملحق: وصية الادخار
وقد أعفي من يحضر، اليوم، من أن أعدد دروس تلك الوصية /”وصية الادخار” كأن أبيّن مرجعها القروسطي في القول: قول الله وقول الرسول، أو أن أسهب في تسطير دررها في الدليل والتفسير، وفي ما تسمح به تجربة الناس، من موعظة، في الزمكان – الدهر، وفي بعض تجليات الاقتصاد الفعلي لمنطقة سوس – آنذاك – وفي الأزمات التي ألمت بها وكادت أن تعصف بها.
ثم كيف لصنافات اقتصادية عشية الرأسمالية الغربية/ الاستعمار يمكن أن تسعف لقراءة بعض خصائص اقتصادها المحلي الهش، والذي يستطيع أن يعيد إنتاج نفسه بالكاد، على الطريقة المبسطة – (انظر فرانسوا كيني، خاصة)، وأثر كل ذلك على العلاقات الاجتماعية – والتجارية، خاصة (…). لكن لابد من الإشادة على أنها بحق وثيقة فريدة وغنية، جديرة بالدرس الأركيولوجي – التاريخي – الاقتصادي – الاجتماعي – الماقبل رأسمالي، مع الترسخ التدريجي لقيم التبادل السلعي الموسع.
ثم لابد أن نذكر بالمحدودية العلمية لتلك المفاهيم في منطقة سوس – آنذاك. إذ لا يمكن أن نجد لها مكانة مطلقة – أو مكتملة – في إبدال المقريزي، مثلا، أو في دورة ابن خلدون حول الكسب والنقود. وقد قام الأستاذ العروي ع. الله بمسح شامل لأهم المفاهيم، جذورها وتطورها وتقعيدها في النظام الرأسمالي – الغربي – الليبرالي ، كمفهوم الحرية ومفهوم الدولة، الخ.
بعض نقط الوثيقة:
- لا تجد في سنين المجاعة إلا ما ادخرت في سنين المخصبة.
- عليك بالادخار وتجنب الإسراف.
- مواد الادخار: الإدام – الجلبان – اللفت اليابس – الخز اليابس – الأركان – الخروب، وخاصة الزريعة “زريعة كل شيء”.
ملاحظتي: انظر كيني في الجزء من الزرع الذي يسعف إعادة الدورة الاقتصادية.
الأزمة:
– مرت على سوس عامين ونصف من المحن والجوع والجراد والوباء (حيث – أكل كل شيء الأشجار والخضر).
- وغارت الآبار.
- وقسحت القلوب.
- وعم التقشف وقلة الرحمة على الأبناء…
- المقايضة والتبادل التجاري الصغير والمحدود (بيع – شراء…).
المراجع
- أحمد الطالبي المسعودي (2022)، مذكرات/ “الأسرار من محلها”، المغرب.
- عبد السلام بنعبد العالي (2015)، البوب- فلسفة، دار توبقال، المغرب.
- عبد الفتاح كيليطو (2015)، تقديم البوب، فلسفة لعبد السلام بنعبد العالي، المغرب.
- عبد الصمد الكباص (2022)، تقديم كتاب “الأسرار من محلها”، المغرب.
- محمد شيكر (2016)، ما المثقف؟ أو المثقف وساندروم الوصاية، المغرب.
- المهدي بنونة (2001)، أبطال بدون كجد، المغرب.
- عبد الله العروي (1967/2011)، الإيديولوجية العربية المعاصرة، المغرب. انظر أيضا العرب والفكر التاريخي وكذا أصول الحركة الوطنية …
- عبد الله حمودي (2019)، الشيخ والمريد، المغرب.
[1] – أستاذ باحث، كاتب عام الحزب الاشتراكي الموحد – تمارة – المغرب.
[2] — ندوة تقديم وتوقيع ومناقشة كتاب مذكرات “الأسرار من محلها” لأحمد الطالبي المسعودي (2022) تمارة – المغرب، شارك فيها الأستاذ عبقادري نورالدين بقارءة أدبية – لغوية – فنية وافية في الكتاب وكذا نسقها العلمي الحروني، وسيرها عبد الواحد حمزة.






