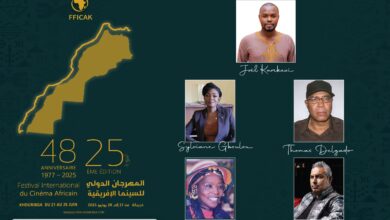نورمان فاركلوف: التحليل النقدي للخطاب- المصطفى عبدون
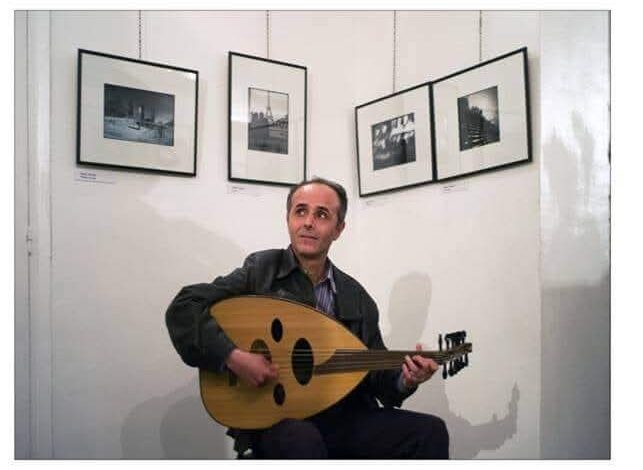
إن الإشكالية الرئيسية التي عالجها “نورمان فاركلوف” في التحليل النقدي للخطاب، ترتبط بعلاقة الخطاب باللغة وبالواقع الاجتماعي، فالخطاب ينتمي إلى عالم اللغة أو العلامات باعتبار أن اللغة هي مجموعة من العلامات، لكن كل علامة لها علاقة بالواقع الاجتماعي، من هنا تطرح إشكالية: هل اللغة تصنع الواقع أم أن الواقع الاجتماعي هو الذي يحدد اللغة؟ بعبارة أخرى هل الأشياء المادية في الواقع قائمة بذاتها أم أنها لا تكتسب معنى إلا من خلال الخطاب؟
ومن هذه الإشكالية تفرعت أسئلة بالغة الأهمية حول من يصنع الخطاب وكيف يتغير، ومتى ولماذا؟ وما هي آليات تغيير الخطاب؟ لكن المتفق عليه هو أن الخطاب لا ينتج من فراغ، بل في إطار سياق اجتماعي وثقافي وتاريخي محدد، من هنا لابد من تحليل الخطاب في إطار الممارسة الاجتماعية، ولكي نفهم أي خطاب، فمن الضروري أن نربط بين الخطاب والسياق الاجتماعي والثقافي، بل ينبغي أن نربط بين هذا الخطاب ومجمل الخطابات التاريخية والمعاصرة.
يُعتبر “نورمان فاركلوف” أول من طور دراسة التحليل النقدي للخطاب، وهي منهجية تعتمد على كثير من المباحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية مثل اللغويات النقدية، كما ترتبط بدراسة العديد من النظريات الاجتماعية. والـمقـصود باللغة بوصفها، شكلا من أشكال الممارسة الاجتماعية هو أن اللغة جزء من المجتمع وأنها صيرورة اجتماعية مشروطة اجتماعيا بالجوانب غير اللغوية من المجتمع.
ويأتي ارتباط اللغة مع الحالة الاجتماعية من كونها الإطار الوحيد للتعبير الإيديولوجي، ومن كونها ميداناً للصراع على السلطة وعاملاً مهماً فيها. وهنالك من الباحثين في التحليل النقدي للخطاب الذين اعتمدوا على الجوانب السيكولوجية في الخطاب، حيث يتم تحديد الجانب النفسي-الاجتماعي بين بنية المجتمع والخطاب. كما أن هنالك دور كبير للجانب التاريخي في الدراسات المعنية بالتحليل النقدي للخطاب.
لهذا التحليل حسب “فاركلوف”، منهجية تقوم على ثلاثة مستويات: المستوى الكبير هو النصي واللغوي والمتوسط هو الخطابي والصغير هو العلاقة بالنصوص والخطابات الأخرى. وكل مستوى يوافق بعدا: الأول بعد النص والثاني بعد الممارسة الخطابية والثالث بعد الحدث الخطابي. على المستوى الأول تُحلل أساليب النحو والمجاز والبلاغة، والثاني عوامل إنتاج النص وتوزيعه واستهلاكه، والثالث التيارات المؤثرة في النص. ومن الضروري أن نميز بين التعامل مع اللغة نصاً والتعامل معها خطاباً، فدراسة اللغة نصاً، يستلزم دراسة كل الوحدات التبليغية المتماسكة من حيث التركيب البنائي لنقل الخطاب، أما الخطاب فهو العملية المعقدة من التفاعل اللغوي بين المتحدثين والمستقبلين للنص.
من حقل الدراسات اللغوية، انتقل عالم اللغة الإنجليزي “نورمان فاركلوف” إلى تطوير نموذج للتحليل النقدي لكافة أشكال الخطاب (إشكاليات تحليل الخطاب الإعلامي، محمد شومان، مجلة الحياة السعودية، العدد 16124، 2007 بتصرف http://daharchives.alhayat.com)، ثم قام بتوسيع مجال عمل نموذجه التحليلي ليشمل كافة مجالات البحوث الاجتماعية، فالتحليل النقدي للخطاب هو تحليل للعلاقات الجدلية داخل الخطاب، والذي لا يشمل اللغة فقطـ، بل السيميولوجيا والصور المرئية وكل عناصر الممارسة الاجتماعية، ومع ذلك يؤكد “فاركلوف”، أن التحليل النقدي للخطاب يهدف إلى توضيح كيف أن التغييرات في استخدام اللغة تعكس التغييرات الاجتماعية– الاقتصادية والتي ترتبط بعلاقات القوة والهيمنة في المجتمع، لذلك يدعو “فاركلوف” علماء الاجتماع إلى تجديد أفكارهم ومناهجهم وأدواتهم البحثية لدراسة الخطاب بغض النظر عن نتائج تلك الدعوة.
وكما يقول “فاركلوف”: عندما ننظر للغة بوصفها خطاباً وممارسة اجتماعية، فإننا نلتزم ليس فقط بتحليل النص وعمليات الإنتاج، ولكن بتحليل العلاقات بين النص والإجراءات، وظروفها الاجتماعية المتعلقة بظروف السياق والمتعلق بالظروف الأبعد خاصة بالتراكيب الاجتماعية والمؤسساتية. ووفقا لنموذج “فاركلوف”، فإن تحليل أي نمط معين من الخطابات، يتضمن تناوب التركيز علي جانبين مترابطين و متكاملين هما: الأحداث الاتصالية، ونظام الخطاب، ويشمل الجانب الأول على تحليل للعلاقات القائمة بين ثلاثة أبعاد أو ملامح للحدث الاتصالي هي:
- النص: قد يكون مكتوبًا أو شفويًا، والنصوص الشفوية قد تكون مذاعة فقط أو مذاعة ومرئية كما في التليفزيون، وفي هذا المستوي يجب تحليل المعجمية أي مفردات اللغة، ودلالات الألفاظ، والنحو وصوتيات النص ونظام كتابته، وكذلك التماسك المنطقي، والتركيبات النصية والوظائف المختلفة لكل جملة، وسيميولوجيا النص من كافة النواحي، وما ينتجه كل ذلك من معاني متعددة ومختلفة، سواء كانت معلنه أو مضمرة.
- الممارسة الخطابية: يقصد به تحليل عمليات إنتاج النص واستهلاكه، والنواحي النفسية والإدراكية الخاصة بكيفية توصل الأفراد إلى تأويلات معينه أو ما يعرف بالعمليات التأويلية، إضافة إلى تحليل التناص والذي يهدف إلى الكشف عن كيفية تشكل واستخدام النصوص وتشابك الأنواع الأدبية والخطابات المختلفة الممزوجة في النص، والتي قد تتضمن استخدامًا تقليديا لأنماط موجودة بالفعل أو استخدامًا إبداعيًا أو مزجًا بينهم
- الممارسة الاجتماعية الثقافية للتيارات الاجتماعية والثقافية السائدة والتي يشكل الحدث الاتصالي جزءًا منها، ويتناول التحليل هنا مستويات مختلفة، منها السياق المباشر للحدث أو السياق الأوسع نطاقا للممارسات المؤسسية، ويمكن تناول الكثير من جوانب الممارسة الاجتماعية الثقافية لعل أهمها الجانب الاقتصادي، والسياسي المتعلق بقضايا القوة والإيديولوجية، علاوة على الجانب الثقافي المرتبط بالقيم والهوية.
ورغم أهمية نموذج “فاركلوف”، إلا أنه يعتبر نوعًا من التفكير النظري المجرد حيث لم يختبر على نحو جاد، ولم يستخدمه سوى عدد محدود من البحوث والدراسات، وهذا الوضع يختلف عن منهجية “ميشيل فوكو” في تحليل الخطاب والتي ربما اكتسبت طابعًا عمليًا تطبيقيًا عميقاً وشاملاً ساعد في تطوير وتجديد مكوناتها النظرية.
وبغض النظر عن نتائج تلك الدعوة، تكتفي الدراسة الحالية بعرض ومناقشة أعمال “فاركلوف” في علاقتها بالأساليب والهويات، حيث يمكن القول بأن “فاركلوف” تأثر بشكل واضح باللغويات النقدية وبأعمال “ميشيل فوكو” وأعمال “غرامشي” عن الهيمنة الإيديولوجية، إضافة إلى تأثره الواضح بعالم الاجتماع الفرنسي “بيير بورديو”، ويتفق “فاركلوف” مع علماء اللغة جزئيًا في تعريفه للخطاب، ثم يؤكد اختلافه معهم. فالخطاب هو اللغة المستخدمة لتمثيل ممارسة اجتماعية من وجهة نظر معينة، والخطابات تشكل وتعيد إنتاج الهويات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية وتمثل نظم المعرفة لمستخدم اللغة، ويعتبر كل خطاب بجزء من نظام خطابي داخل مؤسسة معينة أو مساحة معينة من المجتمع.
يضع التحليل النقدي للخطاب تصورًا للممارسات الخطابية لمجتمع معين – أي الطرق المعتادة لاستخدام اللغة من هذا المجتمع – باعتبارها شبكات معينة، أطلق، عليها أنظمه الخطاب، ويتكون نظام الخطاب لمؤسسة اجتماعية أو مجال اجتماعي معين من كافة الأنماط والممارسات الخطابية المستخدمة في تلك المؤسسة أو ذلك المجال، كذلك تعتبر نظم الخطاب مجالاً وبؤرة للصراع والنزاع الاجتماعي وأحد مجالات الهيمنة الثقافية
ويخلص “فاركلوف” إلى أن الخطاب هو أحد أشكال الممارسة الاجتماعية، ثم يستخدم الخطاب بمعنى أضيق حين يقول: الخطاب هو اللغة المستخدمة لتمثيل ممارسة اجتماعية محددة من وجهة نظر معينة، وتنتمي الخطابات بصفة عامة إلى المعرفة وإلى بناء المعرفة. يتطلب تحليل الخطاب استرجاع الظروف التي أدت إلى إنتاج النص، وهو ما نسميه بتحليل السياق؛ فالسياق جزء أساسي من عملية تحليل الخطاب، لا تعتمد العمليات الاتصالية فقط على السياق حتى تفهم، بل إنها تغير ذلك السياق، ويمكن أن ننشئ داخل السياق النصي سياقًا آخر له مسرده الخاص من المؤشرات وبالفعل يمكن إقحام سياقات جديدة داخل السياقات المركبة
فالخطاب هو كل الأشياء التي تُكون العالم الاجتماعي، بما في ذلك هوياتنا، أو بعبارة أخرى الخطاب هو واقعنا الاجتماعي وإدراكنا لهويتنا، أي أنه من دون خطاب لا يوجد واقع اجتماعي، ومن دون فهم الخطاب لا يمكن أن نفهم واقعنا أو تجاربنا أو أنفسنا، ومن ثم تبدو أهمية تحليل الخطاب. فمن خلال منهجية تحليل الخطاب نستطيع تفسير الواقع الاجتماعي.
يهدف تحليل الخطاب إلى فك شفراته بالتعرف على ما وراءه من افتراضات أو ميولات فكرية أو مفاهيم. فتحليل الخطاب عبارة عن محاولة للتعرف على الرسائل التي يود إرسالها، ويضعها في سياقها التاريخي والاجتماعي، وهو يضمر في داخله هدف أو أكثر، وله مرجعية أو مرجعيات وله مصادر يشتق منها مواقفه وتوجهاته. إن الخطاب أكبر من النص، وأشمل من الإيديولوجيا، فهو يؤثر في نوعية وكيفية استخدام اللغة.
إن تحليل الخطاب لا يتعلق فقط بأسلوب التحليل، بل إنه يشكل منظوراً بشأن طبيعة اللغة وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية والواقع الاجتماعي، كما يتضمن الخطاب مجموعة من الافتراضات النظرية وما وراء النظرية. وبينما تعمل مناهج التحليل الكيفي على فهم الواقع الاجتماعي، يحاول تحليل الخطاب التعرف على كيف تم إنتاج هذا الواقع الاجتماعي، وهذه هي أهم مساهمة من جانب تحليل الخطاب، إذ يفحص كيف تقوم اللغة ببناء الظواهر وليس كيف تقوم اللغة بعكس وإظهار الظواهر، كما يفترض تحليل الخطاب أنه لا يمكن التعرف على العالم منفصل عن الخطاب.
إن التحليل النقدي للخطاب يعكس اختلافات فلسفية ومنطلقات متباينة لأصحابها، ومن ثم رؤى للعالم ومناهج مختلفة، الأمر الذي يشجع على دراسة هذه المنطلقات النظرية والمنهجية بحيث يرد الباحث كل اختلاف أو تباين حول مفهوم الخطاب وعلاقته باللغة والواقع الاجتماعي وآليات تغيير الخطاب، إلى الجذور الفلسفية والمنطلقات التي يعتمد عليها أصحاب المدارس والاتجاهات المختلفة في دراسة واستخدام الخطاب، لكن الإشكالية هنا أنه لا يوجد نقاء معرفي بين نظريات ومدارس واتجاهات تحليل الخطاب، بل هناك أنواع من التداخل والاستعارات المعرفية والمفاهيمية بين هذه المدارس والاتجاهات بمعنى أنه من الممكن العثور على اختلاف في الأسس المعرفية والمفاهيمية ل”نورمان فاركلوف” أحد رواد تحليل الخطاب، ورائد آخر هو “فان ديك”، ومع ذلك فهناك ثمة مشتركات معرفية ومفاهيمية بينهما، ثم أخيراً يمكن القول إن أغلب مدارس واتجاهات تحليل الخطاب خرجت من معطف “ميشيل فوكو”، ونقلت عنه أو تأثرت بأعماله، ومع ذلك اختلفت معه.
يمكن تحديد الملامح الرئيسية لمدارس تحليل الخطاب، والتي قد تعكس سمات معرفية ومنهجية مختلفة لكنها في الوقت نفسه غير متصارعة بل تنقل عن بعضها البعض وتستخدم مفاهيم مشتركة، تؤلف بينها، وتطورها، دون أن تعترف بسيادة أحدها أو اندماجها في منظومة واحدة، ولعل هذا المشهد يعكس أحد ملامح عصر ما بعد الحداثة، والخاص بنزع الطابع الثابت والجامد للمدارس المعرفية والنظريات الكبرى في العلوم الاجتماعية، في هذا الإطار يمكن رصد محاولات التكامل في الرؤى بين اتجاهات وتيارات ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة، ومحاولات التلاقي بين النظرية النقدية ونظرية ما بعد الحداثة.