الإيديولوجيا وأجهزة الدولة الإيديولوجية-المصطفى عبدون
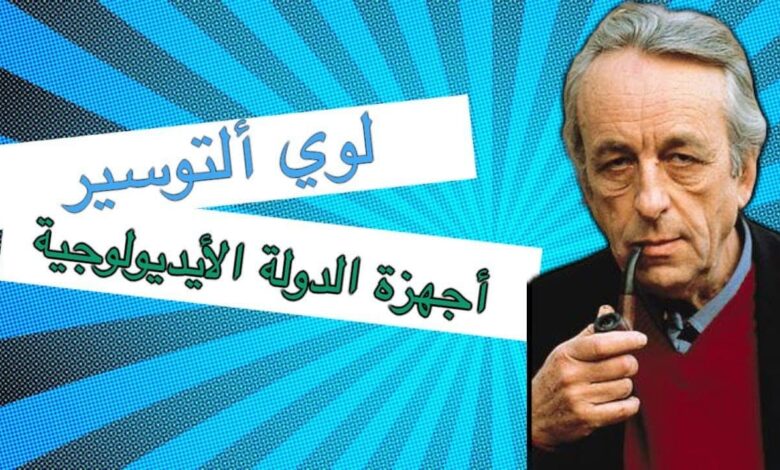
لقد شكل فكر لوي ألتوسير إضافة نوعية وتقدما ملحوظا في الفكر الماركسي والفلسفي عامة، بحيث يعتبر من بين المنظرين الذين حاولوا تجديد وتطوير الفكر الماركسي. ميّز لوي ألتوسير بين نوعين من أجهزة الدولة: أجهزة الدولة القمعية وأجهزة الدولة الإيديولوجية. أما الأجهزة القمعية فهي عتاد الدولة في ممارسة التحكم والهيمنة على الأفراد بواسطة العنف والقمع والقوة المكشوفة من خلال أجهزة الشرطة والجيش وقوانين العقوبات والجزاء، وذلك في مقابل عتاد قمعي ولكن من نوع آخر، وهو الإيديولوجيا أو اللاوعي الاجتماعي الذي يعاد إنتاجه في مؤسسات المجتمع المختلفة مثل الأسرة والمدرسة والكنيسة واتحادات العمال والأحزاب السياسية وأجهزة وسائل الإعلام وغيرها.
إن الفرق بين الجهازين القمعي والإيديولوجي، هو أن الأول يعيد إنتاج السلطة بواسطة العنف المادي والقمع المكشوف، في حين أن الجهاز الآخر يؤدي الدور ذاته ولكن بأدوات “ناعمة”، وبقمع مخفف أو مقنع، إن الجهازين عبارة عن عتاد الدولة ووسيلتها في ممارسة الهيمنة والتحكم في الأفراد، وفي إعادة إنتاج الهيمنة والسلطة وضمان استمراريتهما. وهذا يدفعنا لطرح الأسئلة التالية: كيف حدد ألتوسير تصوره لأجهزة الدولة الأيديولوجية؟ إن أجهزة الدولة الأيديولوجية يجب ألا تختلط في ذهننا بجهاز الدولة (القمعي)، ما الفارق بين الاثنين؟
- أجهزة الدولة الأيديولوجية
ينطلق ألتوسير من أنه يجب ألا نخلط أجهزة الدولة الإيديولوجية بجهاز الدولة (القمعي). جهاز الدولة يحتوي على: الحكومة، الإدارة، الجيش، الشرطة، المحاكم، السجون، إلخ، والتي تمثل ما سماه بـ “جهاز الدولة القمعي”. فالقمعي توحي لنا، بأن جهاز الدولة المقصود هو الذي “يعمل بالاستعانة بالعنف”. وصف ألتوسير “أجهزة الدولة الأيديولوجية” بعدد من الحقائق التي تمثل نفسها للناظر إليها، على هيئة مؤسسات متمايزة ومتخصصة، فاقترح قائمة إمبريقية منها يجب وبوضوح أن تُفحص تفصيلاً، وأن تُختبر وتُصحح ويُعاد تنظيمها. مع كل التحفظات التي يؤدي إليها هذا المطلب، فقد اعتبر أنه يمكننا اعتبار هذه المؤسسات من “أجهزة الدولة الأيديولوجية”:
- جهاز الدولة الإيديولوجي الديني (نظام مختلف الكنائس).
- جهاز الدولة الإيديولوجي التعليمي (نظام مختلف المدارس العامة والخاصة).
- جهاز الدولة الإيديولوجي الأُسري.
- جهاز الدولة الإيديولوجي القانوني.
- جهاز الدولة الإيديولوجي السياسي (النظام السياسي، مشتملاً على مختلف الأطراف).
- جهاز الدولة الإيديولوجي النقابي.
- جهاز الدولة الإيديولوجي الإعلامي (الصحافة، الإذاعة، التلفزة، إلخ).
- جهاز الدولة الإيديولوجي الثقافي (الأدب، الفنون، الرياضة، إلخ).
للوهلة الأولى، يتضح أنه بينما هناك جهاز دولة (قمعي) واحد، فهناك جملة من أجهزة الدولة الإيديولوجية. حتى مع الافتراض المسبق بوجودها، فإن الوحدة التي تشكل هذه “الجملة” من أجهزة الدولة الإيديولوجية كجسد ليست ظاهرة فوراً للعين. من الواضح أنه بينما جهاز الدولة (القمعي) الموحد ينتمي كله للمجال العام، فإن الكثير من أجهزة الدولة الإيديولوجية (على تنوعها الظاهر) هي جزء–على النقيض– من المجال الخاص كما ذكرنا سابقا: الكنائس، الأحزاب، النقابات، الأسر، بعض المدارس، أغلب الصحف، المحافل الثقافية إلخ. لكن ما هو ضروري هو التمييز بين أجهزة الدولة الإيديولوجية عن جهاز الدولة (القمعي). فالفرق الأساسي هو أن جهاز الدولة القمعي يعمل بالاستعانة “بالعنف”، بينما أجهزة الدولة الإيديولوجية تعمل “بالإيديولوجيا”.
يعتبر ألتوسير أن كل جهاز دولة، سواء قمعي أو إيديولوجي، يعمل بالعنف وبالإيديولوجيا في آن واحد، لكن مع وجه تمييز مهم للغاية، يجعل من الضروري ألا نخلط بين أجهزة الدولة الإيديولوجية وجهاز الدولة (القمعي). هذا التمييز المهم هو حقيقة أن جهاز الدولة (القمعي) يعمل بكثافة وبقوة باستخدام القمع (بما في ذلك القمع المادي)، في حين يعمل بشكل ثانوي باستخدام الإيديولوجيا. (لا يوجد جهاز قمعي صِرف).
بنفس الطريقة، لكن بشكل معكوس، فمن الضروري القول أن أجهزة الدولة الإيديولوجية من جانبها تعمل بكثافة وبقوة بالإيديولوجيا، لكن تعمل بشكل ثانوي باستخدام القمع، حتى وإن كان قمعاً غير مباشر. وهكذا، فإن المدارس والكنائس تستخدم أساليب مناسبة للعقاب والطرد والاختيار، إلخ، من أجل “فرض انضباط/تهذيب descipline” عمالها، وأيضاً لفرض انضباط/تهذيب جمهورها. الأمر نفسه ينطبق على الأسرة… وكذلك على جهاز الدولة الإيديولوجي الثقافي (الرقابة، من بين أمور أخرى)، إلخ.
- الإيديولوجيا من منظور ألتوسير
تأسس تصور ألتوسير عن “أجهزة الدولة الإيديولوجية” على التراث الماركسي، الذي يعتبر من أكثر النظريات اهتماما بنمط العلاقة بين الوجود المادي والوجود الذهني، أو الواقع الاجتماعي والأشكال الثقافية، أو الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي، أو البنية التحتية والبنية الفوقية أو غيرها من الثنائيات التي تفرعت في سياق تطور وتنوع النظرية الماركسية. لقد أصبح من المسلمات، أن الماركسية التقليدية قد آمنت بنمط وحيد في تحليل العلاقة بين البنية التحتية والبنية الفوقية، وهي أن الأولى هي الأساس وهي التي تحدد البنية الفوقية. وقد عبّر ماركس عن هذه العلاقة في مقولته الشهيرة: “ليس وعي البشر هو الذي يحدد وجودهم، بل وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم”. إذا كان ذلك كذلك فإن هذه المقولة قد باتت فجة على تلك الصورة التي لا ترى غير نمط آلي وأحادي لعلاقة الوجود الاجتماعي بالوعي الاجتماعي.
إن التصور الذي طوره ألتوسير للإيديولوجيا وحسب ماثيو تول (الإيديولوجيا والقوة الرمزية: بين ألتوسير وبورديو- ماثيو تول/ترجمة: محمود سامي، مجلة حكمة، (hekmah.org يختلف في بعض اعتباراته عن التفسيرات النظرية السابقة للمفهوم، ولكنه حافظ على العناصر الرئيسة الشائعة في التحليلات الماركسية. في كتاب (الإيديولوجيا الألمانية) عرف ماركس وإنجلز الإيديولوجيا على أنها مجموع من الأفكار التي تشوه وتحرف الوعي بشأن العلاقات الإنسانية. هذا التشويه للوعي دائماً ما يمثل وضعاً اجتماعياً معيناً. الطبقة التي تتحكم في وسائل الإنتاج، هي أيضاً -كما يقال عادة- التي تتحكم في وسائل الإنتاج الفكري ولذلك، فإن الأفكار السائدة في مجتمع ما، هي أفكار طبقته الحاكمة. انتهى ألتوسير من هذا إلى أن الإيديولوجيا تمثل ما يتخيله الأفراد من علاقات بشأن حالات وجودهم الواقعي.
يختلف “بورديو” هنا حتماً مع النظرية الألتوسيرية، فبالنسبة له، الدساتير والقوانين تطاع بسبب من العادات والتقاليد أكثر من سبب الفهم الخاطئ لطبيعتها التعسفية. فمن وجهة نظر بورديو، القانون والدولة لا يعتمدان بدرجة كبيرة على التحريف القصديّ وإنما على التصرفات الانصياعية. وهذا اختلاف مركزي بين مفهوم الإيديولوجيا وبين الممارسات التنظيمية. الإيديولوجيا تخص الفكر والوعي، بينما مفهوم القوة الرمزية لبورديو يعمل من خلال ردود أفعال لاواعية متجسدة.
رغم أن ألتوسير افترض بالفعل أن الإيديولوجيا لها وجود ماديّ ولها نمط لماديتها، وأن الإيديولوجيا اشتقت ماديتها من تحققها بداخل كل فرد، وعلاوة على ذلك تكوين هذا الفرد عن طريق الإيديولوجيا المنتقلة إليه عن طريق الأجهزة الإيديولوجيا للدولة (الأسر، المؤسسات التعليمية، إلى آخره..)، إلا أنه لم يزل معتنياً فقط بالوعي وبعده التخيليّ حتى المتموضع بداخل الفرد الواحد. لم يلق ألتوسير بالاً للجسد وردود أفعاله، حيث يبدو توكيده على مادية الإيديولوجيا حافزه هو الدفاع عن المادية الميتافيزيقية بدرجة أكبر من مدى الانطباع الذهني لها. يقدم بورديو نظرية تتعارض مع ما يسميه عقلانية التقليد الكانطي في لفت الانتباه إلى ردود الفعل الجسدية الأوتوماتيكية اللاواعية ضمن آليات القوة الرمزية. (الإيديولوجيا والقوة الرمزية: بين ألتوسير وبورديو- ماثيو تول/ترجمة: محمود سامي، مجلة حكمة، (hekmah.org
يرفض ألتوسير تعريف الإيديولوجيا لدى ماركس، كما يرفض القول بتبعية الإيديولوجيا المطلقة إلى البنية التحتية، وبناء على هذا يرفض أيضا نمط العلاقة الأحادية بين العوامل المختلفة لصالح نمط متعدد من العلائق المحتملة، وهو ما سمح له بإعادة النظر في مفهوم الإيديولوجيا، وفي تأثيرها على الأفراد وفي تشكيل ذواتهم وهوياتهم ووعيهم. فبعد أن كانت الإيديولوجية عبارة عن “وعي زائف”، أصبح للإيديولوجيا وجود مادي يظهر في الممارسات المادية التي تتحدد بأجهزة الدولة الإيديولوجية تظهر، بصورة جلية، في تأثيرها على الأفراد، وفي تشكيل وعيهم وهوياتهم الثقافية. فالإيديولوجيا، في تعريف ألتوسير، هي أقرب إلى مفهوم الثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي، حيث الإنسان يوجد على سجيته وطبيعته ومن ثم يتم تحويله إلى كائن ثقافي من خلال جملة من الأعراف والممارسات والاستراتيجيات. وبناء على هذا التصور يقول ألتوسير: “إن الإنسان حيوان إيديولوجي بالطبع”.
وهو ما حمل ألتوسير على القول بأن الأفراد هم بالضرورة ذوات مقصودين بإيديولوجيا، فالفرد يولد في مجتمع له مؤسساته وممارساته وطقوسه القائمة قبل وجود الفرد، أي له إيديولوجيته التي تحيط بالفرد قبل ولادته وبعدها. لكن ما إن يولد المرء، فإن كل الاحتمالات تنتهي لصالح احتمال واحد لا غير. حين يولد المرء، يدمج في هويته الثقافية وتشتغل عليه فور ولادته آليات التشكيل الإيديولوجي، التي تبدأ بالأسرة والمجتمع والمدرسة والمعاهد والجامعات ووسائل الإعلام الجماهيرية ومؤسسات الثقافة. سواء تعلق الأمر بالإيديولوجيات الاجتماعية، أو بالإيديولوجيات السياسية أو حتى بالإيديولوجيات الثقافية، فإن أمر إنتاج الإيديولوجيات وتوزيعها على الأفراد ليس مسألة اعتباطية، ومتروكة للصدفة، بل إن المجتمع ينظم عملية إنتاج وتوزيع الإيديولوجيا الرئيسية أو الإيديولوجيات الفرعية عبر قنوات ومؤسسات. إذا كان البعض يتحدث عن بنية إيديولوجية أو قطاع إيديولوجي أو مجال إيديولوجي، فإن هذه الكيانات خاضعة لتنظيم اجتماعي محكم ولتأطير اجتماعي.
وإذا كانت هناك إيديولوجيا تلقائية، فإنما هي الإيديولوجيا التي ينتجها المجتمع تلقائياً عبر مؤسساته الإيديولوجية. ويستعمل “محمد سبيلا” مصطلح مؤسسات إيديولوجية بدل أجهزة إيديولوجية لأن الأولى تعني كل المؤسسات الاجتماعية المشتغلة بالإيديولوجيا في حين تعني الأجهزة الإيديولوجية، الأدوات التي تتملكها طبقة معينة لإحكام سلطتها وإقرار سيطرتها. فالمدلول الأول مدلول سوسيولوجي في حين أن المدلول الثاني مدلول سياسي ومرتبط بالوظيفة السلطوية للإيديولوجيا، لذلك هناك من يتحدث عن أجهزة إيديولوجية للدولة وهذا أمر يرتبط بوجهة النظر الماركسية حول الدولة، وهناك من يتحدث عن مؤسسات إيديولوجية يوكل إليها المجتمع أو الطبقة أو الحزب أو الدولة أمر إنتاج أو إعادة إنتاج وتوزيع الإيديولوجيا.
إذا كانت الإيديولوجيا هي مجموعة التمثلات الاجتماعية والقيم والتوجيهات التي يكونها المجتمع أو النظام عن ذاته بهدف تأطير الأفراد وضبطهم اجتماعياً وجعلهم يتصرفون ويسلكون في تلاؤم معه ومع أهدافه، فإن مهمة المؤسسات الإيديولوجية هي إنجاز هذه الأهداف ووضعها موضع التطبيق. فالحديث عن المؤسسات الإيديولوجية هو الحديث عن كيفية إنتاج الإيديولوجيات، وعمّن ينتجها، وعمّن يستغلها ويستهلكها ويروّجها، وما هي القنوات التي تمر عبرها الدورة الإيديولوجية.
فالجديد في البحث حول الايدولوجيا هو اكتشاف قوامها المادي والمؤسسي، بمعنى أنها ليست فقط مجموعة أفكار أو قيم أو تمثلات أو رموز، بل إن كل هذه الأشكال التعبيرية تتشخص في مؤسسات تتولاها بالإعداد والتعهد وتتولى أمر تشذيبها وتوزيعها على نظام اجتماعي واسع. وهكذا نجد ألتوسير، انطلاقاً من هذه النظرة يقدم لائحة يعتبرها تجريبية وغير وافية، للأجهزة الإيديولوجية للدولة وتضم الجهاز الإيديولوجي الديني، والجهاز المدرسي والجهاز العائلي والجهاز القانوني والجهاز السياسي والجهاز النقابي والجهاز الاعلامي والجهاز الثقافي.
وقد أطلق “محمد سبيلا” اسم المؤسسات على هذه الأجهزة. فمعظمها ذات وظيفة مزدوجة اجتماعية وسياسية، وبالتالي يمكننا أن نقوم بالتمييز بين المؤسسات ذات الوظيفة الاجتماعية المهيمنة والمؤسسات ذات الوظيفة السياسية المهيمنة كالمؤسسات السياسية، والمؤسسات المزدوجة الوظيفة. بل يمكن أن نتحدث عن تكييف كل المؤسسات تكييفاً سياسياً في اتجاه خدمة وترسيخ أسس النظام السياسي الذي تشتغل في إطاره، وذلك بتسخير المكونات الأساسية للمجتمع في اتجاه دعم النظام السياسي.
خاتمة
إذا كان ماركس يرى أن الإيديولوجيا ذات طبيعة وهمية وضبابية وتزييفية، فإن ألتوسير ينظر إليها بوصفها وظائف عملية مجسدة عبر أجهزة الدولة الإيديولوجية ليس من السهل الاستغناء عنها. وهكذا نستطيع فهم معنى التحول المادي للإيديولوجيا حيث تثبت هذه النظرية أن هناك طرقا أخرى جديدة لممارسة الإيديولوجيا غير الطرق الخطابية أو الفكرية. فليس شرطا في الإيديولوجيا أن تقتصر على مجال الأفكار والمعتقدات، بل إن مؤسسة أو جهازا معينا يمكن أن يقوم بدور إيديولوجي مثل الكنيسة والمدرسة والإعلام. فانطلاقا من مقاربة مختلفة لعلاقة البنية التحتية بالبنية الفوقية، يكون ألتوسير قد تجاوز الطرح التقليدي القائل بالعلاقة الحتمية بين البنيتين.
المراجع:
- لوي ألتوسير، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
- الإيديولوجيا والقوة الرمزية: بين ألتوسير وبورديو – ماثيو تول/ ترجمة: محمود سامي، مجلة حكمة (hekmah.org)
- Louis Althusser : Positions, Ed. Sociales Paris, pp. 159-172 ترجمة : د. محمد سبيلا
- الإيديولوجيا كأساس للمشروعية السياسية: د. محمد سبيلا المصدر: الإيديولوجيا نحو نظرة تكاملية المركز الثقافي العربي / بيروت ايلول / سبتمبر 1992 نقلاً عن “الحضارية”
- الفلسفة وإيديولوجيا الإعلام، إسهام الفكر المعاصر في دراسة وسائل الإعلام، أشرف حسن منصور الحوار المتمدن-العدد: 3016 – 2010 / 5 / 27 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=217018
- مفهوم الدولة: طبيعة السلطة السياسية، عبد الجبار الغراز. maktoobblog.com
طبيعة السلطة السياسية، ذ محراش،http://cdhsos.yoo7.com/t99





