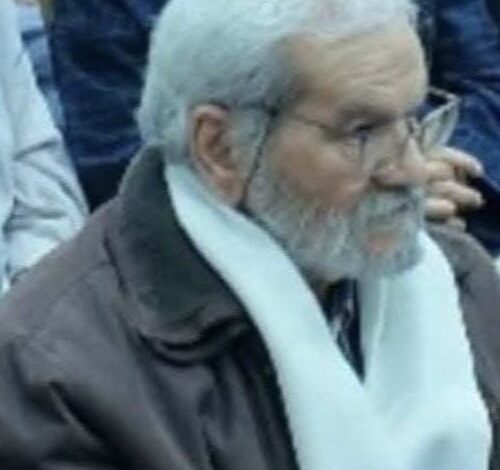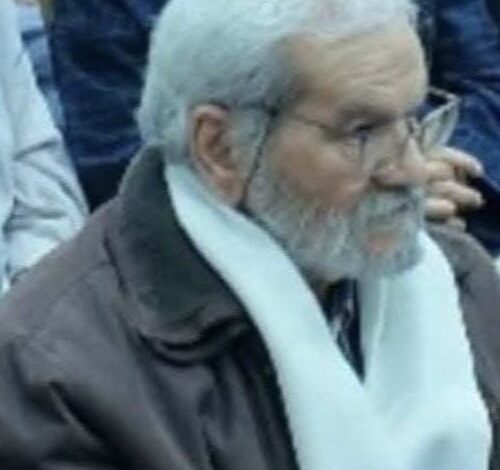الكاتب المغربي أحمد قابيل
خصص المجلس الاعلى للتربية والتكوين في تقريره الأخير حيزا مهما للهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة لدى الاطفال الذين حالفهم الحظ ودخلوا المدرسة. حجم هذا الهدر كبير ويعد بمئات الآلاف من التلاميذ الذي يغادرون المدرسة كل سنة بصفة نهائية دون أن يحصلوا على أية شهادة تكفل لهم الاندماج في الحياة العملية للمجتمع، ودون أن تفلح مراكز التكوين المهني الموجودة في استيعابهم. والنتيجة هي أن الآلاف من الاطفال واليافعين يخرجون إلى معركة الحياة دون سلاح، سلاح الشهادة والمعرفة، ويضيع المجتمع برمته لأنه لم يستفد من هذه الطاقات الشابة، ويضيع المجتمع أيضا لأنه ينفق الملايير من الدراهم سنويا على ميدان التربية والتعليم دون طائل.
أسباب هذا الهدر كثيرة ومتشعبة وكانت موضوع العديد من الدراسات الرسمية وغير الرسمية. لكن سأتحدث اليوم عن هدر من نوع آخر هو الهدر اللغوي، ويخص هذا العدد القليل من التلاميذ ممن أفلت وبقي على مقاعد الدراسة حتى حصل على شهادة الباكالوريا ثم انتقل إلى التعليم الجامعي.
نحن نعرف أن التلميذ المغربي في المدارس العمومية يبدأ في دراسة لغة أجنبية أولى (الفرنسية) بدء من السنة الثانية من التعليم الابتدائي ثم يبدأ بعد ذلك دراسة لغة أجنبية ثانية (انجليزية، أسبانية، ألمانية، إلخ..) بداية من السنة الثالثة من التعليم الاعدادي، وتنفق الدولة من أجل ذلك الكثير من الجهود في تكوين أساتذة هذه اللغات الأجنبية والكثير من الأموال على هذا التكوين ثم على أجور الاساتذة بعد التوظيف، الخ… ونحن نعرف أن الغرض من تعلم اللغات هو الانفتاح على الثقافات الأخرى والتواصل مع الشعوب الاخرى، والاستفادة من المعارف والعلوم المكتوبة بلغات اجنبية سواء في مرحلة الدراسة أو في البحث العلمي.. غير أن الكثير من ذلك لايحصل للأسف في تعليمنا الجامعي، فبمجرد أن يدخل الطالب أبواب الكلية أو المعهد الجامعي أو أية مدرسة عليا سواء كانت في الدراسات الإنسانية او العلمية، يتم تجاهل كل ما سبق أن تعلمه من لغات أجنبية بل وإهمال حتى لغته الوطنية التي درس بها كل مراحل تعليمه السابقة.
وحينما نطلع على مقررات كلياتنا نفاجأ بغياب اية حصص للغات الأجنبية التي سبق للطالب أن تلقن مبادءها، مع أن المفروض أن يستمر في دراستها حتى يتقنها جيدا ويستفيد من المراجع الاجنبية المكتوبة بلغات اخرى (انجليزية، إسبانية، ألمانية، إلخ..) يحصل هذا في العديد من مؤسساتنا الجامعية، إلا من رحم ربك، وهم قليل.
ويحصل هذا حتى بالنسبة للغة الوطنية إذ يتم تجاهلها في كلياتنا (الطب الهندسة، إلخ..) ومعاهدنا الجامعية طوال مسار الدراسة التي قد تستغرق سبع سنوات يتخرج الطالب بعدها وقد نسي الكثير من معالم لغته الوطنية بحكم عدم الاستعمال، وهو ما نلاحظه جيدا حين يضطر طبيب أو مهندس مغربي للحديث باللغة العربية ويجد صعوبة كبرى في النطق أو التهجي أو العثور على الكلمات المناسبة.. مقارنة مع المهندس أو الطبيب من بلد عربي آخر.
فعلى من نلقي المسؤولية في هذا الهدر اللغوي؟ على عمداء الكليات والمعاهد أم على رؤساء الجامعات أم على وزارة التعليم العالي أم على غياب التنسيق بين وزارتين يفترض أن يكون التنسيق بينهما: وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي وأن تكمل إحداهما عمل الأخرى؟