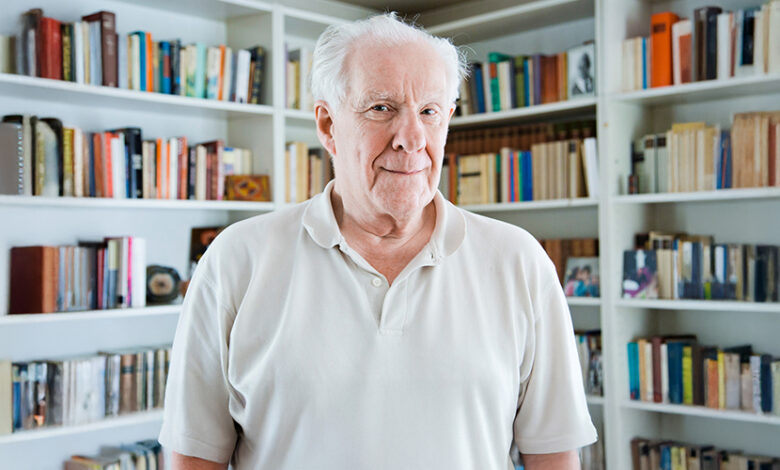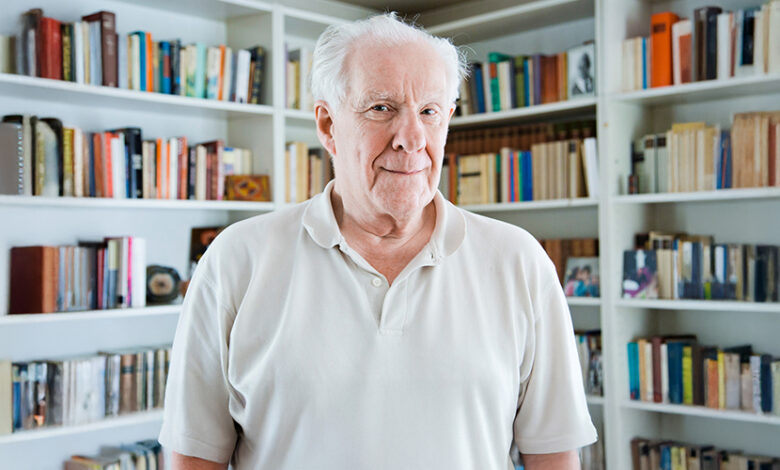أحمد رباص
يقول آلان باديو عن كتيبه “الموجز الصغير للاإستطيقا” إن الديداكتيكية، والرومانسية، والكلاسيكية هي الأنماط المحتملة للعقدة بين الفن والفلسفة، والطرف الثالث لهذه العقدة هو تربية الذوات، وخاصة الشباب. ما يميز قرننا الأخير، في رأيي، هو أنه رغم تشبعه بهذه الأنماط الثلاثة، إلا أنه لم يُنتج أي نمط جديد. وهذا يُفضي اليوم إلى نوع من فك الارتباط بين هذه الأطراف، وانفصالٍ مُحبط بين الفن والفلسفة، وانهيارٍ تامٍّ لما كان متداولًا بينهما: الموضوع التربوي. من هنا تنبع الأطروحة التي مفادها أن هذا الكتاب الصغير لا يعدو أن يكون مجرد سلسلة من الاختلافات: وفي ضوء هذا الوضع من التشبع والانغلاق، يتعين علينا أن نحاول اقتراح نمط جديد، وهو نمط رابع من الاتصال بين الفلسفة والفن”.
من أجل تلقي التفاصيل الممتعة لما ورد ملخصا في هذا التقديم الجميل “للموجز الصغير..”، تعالوا معي، قرائي الأعزاء، نتابع ما كتبه عنه لوك باشلو:
إلى جانب شكلنة ودقة العمليات الوصفية، التي ساهمت البنيوية بشكل كبير في اعتمادها في جميع العلوم الاجتماعية، فرضت، طوعا أو كرها، نموذجا نظريا قائما على فرضية سوسير القائلة بأن اللغة هي نموذج جميع أشكال التعبير. لذا، فإنها تضع التأمل في الصورة مباشرةً ضمن إشكالية عامة تتجاوز بكثير مجرد ملاحظة البيانات والأعمال الأيقونية، مع خطر طمس خصوصيتها. فالصور، في الواقع، تُنسب إلى نظام خارجي عنها، هو اللغة، ولا تُفهم إلا من خلالها. وقد طورت جميع الدراسات التي تدّعي استنادها إلى السيميولوجيا والبنيوية هذا المفهوم، وقد كثرت منذ نشر كتاب رولان بارت “سيميولوجيا الصورة” (1964).
أحيى هذا الخيار بانتظام متخصصو الصور من جميع الأطياف (وينتر في مجالنا). مهما كانت خصوبتها المُثبتة، لم تنجح هذه النظرية قط في كبح جماح سيل التساؤلات الذي يُثيره ظهور الصور في سياقات مُحددة. يبدو أن تنوعها وأصالتها وطبيعتها غير المتوقعة في كثير من الأحيان ووظائفها المُتعددة، بالنسبة لمعظم المهتمين بالصور، يتجاوز إلى حد كبير الحدود التي يفرضها النموذج اللغوي. ومع ذلك، كان لهذا الأمر فضل إبعاد خطاب الصورة عن إمبراطورية المقولات الفلسفية (إشكالية العلاقة بين الحقيقة والفن) التي كان غالبا فيها. بين المقولات الفلسفية، الواسعة جدا التي لا تُدرك خصوصية إيقونوغرافيا، والنموذج اللغوي الضيق جدا الذي يسمح بما يبدو أساسيا بالهروب، ما هو المسار الجديد الذي يُمكن أن ينفتح؟
الطريق الرابع لآلان باديو
يطرح آلان باديو (1998) فكرةً في الفصل الأول من كتابه “الموجز الصغير للاإستطيقا”، وفي ما كتبته عن هذا النص، هناك إشاراتٍ إلى نظرياتٍ أخرى، أو مُكمِّلاتٍ، أو مُضاداتٍ لمقترحات باديو، وأمثلةٍ على ممارساتٍ أيقونيةٍ خاصةٍ ببلاد الرافدين. فيما يلي افتتاحية هذا النص:
“أعني بـ”اللاإستطيقا” علاقةً بين الفلسفة والفن، لا تدعي بأي حال، على افتراض أن الفن في حد ذاته مُنتجٌ للحقائق، جعله موضوعا للفلسفة.
على عكس التأمل الإستيطيقي، تصف اللاإستطيقا الآثارَ الفلسفية الداخلية البحتة الناتجة عن الوجود المُستقل لبعض الأعمال الفنية.” (باديو 1998).
لذا، يُعد الفن مُنتجًا للحقائق، وهو، على الأقل، مُساوٍ للفلسفة. يُنتج الفن آثارًا فلسفيةً داخليةً بمجرد وجود بعض أعماله. العلاقة بين الفن والفلسفة، بحسب المؤلف، تتسم إما بالنبذ أو بالولاء. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن الفن (وخاصة الصور) والفلسفة مرتبطان تاريخيا، منذ نشأة الفلسفة الغربية في اليونان. ويمكن تصور هذه الصلة بثلاث طرق: تربوية، ورومانسية، وكلاسيكية.
النمط التربوي
يُسند التمط التربوي للصورة دور التعليم. يجب أن تنقل الصورة حقيقةً مُكتسبة خارجيا. ويتحقق هذا النقل من خلال قوة التشابه الانتقالية، كما يُمكن للاستعارة، مثلا، أن تُساعد على فهم فكرة ما. ولكن يجب ألا تتجاوز وظيفتها هذا المستوى.
يجب أن يكون معيار الصورة هو التربية، لكن معيار التربية هو الفلسفة. وبالتالي، تكون الصورة تحت السيطرة لأن حقيقتها تأتي من الخارج، ولا يُمكن قياسها إلا من خلال تأثيرها على الجمهور.
النمط الرومانسي
يرى النمط الرومانسي في الصورة المظهر الوحيد القادر على إظهار الحقيقة. وهكذا، يُنجز ما لا تستطيع الفلسفة إلا الإشارة إليه. الصورة هي الجسد الحقيقي للحقيقة؛ وهي تُقابل استعارة معروفة في مجتمعاتنا (المسيحية) ، وهي استعارة المسيح. المسيح هو الصورة الحية، تجسد الله الآب على الأرض.
النمط الكلاسيكي
وأخيرا، خفف النمط الكلاسيكي من حدة التوتر بين النمطين السابقين: الحظر الديداكتيكي، الوظيفة الأداتية البحتة للصورة في خدمة التربية، والفلسفة بالتالي، والتمجيد الرومانسي. كان أرسطو هو صاحب هذا الاختزال. الصورة في حد ذاتها عاجزة عن قول الحقيقة، لكن هذه ليست مشكلة، لأن ذلك في النهاية ليس من وظيفتها. يتعلق الأمر بشيء آخر: التطهير، الذي يُمكن تعريفه بأنه تفريغ المشاعر في صورة انتقال إلى الشبيه.
لذلك، فإن معيار الصورة هو فائدتها في علاج آلام الروح. يترتب على ذلك أن دور الصورة سيكون، بلا شك، الإرضاء، وليس إنتاج الحقيقة. فالإرضاء لا يأخذ من الحقيقة إلا ما يُمكّن من إطلاق عملية التماهي، أي شظايا الحقيقة. الحقيقة، في الواقع، كيانٌ مُجرّد من كل حقيقة، لكن بعض جوانبها قد تجد موضع تطبيق في المخيال؛ موضع تطبيق عواطف أشكال الانتقال. وهذا ما يُسمى بالواقعية. ينبع السلام بين الصورة والفلسفة من الحد الفاصل بين الحقيقة والواقعية. فإلى جانب الصورة، تحتفظ الفلسفة بحقها في الحقيقة.
حالة بلاد الرافدين
لدعم هذه الأطروحة، يمكننا الاستشهاد بحالة بلاد الرافدين. بعد أن اضطررتُ إلى تناول وظيفة الصور في سياق بلاد الرافدين، وبعد دراسة العينات التي كانت بحوزتي بدقة بالغة، توصلتُ إلى استنتاج قريب من الوظيفة التطهيرية التي شرحها أرسطو، ولكن بطرقٍ ومساراتٍ تجاهلت عمدا النظريات الجمالية الكلاسيكية الكبرى. كان الأمر يتعلق بعينات من صور بلاد الرافدين تحمل الأختام الدائرية لنهاية العصر النحاسي، في وقت ظهور ما يُسمى بمجتمعات ما قبل الدولة.
في هذا السياق، تُعتبر الصور دائما إحدى نتائج حركة هيكلة اجتماعية واسعة. لكن دراسة متأنية لصور هذه الفترة واستخداماتها قادتني إلى افتراض أنها لم تكن نتيجةً بسيطةً لهذه الحركة فحسب، بل كانت بلا شك أصل هذه الحركة الهيكلية الاجتماعية. وأنها بدت، من خلال أدائها – أي من خلال طريقة استقبالها – وكأنها أصل ما يُسمى بالدولة أو ما قبل الدولة. كيف؟ لأنها تُشرك المُستقبِل في عملية إسقاط تُطلق التوترات الحتمية في أوقات الأزمات التي تُميز الهيكلة الاجتماعية. كيف تُطلق هذه التوترات؟ من خلال تنوع ما تكشفه، هل طلب إكمال رسالة تُعتبر ناقصة، أم إسقاط، أم تطهير؟ يُمكننا مُقارنة هذا الوضع بممارسة الاختبارات الإسقاطية، المُستخدمة كعلاج، والتي يقول بعض علماء النفس إنها تُعادل التحليل النفسي الحقيقي.
عارضت هذه الأطروحة الفكرة الأكثر شيوعا، وهي أن الوظيفة الأساسية للصور مطابقة لوظيفة اللغات الطبيعية، ألا وهي التواصل. وقد تعزز تأثير النموذج اللغوي أيضا بملاحظة نشأة الكتابة ثم توسعها في بلاد ما بين النهرين، والتي انتقلت، من طبيعية الصور التوضيحية إلى تجريد العلامات المسمارية، من التفسير المباشر للصورة إلى الفهم، رهنا بتعلم تدوين اعتباطي مُصمم لنسخ العبارات اللغوية.
لذلك، كان هناك ميل سريع جدا لمواءمة وظيفة الصورة مع وظيفة الكتابة، لسبب بسيط هو أن الأخيرة تنحدر من الأولى، وأن الكتابة تبدو بوضوح خاضعة للنموذج اللغوي. يمكن تصور ذلك في الكتابة الأبجدية الحالية، التي يجب أن تنقل عبارات لغوية، ولكن على مستوى تحليلي أساسي إلى حد ما، وهو أمر غير مقبول في مرحلة إعادة الكتابة الأيديوغرافية (الرمزية) في بلاد ما بين النهرين.
(يتبع)