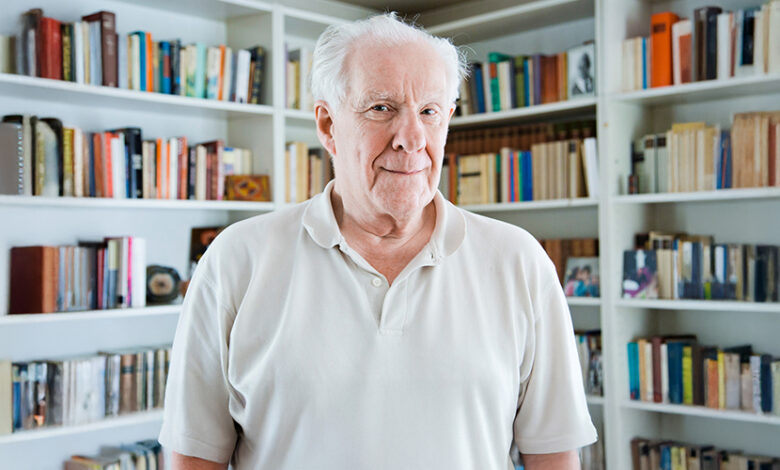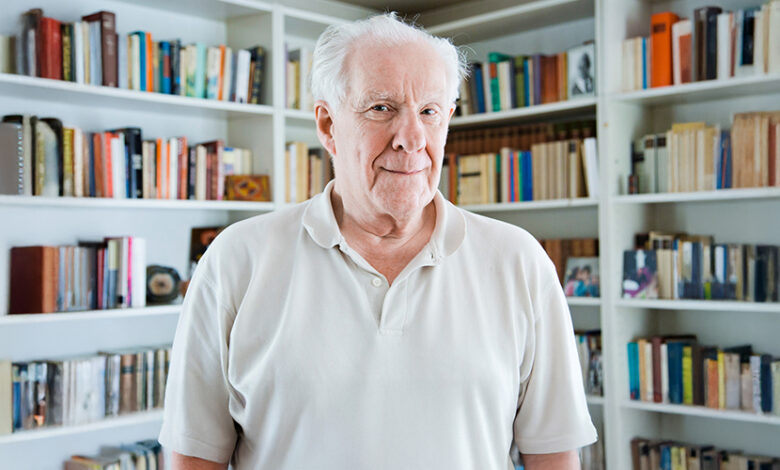أحمد رباص
يرى آلان باديو، في كتيبه “الموجز الصغير للاإستطيقا”، أن القرن العشرين لم يفعل شيئًا سوى العودة باستمرار إلى الانحصار ضمن هذه الطرق الرئيسية الثلاثة في تنظيم الإنتاج الفني والتفكير فيه. وقد استولى، شيئا فشيئا أو تلقائيا، على هذه الأنماط بشكل متكرر ومنهجي لدرجة أنها أصبحت الآن مشبعة. وبالتالي، فإن جميع التفسيرات المقدمة تُنتج في النهاية دمجا، ضمن نفس المقولات، لأعمال مختلفة اختلافا واضحا. وباختصار، نحن ندور في حلقة مفرغة.
ما هو الوضع حاليا؟
من بين الحركات الفلسفية الرئيسية التي طبعت هذا القرن (العشرين)، يمكن إدراج الماركسية، والتحليل النفسي، والهرمينوطيقا الألمانية (هايدغر وعشاق كتبه، بل كل التيار الوجودي والفينومينولوجي) ضمن التوجهات المذكورة آنفا.
الماركسية، بلا شك، نظرية ديداكتيكية. لا داعي لتقديم أمثلة عن ذلك. فالإنتاج الفني، مهما كانت التقنيات المستخدمة، يضطلع بمهمة أساسية تتمثل في نقل مجموعة من الأفكار والتصورات، مذهب أقيم، بطبيعة الحال، خارج نطاق ممارسة هذا التخصص الفني أو ذاك.
التحليل النفسي، كما رأينا، كلاسيكي، إذ يحتفظ بدور التنفيس عن الذات من خلال وظيفة الصورة، من خلال تطبيق الإسقاطات والتماهي، بل إنه بُني حول استخدام هذه المفاهيم. ومن الطبيعي أن نفكر في الطوبولوجيا الفرويدية مع مراحل تطور تكوين الأنا في الطفولة المبكرة والدور الذي تلعبه فيها الصورة، واستحضار أسطورة نرجس، ومرحلة المرآة، إلخ..
لهذا المفهوم الكلاسيكي الأرسطي فعالية واضحة على المستوى الفردي والاجتماعي، إذ أنه يعزز جميع عمليات البناء أو التماسك الاجتماعي. ويمكن لنا أن نجد أمثلة عديدة على هذا الأداء في الإنتاجات المعاصرة والقديمة على حد سواء. وأخيرا، الهرمينوطيقا (هايدغر)، التي هي رومانسية في جوهرها لأن أقوال الشاعر والفنان والفكر الخالص للمفكر، في نهاية المطاف، لا يمكن التمييز بينها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة لا تذكر البنيوية. على أي حال، فإن هذه الأخيرة، وكذلك الحركة السيميولوجية بأكملها، تحتوي بوضوح على جرعة كبيرة من الديداكتيكية، بقدر ما يشارك إنتاج الصور في إظهار بنيات تطورت خارج الممارسة الأيقونية وتشير إلى بنية شاملة للأداء الاجتماعي. سيكون هناك نحو حقيقي للأساليب والقواعد التي ترتبط ارتباطا وثيقا بقواعد أخرى تحكم أداء المجتمع. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ارتباط هذه القواعد الاجتماعية المتعددة في ما بينها يستجيب لآلية لا تخضع لأي تحديد دقيق؛ لأنها تتجلى في البنية التي تتولد بشكل شبه تلقائي، في جميع قطاعات الحياة الاجتماعية، ولكن بطرق مختلفة.
يتعلق الأمر ببنيات البنيات، التي تؤدي إلى البنية الكبرى التي هي، في نهاية المطاف، المجتمع. إذا كان من الممكن وصف وتحليل البنيات-العناصر محليا – الصورة، الموسيقى، قواعد الزواج، النظام الاقتصادي – فإن المحرك الذي يخلق البنية الكبرى يظل مظهرا عفويا يبدو أنه ينبع من نوع من الميتافيزيقيا، قريبا من النمط الكلاسيكي.
النمط الرابع
لفهم إنتاج الصورة الآن، وربما بشكل أدق، كان من المناسب للمؤلف أن يقترح نمطا رابعا، وأن يفكر فيه بعيدا عن الجاذبية الفلسفية، تماما كما سعت الهرمينوطيقا إلى التهرب من صرامة الأوصاف البنيوية والسيميولوجية الجافة نوعا ما (مؤخرا، يمكن لنا أن نستشهد أيضا بالميديولوجيا (علم الوسائط) عند ريجيس دوبريه، وهو عبارة عن سيميولوجيا تلتزم، بالفعل، التزاما صارما بالبرنامج البنيوي: الرسالة هي الواسطة).
لفصل الفكر عن الفن والفلسفة بنجاح، تفرض عملية أولى ذاتها: التخلص من إشكالية علاقة “صورة-حقيقة”. مقولات هذه العلاقة هي المحايثة (الحقيقة داخلية في العمل) والتفرد.
في النمط الرومانسي، تكون الصورة بمثابة تجلّ للمحايثة. يكشف الفن عن الانحدار النهائي للفكرة (بالمعنى الأفلاطوني). إنه تجسيد مثالي لهذه الفكرة. لا يسعنا إلا الرجوع إلى نصوص أفلاطون، بل إلى الجدل الدائر حول الصور في بيزنطة، بما في ذلك إشكالية الأيقونات، واستعارة المسيح، إلخ..
من ناحية أخرى، لا تستجيب الصورة، وفقا لهذا التصور، لمبدأ التفرد في ما يتعلق بالحقيقة، لأن هذه الحقيقة هي نفسها التي تطورت لدى المفكر؛ فهي ليست فردية بأي حال من الأحوال.
في الديداكتيكية، الحقيقة ليست كامنة في الصورة، لأنها تأتي إليها من الخارج. فالصورة في الواقع ليست سوى وعاء لهذه الحقيقة القادمة من مصادر أخرى: أفلاطون، البنيوية، الماركسية. لكنها فريدة لأنها وحدها القادرة على عرض حقيقة، ولو جزئيا، على شكل شبيه. ولأن الحقيقة غالبا ما تكون بعيدة المنال عن عامة الناس، من خلال تشبيههم واستعارتهم، فإنها قادرة على نقل شيء من هذه الحقيقة التي كانت ستظل مخفيا لولاها (الصورة).
يجب علينا الآن تجاوز إشكالية الحقيقة هذه والاعتراف في إنتاج الصور بتزامن المقولتين اللتين تحددان ظهور الحقيقة: المحايثة والتفرد. طالما كانت إحدى هاتين الخاصيتين مفقودة، كانت الصورة تفتقر إلى الحقيقة، وبالتالي لا يمكن أن تخضع إلا لهذا النموذج.
ولكن إذا توصلنا إلى إدراك أن المحايثة والتفرد يتجليان بالتساوي وفي وقت واحد في الصورة، كما هو الحال في جميع الإنتاج الفني، فنحن الآن أمام تجل للحقيقة، لحقيقة الفن. وبالتالي، ستكون الصورة إجراءً للحقيقة في حد ذاتها، وفكرا لا يمكن اختزاله في حقائق أخرى، ولا سيما الحقائق السياسية والفلسفية.
وهنا يبرز السؤال: إذا كان الفن هو الإنتاج الأصيل للحقيقة، فما هي الوحدة ذات الصلة بهذا الإنتاج؟ هذه هي إشكالية المحدود واللانهائي.
(يتبع)