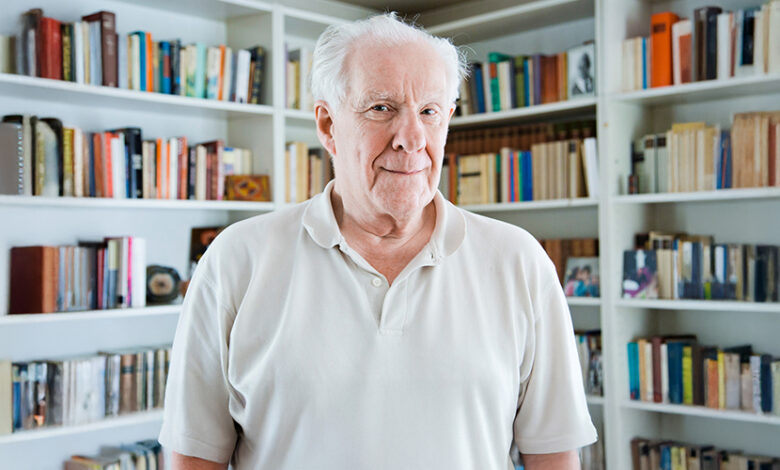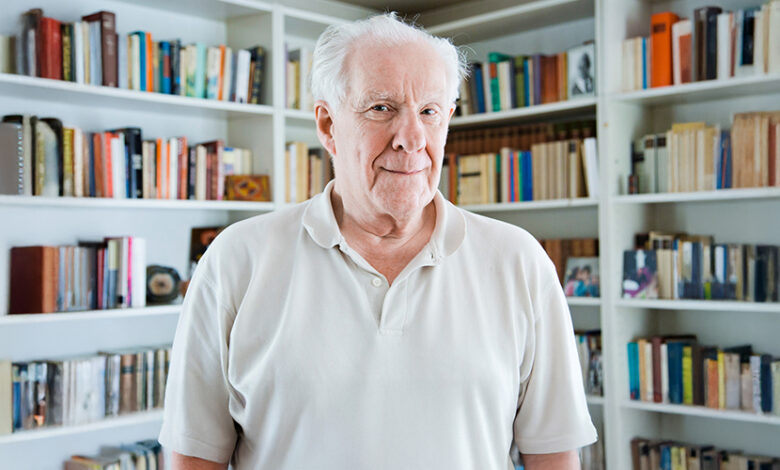أحمد رباص
بغض النظر عما تمت برمجته قبل قليل، يعتبر العمل الفني في جوهره شيء مكتملا، جزئيا، ومحدودا بدقة. وهذا لا يتوافق مع تعريف الحقيقة، سواءً كانت شاملة أو عامة أو كونية. لذا، فالصورة ليست حقيقة، بل هي مجرد حقيقة أيقونية، حقيقة فنية؛ أي عنصر من عناصر العملية المنسوجة، من شبكة من الحقائق الفنية والصور المتعددة. حقيقة الفن عملية مكونة من أعمال، لكنها لا يمكن أن تتجلى بشكل متكامل في أي منها. لذلك، يجب اعتبار الصورة مثالاً محلياً للحقيقة. هذه المثال المحلي، الذي يُنتج شظية من الحقيقة، يُطلق عليه باديو اسم “ذات” الحقيقة.
الأسلاف
بالنسبة إلينا، نحن الذين نواجه الحاجة إلى الإلمام بعينة من الصور، يترتب على ذلك أن الوحدة المعنية ليست الصورة المعزولة، مهما كانت صفاتها التقنية والجمالية، بل تكوين فني، مجموعة من الأعمال، من الصور. يجب أن يكون هذا التكوين تسلسلاً قابلاً للتحديد ولكنه يكاد يكون لانهائياً للأعمال التي تُكوّنه.
يمكننا أن نلمس شجاعة الفيلسوف في اتخاذ موقف يُغرق الفلسفة في أزمة، لدرجة أنه يُقصي جزءً هاما من برنامجها، بل جزءً جوهريًا: التفكير في العالم بكليته، بما في ذلك الإنتاجات البشرية والفنون والصور. ومع ذلك، يصعب فهم ما يُميز المسار الذي يُسميه “رومانسيا”، والذي يُصنف تحته تأويلات هايدغر، عن المسار الذي يقترحه.
ففي الإطار الرومانسي، يغيب التفرد في العمل الفني في علاقته بالحقيقة، لأن حقيقة العمل الفني ليست خاصة به، بل هي مطابقة لحقيقة المفكر، حقيقة متقاسمة، مشتركة، وبالتالي غير متفردة. وهذا بلا شك هو الحال عندما ننظر إلى الفن في شكل قصيدة فقط. ويُنظر إلى الشاعر هنا على أنه قادر على تمثيل جميع الفنانين.
ألا نرى، مرة أخرى، وبشكلٍ خفي، ظهور الدور المهيمن الممنوح للغة على جميع الإنتاجات الفنية؟ بنيويةٌ لا تُعلن عن نفسها كذلك. في الواقع، من الأصعب بالتأكيد التمييز بين “قول” الشاعر وقول المفكر، ولكن ربما ليس بين قول المفكر وقول صانع الصورة.
ضمن ما يتضح من تعريفه للهرمينوطيقا، تمنح الفيتومينولوجيا العملَ الفني، بحق، خصوصيةً لا تُضاهى وعلاقةً بالحقيقة، لا تختلف عن المسار الذي تُشير إليه لإنقاذ الإنتاج الفني من أي تأثير خارجي. يمكن لنا، بالطبع، الاستشهاد بالصيغ المتعددة التي تُزيّن نصوص ميرلوبونتي عندما يتحدث عن عمل الرسام. استحضار “الفكر في الصور”، و”الرسام الذي يُفكّر بيديه”، إلخ..
الفينومينولوجيا، التي كانت في أصل العديد من التحليلات الأيقونية، مثل تلك التي قدمها ميرلوبونتي، مثلل (“العين والروح”، “شك سيزان”، والنصوص التي جُمعت في “المرئي واللامرئي”، وحتى تلك التي قدمها هايدغر عن لوحة فان غوخ، “الحذاء”، في “الطرق التي لا تؤدي إلى أي مكان”، التي تناولها جاك دريدا، في “الحقيقة في الرسم”، إلخ..)، أثبتت الفينومينولوجيا أنه لا توجد بيانات مادية خالصة، خارج الفكر، ولكن هناك ارتباطا ثابتا بين أفعال الوعي (مثلا، الرؤية، الإدراك، التعرف) والأشياء التي تتعلق بها. يُطلق على هذا الارتباط اسم نويز (فعل الفكر)، ويُطلق على الشيء، كما يظهر في هذه الأفعال (بعد ترشيحه إذن بواسطة الوعي)، اسم نويم (فكرة). وبالتالي، فهو ليس شيئا خالصا في حد ذاته، ولكنه موجود في وظيفة إعطاء المعنى لأفعال الوعي.
تحديدٌ صاغه هوسرل (في “فينومينولوجيا الإدراك”)، ولكن يُمكن تحديد مقدماتٍ له، أو “تنبؤاتٍ” كما يُمكن تسميتها، في العصور القديمة. هذا هو حال طقس فتح الفم في بلاد ما بين النهرين، الذي يقوم، لإحياء الإله المُمَثَّل بتمثال، بإجراء سلسلة من التلاعبات مصحوبةً بالصلوات، وإلا فإن هذا التمثال لن يُمثِّل شيئا، ولن يكون حيا، ولن يؤدي أي وظيفة. من الواضح أن هذا التراجع المُحفوف بالمخاطر لا يُراعي الصفة التشكيلية المُكتملة للتمثال. فهذه الأخيرة، بالمعنى الدقيق للكلمة، لا توجد إلا بعد الطقس. لذا، فإن تدخل ما تُسميه الفينومينولوجيا “أفعال الوعي” حاسمٌ في هذه الحالة. لم تعد مُشكلة التفرد قائمة، لأن الحقيقة ليست شيئا آخر غير حقيقة الوعي غير المنفصلة عن الموضوع الذي وُلدت معه.