الموروث الشعبي بين سلطة الشفاهي والتدوين في رواية (ليلة مع رباب) للكاتبة المغربية فاتحة مرشيد

بقلم الأستاذ وليد جاسم الزبيدي-جامعة المستقبل/ العراق.
المقدمة:
سَخّرتِ الأديبةُ المغربية (فاتحة مُرشيد) أدواتِها وموهبتَها وخيالَها لتكون للرواية المغربية مكانتها في الساحة الروائية العالمية، من خلال ما قدمتهُ وتقدمهُ من نتاجٍ أدبي، ونحنُ هنا بصدد السرد، بدءاً من (لحظات لا غير/ 2007م)، (مخالب المُتعة وجيوش البطالة/ 2009م)، (المُلهمات/ 2011م)، (الحق في الرحيل/ 2013م)، (التوأم/ 2016م)، (لأن الحب لا يكفي/ 2017م)، (انعتاق الرغبة/ 2019م)، والرواية التي بين أيدينا الآن (ليلة مع رباب/ 2025).
الرواية بشكلٍ عام لم تكن قبل عقود إلا جنساً أدبياً يحتل المراتب الأخيرة في أدبنا العربي خاصة، وفي الأدب العالمي عامة، لطغيان الشعر الذي تسيّد الساحة الأدبية قروناً طويلة. وبعد التغيرات السياسية وما طرأ من تطورات في التقنيات، وحاجة المشهد الثقافي إلى السرد الذي يحتوي ما آلت إليه الصور الجديدة وعجز الشعر عن جمعها في نص واحد أو ديوان، أخذت الرواية على عاتقها أن تكون الجامعة الثقافية لجميع الأجناس الأدبية والفنية، وتحمل راية التهجين الأجناسي. فضلاً عن اعتمادها في منظمات ومؤسسات ثقافية عالمية مرموقة ووضع الجوائز الكبرى لها، مما شجع على الكتابة والإبداع فيها، حتى تحوّلت جيوش من الشعر والشعراء إلى معسكر الرواية ،حيثُ أوضحت صوت الهم والصرخة، والسؤال الذي تضعه أمام الجميع للبحث عن الجواب، وأحيانا النافذة المشرعة نحو غدٍ يحاكي الأحلام.
الموروث الشعبي في الأدب
لكل أمّةٍ وشعبٍ تراثٌ يحمل ثقافة الجماعة والمكان، مهما كانت تلك الأمة أو القبيلة، متخلفة أو متطورة، قديمة عهدٍ، أم حديثة. وهذا الإرث يعتبر عند البعض مقدساً، كما هو في الكتب السماوية وما يحتويه من عادات وثقافات تحمل صفة التقديس، وتُعدّ عند البعض شعيرةً أو عُرفاً، لا مناص منه. وهذا الإرث، التراث، تتناقلُهُ الأجيال عهداً ووصيةً لأنه تميمتها للبقاء وهو تاريخها الذي يحكي عنها، كما هو حال قصيدة (عمرو بن كلثوم) التي ظلت (النشيد القبلي) لقبيلته، وكما هي حكايات (أبي زيد الهلالي)، والمقامات، وألف ليلة وليلة، وكليلة ودمنة، وفي تراثنا الكثير. وأضيفت بفعل تقادم الزمن وما تفعله التكنولوجيا وعوامل (الحضارة)، فنونٌ دخلت ضمن التراث، منها الأعمال اليدوية، وهندسة المباني، والأغاني، والملابس، والطعام، إلم .. حتى وُصمَ (التراث) بِسَمتِ (الهوية)، يمتد الى آلاف السنين.
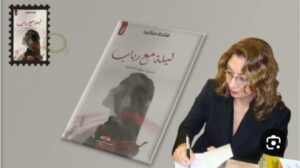
الموروث الشعبي في روايات (فاتحة)
منْ يقرأ روايات الأديبة (فاتحة مُرشيد) يجدها قد تبنّتْ وضع الموروث الشعبي المغربي في أعمدة بناء رواياتها، وأخذت على عاتقها نشر هذا التراث المحلي المتنوع كالفسيفساء بين يدي القارئ، حتى بدا أنهُ جزءٌ من منظومة الثقافة العالمية الزاخرة عطاءً وإنسانيةً. ففي رواية (لحظات لا غير) استخدمت أقنعةً عدّة، ومنها الأغاني التراثية والأسطورة، وفي رواية (مخالب المتعة)، استخدمت الأغاني العربية التراثية العربية والمغربية، والمثل الشعبي المغاربي، واللهجات المغربية الدارجة، والأكلات الشعبية، وحفلات الأعراس المغربية، ووظفتها ضمن سياق أحداث الرواية وتنقلاتها الدرامية. وفي رواية (الملهمات) أعطت صورة واضحة عن احتفالات المرأة الصحراوية بطلاقها، وجلسات الشعر الحساني. وفي رواية (الحق في الرحيل)، كان الموروث الشعبي حاضراً، والثقافة الأمازيغية، من خلال المأكولات، وألوان الطعام، والأغاني الشعبية المغربية. وفي رواية (التوأم) تعلن الميثولوجيا حضورها، من خلال المتاحف والمنحوتات، ورموز الآلهة الإغريقية. (كتاب مرايا وأقنعة في السرد سنة 2020م) .
وقد جعلت الأديبة (فاتحة مرشيد) من جغرافيا – المكان، خارطةً تتجول من خلالها في مدن وصحارى وريف المغرب، بل امتدت خارطتها لتشمل مدناً في مختلف أرجاء العالم، فكان المكان يتلوّن مع كل ثقافة، والثقافة تتلوّن بعطر المكان.
الموروث الشعبي في رواية (ليلة مع رباب)
إذا كانت روايات (فاتحة) السابقة قد ذكرت التراث بتنوعاته وألوانه، في باب أو وفق ما تقتضيه صورة حدث، أو ترابطٍ موضوعي في سلسلة أحداث أو بنية شخصية بطل من أبطال رواياتها، فأنا أعتبرُ أن رواية(ليلة مع رباب) ابتدأت وانتهت وهي عبارة عن (معجم للتراث المغربي) المخصص للأمثال الشعبية التي توارثتها الأجيال، وتؤشر إلى أن الرافد الذي لم ولن ينضب لهذا التراث على لسان امرأة كبيرة السن حكيمة هي
(هشومة). وقد دوّنت الأديبة (فاتحة) بكل أمانة المثل المغربي في هذه الرواية وجمعتهُ في كتاب للأمثال والتراث المغربي تحت عنوان رئيس هو (ديوان أمّي هشومة) وفي عنوان فرعي (ليلة مع رباب). وحصرتُ عدد الأمثال الشعبية في الرواية/ الكتاب بـ(63) مثلاً شعبياً مغربياً. هو عبارة عن معجمٍ للأمثال يحمل حكمة وخبرة أجيال تمتدُ عقوداً ودهوراً، وهي وصفات دقيقة وحلول ونظرة حكيم لأمورٍ حياتية متنوعة. ولم يغب عن خلدها (الأديبة) وببداهتها وذكائها المعهودين، أن تشير إلى (القرآن الكريم) في موقع ومناسبة الآية مع الحدث وسير الكلام والحوار، فجعلت القرآن هو الإرث والهوية التي نعتمدها ونستلهم منه الحكمة والمثل والعلاج. وهنا نجحتِ الأديبةُ في جمع الشفاهي ليكون مدوّناً، ولتقرأه الأجيال الجديدة التي ربما لم يمر بها مثل واحد، أو أن هناك أسراً في المجتمع تُلقّنُ أولادها الأمثال الغربية وتناست إرثها الكبير العظيم.
الموروث والحداثة في الرواية لتُعدلَ الأديبةُ في مسار الرواية، لم تجعلها موروثاً شعبياً فقط، بل زاوجت بين الموروث والحداثي بأسلوب رشيق يجعل المتلقي مهما كانت هويته وجنسيته يسترسل ولا ينقطع في متابعة الرواية، نهضت في الرواية أقوال لعلماء وفلاسفة وأدباء وفنانين، جرت أقوالهم مجرى الحكمة والمثل ، وقد حصرتُ عدد المقولات في الكتاب/ الرواية بـ( 27) مقولة مبثوثة في مجمل الكتاب، بدء من أول صفحة في المطبوع مقولة (ميجنون ماكلولين) إلى (شورون، مايا أنجلو، جبرا إبراهيم جبرا، نجيب محفوظ، إليوت، همنغواي, إلخ..).
في هذه المعادلة الفكرية وهندسة الرواية لم تجعل (الأديبة) روايتها تقوم على عمودٍ واحدٍ بل أسندت وساندت العمود التراثي الشعبي بحداثة الحكمة وأقوال المعاصرين الذين أثبتوا ودعموا حكمة الأمس وليكن (كتاب المثل الشعبي في المغرب) مُترجماً عبر اللغات والثقافات العالمية المختلفة.
الموروث الاسمي ( اسم العلم/المكان/ المهنة)/ تُعلمنا الروايةُ/ الكتابُ درساً آخرَ، أن التراث ليس اللغة الدارجة (العاميّة)، ولا الملابس، الطعام، الحكمة، الموسيقى، الألوان، طريقة السير، طريقة نطق بعض الأحرف، الصوت، إلخ.. فمن موروثنا مثلاً (الأسماء) وما زالت هذه (الظاهرة) موجودة في المجتمعات خصوصاً الشرقية، أن يكون للإنسان ( أنثى/ ذكر) عدد من الأسماء أحياناً يفرضها المجتمع أو العائلة أو ظرف طارئ، كأن تخاف الأسرة على الولد (ذكر) فتسميه باسم بنت، أو بنت فتسميها باسم ذكر، وهكذا، أو لظروف اجتماعية أو سياسية تتغير الأسماء، وهنا تعطينا الرواية (ليلة مع رباب) مسميات لنفس الشخص مثلاً (عبد الحفيظ، سيف، المنحوس، الزلزال، الكارثة، الشيطان، غول النحس) ، أو (جودية، بنت السيكليس، رباب)، وهكذا..
عنوان الرواية/
استلت (فاتحة) العنوان، من ألـ (216) صفحة، وكعادتها من سطر من سطور الرواية، كما فعلت في عددٍ من رواياتها السابقة، أتّفق مع جزء من العنوان، وهو (ليلة مع رباب) لأنها ليلةً كان يحلم بها (عبد الحفيظ/ سيف/ الراوي) لكنّي وهذا رأيي، لا أتفق مع الجزء الثاني من العنوان (سيرة سيف الراوي)، لأني لا أرى ولم أقرأ الرواية، ولم تصلني من خلال قراءتي المتواضعة أنها (سيرة ذاتية) أو نصنّفها ضمن (أدب السيرة)، هي رواية تخرج من كل الحدود التي تضعها السيرة ضمنها، فهي كتابٌ وضع المعرفة والثقافة في طبقٍ راقٍ يستمتع بهِ المتلقي، وتستفزّهُ، وتضع أمامه تحديّات كي يتواصل معها، فأنتَ لا تستطيع أن تواكبَ ما تكتبهٌ (فاتحة) إذا لم تمتلك مفاتيح إشاراتها وطلاسمها.
الخاتمة
تنحتُ (فاتحة) في صخر الرواية وعلى جدران معارضها ثقافة أمة، وتخاطب العالم في تشكيل الهُوِيّة عبر الخروج من المألوف والدارج إلى مفهوم يتخطى الحدود والجغرافيا في توظيف الموروث (الإرث) بما يتناسبُ وصورة العالم الجديد.
إنّ هيمنة العولمة وسعيها في طمس الهوية، وتأثير الحروب، ودور الاستعمار بكل أنواعه بعد خروجه من الجلباب العسكري ليدخل من كل ثقب في بيوتنا بشن حروب أعتى من السلاح النووي، جعلت من الأديب الواعي أن يتمسك بهويته وتراثه بعقلٍ مفتوح وأن يجعل من جميل المحتوى وما يكتنزه من علوم ومعارف، وإبعاد الخرافة والوهم وكل ما يسيء إليه ونُخرجُهُ للآخر بصورةٍ حضاريةٍ ونقدّمُهُ بما يليق بهذا الموروث.
وهي (فاتحة) كسرت مظاهر التوتر والقلق والاضطراب والعامل النفسي والرهاب من طمس الهوية، ليكون التراث حاضراً في كل عصر، وصالحاً للتسويق للأجيال اللاحقة. وهي تساهم في ثورة التهجين الأجناسي للرواية لتستوعب هذا الخزين الثر، وأن يكونَ التراث وما يحويه من طابع فلكلوري وعجائبي وشفاهي ومروي ضمن سلطة المدونة والتدوين بعدما كان في حدود سلطة الشفاهي، وأن تتعامل معه (الأديبة) ضمن تعددية المستوى وتتجاوز قوالب التكنيك السردي، لتحلّقَ بالنص في آفاق تستشرف سماوات كل العالم، لأنني أرى (فاتحة) من خلال كتاباتها وفكرها ترى الروايةَ جنساً متحوّلاً، لا ثابتاً. واليوم هي نقلت هذا التراث الضخم من بيوتاتٍ وحاراتٍ مغلقةٍ ومقاهٍ مقفلة تخاف الرقيب، وجعلتْ من هذا المثل (التراث) يرى النور ويراه العالم، لتبدأ رحلة النص المدوّن في عصر الذكاء الاصطناعي.





