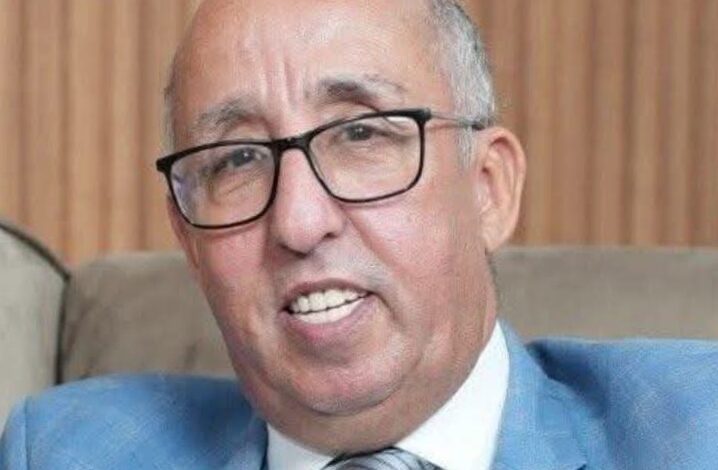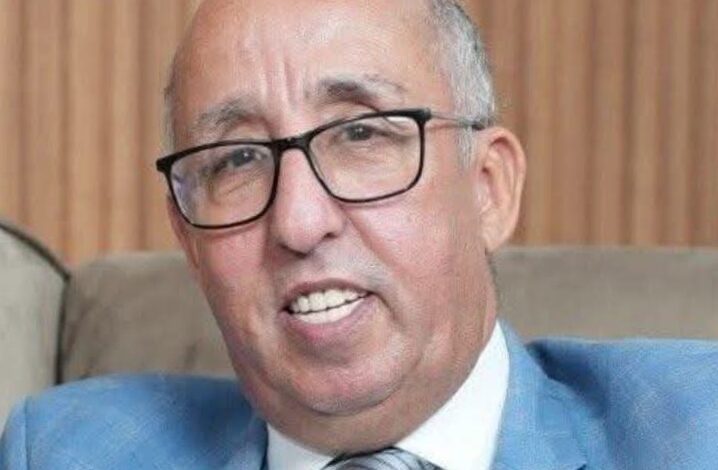بقلم الأستاذ: مصطفى المنوزي
تقديم
صحيح أن الدولة، من خلال مؤسساتها وممثليها، تظل الفاعل الرئيسي في المشهد السياسي والعمومي، خاصة أمام هشاشة المشهد الحزبي وضعف مكوناته التنظيمية والفكرية. غير أن هذا الفراغ – المفروض من الأعلى والمغذّى من الخارج – لا يمكن أن يشكل مبررًا لإطلاق اليد في الهيمنة الرمزية إلى ما لا نهاية. فالهيمنة، وإن كانت ضرورية لضبط التوازنات في مراحل حرجة، سرعان ما تتحول إلى عائق بنيوي حين تتجاوز حدودها المعقولة، لأنها تُنتج احتكارًا للشرعية، وتغذي توتر العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتعيد إنتاج دائرة الريبة وعدم الثقة.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير في طبيعة الشرعية وآفاق الأمن، ليس بوصفهما أدوات للسيطرة، بل كآليات للتجديد والاستباق وبناء التعاقد الاجتماعي.
إن اللحظة المفصلية التي تحدد مآلات الدولة هي لحظة إقرار العقل الأمني بأن الشرعية التاريخية ليست مجرد إرث رمزي أو ترف مؤسساتي، بل شرط لا غنى عنه للاستمرار. غير أن هذه الشرعية، في حد ذاتها، لا تكفي ما لم تُدعَّم بشرعية الديمقراطية؛ إذ أثبت التاريخ أن الشرعيات الموازية – الدينية والوطنية والاجتماعية – لا تتجاوز وظيفة التكميل والدعم الرمزي، دون أن تحسم في معادلة الاستقرار أو بناء الثقة.
إن جوهر الانتقال الأمني لا يقتصر على إصلاح تقني للأجهزة أو تحديث أساليب الضبط، بل هو تخلي واعٍ عن التعريف التقليدي للدولة كتنظيم يقوم على العصبية والدين، ويضمن بالقوة تناوب الأسر المهيمنة على السلطة. هذا التعريف القديم هو ما غذّى تنازع الشرعيات وتنازع السرديات، وأبقى الدولة والمجتمع في حالة هشاشة دائمة.
ولعل ظاهرة السيبة التي عرفها المغرب، وما رافقها من تمرد الهوامش على المركز، تشكل مثالًا تاريخيًا حيًّا على أن غياب الشرعية المقنعة يولّد مقاومات بديلة. فكلما فشلت الدولة في إنتاج شرعية قادرة على الإدماج، برزت الهوامش كفضاء تمرد وعصيان، في شكل دفاع ذاتي أو كسلطة بديلة. وهكذا تحولت السيبة إلى سردية مضادة، لا مجرد واقعة ظرفية.
إن تجاوز منطق السيبة لا يكون بالقمع ولا بإعادة إنتاج مركز متسلط، بل عبر بناء عقد ديمقراطي جديد يدمج الهوامش داخل مشروع الدولة، بدل دفعها إلى العزلة أو الانفصال الرمزي. وهنا يكمن الرهان: انتقال أمني عقائدي يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس جديدة.
ملامح السيناريو المستقبلي
1. تحول في العقيدة الأمنية: من أمن يقوم على الحراسة والرقابة إلى أمن يقوم على الثقة والمواطنة، ومن مركز يخشى الهوامش إلى مركز يستوعبها ويعتبرها مصدرًا للشرعية والدينامية.
2. شرعية مزدوجة: الشرعية التاريخية كذاكرة تأسيسية تحفظ عمق الدولة، والشرعية الديمقراطية كعقد مستقبلي متجدد يؤسس لشراكة سياسية وأمنية حقيقية.
3. دولة المجتمع: دولة آمنة وليست أمنية، قوية بشرعيتها لا مخيفة بأجهزتها، قادرة على تحويل التنوعات والتوترات إلى موارد قوة لا إلى مصادر تهديد.
أفق استشرافي
إن أي انتقال ديمقراطي في المستقبل سيبقى ناقصًا إذا لم يواكبه انتقال أمني على مستوى العقيدة. فالدولة التي تظل أسيرة هاجس العصبية والسيطرة ستبقى عرضة لتنازع الشرعيات، ولن تبرأ من فوبيا الانقراض. أما الدولة التي تدمقرط أمنها وتحوّل سياساتها من منطق التخويف إلى منطق الشراكة، فهي وحدها القادرة على طي صفحة التنازع بين المركز والهوامش، بين النظام والسيبة، وبناء دولة المستقبل: دولة آمنة وليست أمنية، قوية وليست مخيفة.
وكما لعب الحقوقيون دورهم الطلائعي في تيسير الإنتقال السياسي والحقوقي ودعموا إنجاح وحصاد ثمار التسوية السياسية المتوجة بصدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ؛ فإن أي إنتقال منشود لن يمر إلا عبر تأهيل الفعل الحقوقي وفق متطلبات الجيل الجديد من الحقوق ، وعلى الخصوص الانفتاح على الحق في المشاركة في صناعة القرارات الأمنية والمالية والتشريعية المتعلقة بالسياسة العامة والقضايا المصيرية والحيوية الإستراتيجية بعد تحريرها من تمثلات المجال المحفوظ !