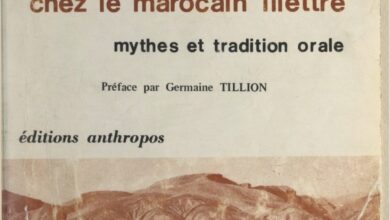جيل مارماس: هيجل ومغالطات العقل الخالص (الحلقة الخامسة)

ترجمة: أحمد رباص
ما هي إذن مراحل الأنثروبولوجيا؟ فالروح، كنفس طبيعية، لها أولاً محتوى يُختزل إلى عواطفها؛ ثم، كنفس تحس، تكون عرضة للانقسام؛ وأخيراً، كنفس فاعلة، تُعبّر عن روحانيتها في جسديتها. لنوضح ذلك:
(أ) النفس الطبيعية واحدة بتأثيراتها أو أحوالها. وكمثال على ذلك، يمكن الاستشهاد بالفقرة التالية:
“يختلف مزاج الرجال في الصباح عن المساء. ففي الصباح، تسود الجدية، ويزداد انسجام العقل مع ذاته ومع الطبيعة. أما النهار، فيُخصص للعمل. وفي المساء، يسود التأمل ونشاط الخيال. وفي منتصف الليل، يعود العقل من تشتتات النهار إلى ذاته، فينفرد بنفسه، وينغمس في التأملات. وبعد منتصف الليل يموت معظم الناس؛ لا ترغب الطبيعة البشرية حينها في بدء يوم جديد بعد”.
يُظهر هذا النص التواضعَ الاستثنائي للنفس الطبيعية في هذه اللحظة. إننا بعيدون كل البعد، وهو أقل ما يمكن قوله، عن الروح المتفلسفة. في صورة النفس الطبيعية المُقدمة هنا، يتعلق الأمر بالحالات المزاجية غير المحددة التي تتوالى في الفرد وفقا لمراحل اليوم. مع ذلك، فإن تأثيرات النفس الطبيعية ذات طبيعة متنوعة. فهي تتخذ أولًا شكل طباع ثابتة (مثل الشخصية)، ثم شكل قرارات متوالية (مثل تعاقب اليقظة والنوم)، وأخيرًا شكل قرارات عابرة ومنظمة بشكل منهجي (أحاسيس تتكشف وفقًا للحواس الخمس).
ب) في الروح العاطفية، نشهد صراعا بين الروح ونفسها. وبهذه الحقيقة تحديدا، تُشحن الروح بالمحتوى. يُشكل القطب الموضوعي للروح العاطفية، بطريقة ما، مخزونًا من التحديدات التي يُمكنها الوصول إلى الوعي، ولكنها أيضا تُحتمل أن تبقى مدفونة في أعماق الروح. يُستبدل الوجود المباشر والفريد لتأثيرات الروح الطبيعية بالوجود الكامن لمجموعة مُعقدة من المحتويات غير المُتأملة. وفي ما يتعلق بالروح العاطفية، يستخدم هيجل صورة “البئر بلا تحديد، حيث يُحفظ كل شيء دون وجود”. وهكذا، تكتسب الروح عالما داخليا حقيقيا تسعى جاهدةً لامتلاكه:
“يتعلق الأمر بالنسبة إلى [الفرد الحساس]، بإثبات جوهريته، الامتلاء الذي لا يكون إلا في ذاته، كذاتية، والاستيلاء على ذاته، والتحول إلى ذاته كقوة [تتصرف] في ذاته”.
أولاً، هناك لحظة سلبية، حيث يمكن أن تخضع الروح لإيحاءات منومة، والدخول في علاقات توارد خواطر مع الآخرين، وإظهار موهبة الاستبصار، وما إلى ذلك. ثم تأتي لحظة الانقسام، حيث تنقسم الروح إلى عدة مبادئ متنافسة. وهنا يأتي اضطراب العقل. أحد أكثر جوانب نظرية هيجل إثارة للدهشة هو تفاؤلها العلاجي. فبينما يرى هيجل أن الجسد الطبيعي مريض في جوهره ومحكوم عليه بالموت، يمكن للعقل دائمًا الهروب من الجنون – حتى لو كان معظم الأفراد، كما يقول، يمرون، في سياق وجودهم، بمرحلة من الوهم بدرجات متفاوتة من الشدة. وأخيرا، تأتي لحظة العادة، عندما تتمكن الروح من تقوية الجسد أمام المضايقات الخارجية أو جعله ماهرا. وهكذا، على الرغم من أنها في وضع الشر اللانهائي، تؤكد الروح سلطتها على الجسد.
ج) أخيرا، تُعبّر النفس، كنفس فاعلة، عن جسدها. وكما جاء في” الموسوعة”، فإن “للنفس، في جسديتها، شكلها الحر، الذي تشعر فيه بذاتها وتسمح بالشعور بها”. وبتعبير أدق، تجعل الروح الفردية جسديتها “المنفذة الخاضعة، اللامقاومة، لإرادتها”. يُظهر هذا التعبير أن تأثير الروح “الفاعلة” على الجسد ليس عنيفًا، بل هو سيادي. وكما نرى، تُجيب نظرية النفس الأنثروبولوجية على سؤال البداية. فالنفس تعاني من جميع عيوب المباشرة، فهي عاجزة عن المعرفة والتصرف بصدق. ومع ذلك، فهي تُشكل الأساس لمزيد من تطور الروح. إنها لحظة يجب تجاوزها، ولكنها لا غنى عنها بنفس القدر.
أي تحليل للروح؟
بعيدا عن الفهم المحدد لمفهوم النفس، يكمن السؤال في معرفة ما يسمح لنا به الفكر التأملي من قول إيجابي عن الروح بصفة عامة. فالنظرية الهيجلية الأساسية، كما نعلم، هي أن الروح لا وجود لها إلا من خلال تحررها من الطبيعة:
“من أين تأتي؟ – من الطبيعة؛ إلى أين تتجه؟ – نحو حريتها. ما تكونه تحديدا هو هذه الحركة لتحرير نفسها من الطبيعة. جوهرها ذاته لا يمكن وصفه كذات ثابتة، تفعل وتسبب هذا أو ذاك، كما لو كان هذا النشاط شيئا طارئا، نوعا من الحالة، يمكن أن توجد خارجها. بل إن نشاطها هو جوهريتها، وفاعليتها هي وجودها”.هذا التصور يعني أن الروح – كفرد، كشعب، كدولة، كذات مُمَثَّلة في عمل فني، كإله مُعبود في ديانة، إلخ – تنتج نفسها بإحداث ” الوجود” لما ليس هو نفسها، أي “الوجود” الخارجي أو “الوجود” لذاته بقدر ما هو مُعطى ببساطة. هذه هي النقطة التي من المفيد دراستها الآن، من خلال تناول محمولات الميتافيزيقا المدرسية كما طرحها كانط. بأي معنى يمكننا القول إن هيجل يُصلح تصور بساطة النفس، وهويتها العددية، وجوهريتها، وكذلك “المثالية” التي تقتضيها هذه الصفات؟ كما سنرى، توجد هنا سلسلة من الاختلافات حول فعل الروح كمنجزة لـ”إحداث” المعطى الخارجي”.
أ) في القاموس المشترك بين كانط وهيغل، يُقابل “البسيط” “المركب”. في قراءة كانط للميتافيزيقيا الدوغمائية، تُشير بساطة النفس إلى طبيعتها غير القابلة للفساد، وبالتالي الخالدة. وهذه إذن سمة ثابتة.
(يتبع)