ثقافة و فن
موت المؤلف: رؤى حداثية عربية-المصطفى عبدون
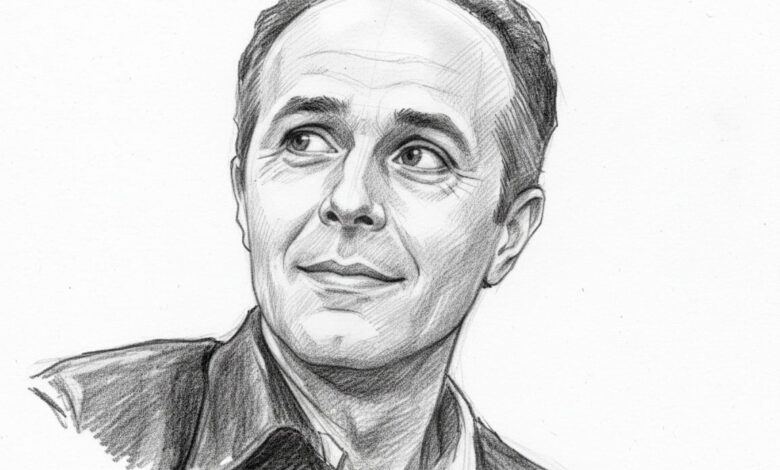
يعتبر الحداثيون أن البنيوية ليست فلسفة أو فكراً، ولكنها طريقة في الرؤية ومنهج في معاينة الوجود فنياً، وآلية في التحليل النقدي.والواقع أن هناك من يرى أن البنيوية قد انزلقت من المنهجية العلمية المستقاة من لسانيات “فرديناند دي سوسير” إلى مجال الإيديولوجيا والمواقف العقائدية وذلك عند طرح “رولان بارت”رؤيته عن النص وأعلن موت المؤلف مشيراً بذلك إلى “موت الإله” الذي أعلنه قبله الفيلسوف الألماني الوجودي “نيتشه”.
وإذا كان الوجوديون قد تخلصوا من الإله، والبنيويون قد تخلصوا من الإنسان، فأي قيمة للوجود وأي قداسة مزعومة للنص اللغوي المجرد المنقطع عن الحياة والمعرفة يقول كمال أبو ديب: “الحداثة انقطاع معرفي ذلك أن مصادرها المعرفية لا تكمن في المصادر المعرفية للتراث والفكر الديني، وكون الله مركز الوجود، وكون السلطة السياسية مدار النشاط الفني، وكون الفن محاكاة للعالم الخارجي، الحداثة انقطاع لأن مصادرها المعرفية هي اللغة البكر والفكر العلماني.”(1)
إن أعلى ما يطمح إليه الشاعر الحداثي هو أن ينتج “لا شيء” كما يقول فلوبير: “كل ما أريد أن أفعله هو أن أنتج كتاباً جميلا حول لا شيء وغير مترابط إلا مع نفسه وليس مع عوالم خارجية”(2)، انفصال وانفصام وانقطاع عن كل قيمة حضارية وإنسانية ورسالية.
إننا لا نستطيع دارسة بنيوية “ياكبسون”و”غولدمان” بمعزل عن المفاهيم الماركسية عن وظيفة الأدب وخاصة كتابات ماركس عن البنية الفوقية “الدين والسياسة” والبنية التحتية “القوى الاقتصادية والاجتماعية” وأن الثانية تتحكم في حركة الأولى في ظل صراع طبقي مستمر بين رأس المال والطبقة الكادحة. صحيح أن الشكلانية جاءت ثورة على هذه الأفكار، لكن أبعادها العقائدية العميقة ظلت ماثلة في ذهن نقاد البنيوية اليساريين.
كما أننا لا نستطيع دراسة بنيوية “بارت”و”كريستيفا” و”دريدا” بمعزل عن المفاهيم الوجودية التي تقول بأن الفكر والثقافة والدين من خلق العقل البشري، وأن الإنسان هو جوهر الوجود، وصولا إلى الفيلسوف “نيتشه” الذي أعلن “موت الإله” وأن الكون ذاتي الجوهر مستغنٍ عن خالق أو موجد له وهذا بالضبط ما قصده “بارت” عندما أعلن موت المؤلف وأن النص مكتفٍ بذاته معزول عن قائله.
إن الغاية القصوى للحداثي فكراً ومنهجاً هو إلغاء كل ما هو مقدس وغيبي. “إذا كانت الحداثة حركة تصدعات وانزياحات معرفية قيمية، فإن واحداً من أهم الانزياحات وأبلغها هو نقل حقل المقدس والأسراري في مجال العلاقات والقيم الدينية والماضوية إلى مجال الإنسان والتجربة والمعيش.”(3)
لذلك لا يمكن فصل التداعيات الفكرية للمنهج البنيوي عن إجراءاته التحليلية، وإلا كانت نوعاً من العبث والفوضى والآليات المجردة التي لا تفضي إلى المعاني والدلالات والقيم الإنسانية.
“وحين ينقل الحداثيون العرب المصطلح النقدي الجديد في عزلة عن خلفيته الفكرية والفلسفية، فإنه يفرغ من دلالاته ويفقد القدرة على تحديد معنى، ويصبح النشاط الفكري في البنيوية والتفكيك ضرباً من العبث أو درساً في الفوضى الثقافية، وكلاهما نوع من الترف الفكري الذي لا يتقبله واقعنا الثقافي، وخاصة ما يتعلق بأنسنة الدين وتطبيق المبادئ النقدية الوافدة على النصوص المقدسة.”(4)
وقد تبني الناقد “عبد الله الغذامي” النصوصية في رؤيته النقدية منطلقاً من الدراسات الألسنية وتداعيات البنيوية وما بعدها، ومتوسلاً بالتشريحية، إجراء تحليلياً تفكيكياً في مقاربة بني النصوص الداخلية، وقد اعتبر الغذامي أن إقصاء المؤلف من العملية النقدية هو تأكيد على النصوصية، فالنصوص هي التي تفسر بعضها، ومن ثم وجب إبعاد العوامل الخارجية عن النص، فالسياق الخارجي لا يمكن أن يحدد علاقات النص ودلالته، لأن النص قد تجاوز هذا الخارجي وتحرر عنه واستقل عنه بوجود جديد، ينبني عليه عالم جديد.(5)
والحقيقة أن الغذامي مفتون بالمناهج الحداثية، وإن حاول أن يبدو موضوعياً ومنتمياً إلى تراثه النقدي واللغوي وذلك بإبدال المصطلحات الغربية التي يؤمن بمضامينها بمقابلات اصطلاحية لغوية عربية تلقى قبولاً لدى النقاد العرب.ولعل ذلك يظهر واضحاً في كتابيه: “الخطيئة والتكفير” و”ثقافة الأسئلة”.
في حديث الناقد “رجاء عيد” عن التناص، نجده يميل إلى عزل النص عن خارجه وقائله، يقول: “إن النص عدد من نصوص ممتدة في مخزون ذاكرة مبدعة، ومن ثم فهو ليس انعكاساً لخارجه أو مرآة لقائله، وإنما فاعلية المخزون التذكري لنصوص مختلفة هي التي تشكل حقل التناص، ومن ثم فالنص بلا حدود.”(6)وقد سبق له في نفس الكتاب التصريح بعدم إمكانية عزل النص عن خارجه أو مؤلفه أو سياقه الثقافي، “فإذا كان النص له هويته القارة في نسيجه اللغوي، فهو كذلك لا ينكفئ على جسده اللغوي، إن للنص علاقة بخارجه، فوحداته الدلالية في سياقها الثقافي لا يمكن عزلها عن تلك التفاعلات المتعددة في أبعادها المختلفة.”(7)
إن تجاهل عالم القيم يقضى على فاعلية النقد البنيوي، باستبعاد كل المضامين الأخلاقية التي لا يخلو منها عمل فني رفيع، والمؤلف ينشأ في عالم القيم ويتأثر به، ومن هنا كان لا بد من تكوين موقف نقدي واضح يتصدى للمناهج التي بقدر ما أفادت النص فهي قد أمعنت فيه خراباً وتمزيقاً، بإقصائها للمؤلف المبدع الذي لولاه لما ظهرت الأعمال الكبيرة الخالدة للوجود.(8)
لقد أوضح “بارت” أن المعنى لا يأتي من خارج اللغة، الأمر الذي يعني انتفاء القصيدة وإقصاء المؤلف، لأنه يمثل قيداً على تفسير النص، إن موت المؤلف يعني رفض فكرة وجود معنى نهائي أو سري أو مقدس للنص، بل رفض وجود الإله ذاته.
وقد قدم عبد الملك مرتاض رؤية متوازنة لم تشكل له فيها مقولة موت المؤلف إغواءً، ورغم رفضه للقراءات السياقية المحضة التي أبعدت النص عن عناصره الجمالية الكامنة في تراكيبه اللغوية، إلا أنه أعطى للمؤلف مكانته في العملية الإبداعية إدراكاً منه لخطورة الانسياق وراء أطروحات النقد البنيوي التي لا تجد لها مبررات فكرية في ثقافتنا العربية والإسلامية، وإدراكاً لخصوصية الثقافة العربية والتراث النقدي القديم كمرجعية في إعطاء المؤلف حقه في الإبداع والنقد على السواء يقول: فالمبدع سيد إبداعه وصاحبه لا ينازعه فيه مجتمع ولا زمان ولا بشر على الرغم من إيماننا بفكرة التناص.(9)وهذا تأكيد على انتماء النص لمؤلفه وأن مقولة موت المؤلف هي مغالطة نقدية تخالف المنطق السوي في الصلة بين المبدعين وأعمالهم.
استعاد عبد العزيز حمودة عبارة “مايكلز”: إن نظرة موت المؤلف تحاول أن تحتفي باستحالة حل مجموعة من المشاكل المؤلوفة: وظيفة قصد المؤلف، وضع اللغة الأدبية، دور الفرضيات التفسيرية” ويعلق إن خطأ هذه النظريات النقدية الحداثية يكمن في التصور بأن هذه البديهيات هي مشكلات حقيقية، وأن تقلب “بارت” المزاجي وسعيه وراء الموضة والمخالفة، جعله يعلن موت المؤلف ثم يعود للاعتراف بوجوده وأنه لا جدوى من إقصائه عن نتاجه الإبداعي في حديثه عن سيميولوجيا القراءة.(10)
ويظل التساؤل قائماً: هل جاءت نظرية موت المؤلف لتحل مشكلة النص ودلالاته، أم أنها جاءت استجابة للرؤى الفلسفية السائدة، أو خطاباً مزاجياً للمعهود، بل وللمنطق العقلي، فالإنسان هو الذي اخترع اللغة، فكيف نسمح لها أن تقتله؟! إن مثل التعسف في إعلاء قيمة النص على حساب مؤلفه واستنطاقه بما لا يحمله من دلالة كمثل وضع النص على آلات التعذيب ليجبر على الاعتراف بجريمة مقيدةٍ ضد مجهول أم أنها الفوضى الخلاقة التي بشرت بها إحدى الأبواق العولمية السوداء.
يعترض الناقد فاضل ثامر على إجراءات البنيوية التي تمنح النص والقراءة سلطة تامة وتلغي فعل المؤلف والإنسان واعتبر أن هذا الطريق أحادي قاصرعن فهم الظاهرة الأدبية فهماً شاملاً، ويعتقد أن النص له تجربة خاصة تبثها الذات المبدعة وتتأثر بالسياق التاريخي والثقافي وله جمالياتها اللغوية، وعلى الرغم من الكثير من المحاولات الشكلية والجمالية المتطرفة، تظل هناك علاقة جدلية عميقة بين المكونات الجمالية والأدبية والشعرية من جهة وبين المكونات الإيديولوجية والمعرفية والرؤيوية من جهة أخرى داخل النص الأدبي، وأن أي محاولة لإقامة تعارض بين الجانبين محاولة مصطنعة محكوم عليها بالفشل.(11)
إن الخطاب الإبداعي ليس وثيقة فكرية أو تاريخية أو دينية، لكن السياق الفكري والتاريخي والديني إضافة إلى الثقافة والرسالة التي يحملها المؤلف، يلقي بظلال شفيفة رهيفة متموجة، يمكن للإضاءة النقدية أن تنفذ من خلالها إلى البنية العميقة للنص، ويتوازى ذلك مع تفكيك البنى اللغوية الدالة الحية لاستكشاف جمالياتها الذاتية الشكلية وبذلك تجتمع المقاربة الشكلية والموضوعية ويتحقق الجمال من امتزاجهما.
وقد اقترح بعض النقاد المحدثين أن نقوم بعملية إزاحة مؤقتة لسلطان المؤلف عن النص، ثم نعيده ضيفا عليه، يقول عبدالله الغذامي “إن مفهوم الموت لا يعني الإزالة والإفناء، ولكنه يعني تمرحل القراءة موضوعياً من حال الاستقبال إلى التذوق، ثم إلى التفاعل وإنتاج النص وهذا يتحقق موضوعياً بغياب المؤلف، فإذا ما تم إنتاج النص بواسطة القارئ فإنه من الممكن حينئذ أن يعود المؤلف إلى النص ضيفاً عليه.”(12)
يمكن لنا تنفيذ هذا الإجراء الآلي، لكن روح المؤلف ستظل تحوم في المكان وهو صاحب المأوى الجميل(النص) الذي يأوي إليه القراء الضيوف للتماهي معه واستكشاف جمالياته.”لقد كشفت البنيوية عن نزعة لا إنسانية – عندما أعلنت موت المؤلف – بمعنى أنها لم تؤمن بقدرة الإنسان على التأثير في التاريخ والواقع الاجتماعي بوصفه ذاتاً فاعلة، بل نظرت إليه بوصفه منعزلا وخاضعاً لهيمنة الأنموذج اللغوي والأنساق البنيوية، وبذلك جردته من أي حرية أو قدرة على ممارسة الإدارة الإنسانية.”(13)
الهوامش:
-
كمال أبو ديب، مقال بمجلة فصول المجلد الرابع العدد الثالث، 1984، ص37.
-
مالكولمبرادبري وجيمس ماكفلرن، الحداثة 1890-1930، ترجمة مؤيد حسن فوزي، بغداد، دار المأمون للترجمة والنشر،1987، ص25.
-
خالدة سعيد، الحداثة وعقده جلجامس، مقال بمجلة “قضايا وشهادات” نيقوسيا شتاء، 1991، ص273.
-
عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، ص64.
-
انظر عبد الله الغزامي، تشريح النص مقاربات تشريحية لنصوص معاصرة، لبنان، دار الطليعة،1987، ص79.
-
رجاء عيد، القول الشعري، مصر، دار المعارف، 1990، ص225.
-
رجاء عيد، القول الشعري، ص21.
-
انظر محمد علي الكردي، النقد البنيوي بين الأيدلوجيا والنظرية، مجلة فصول العدد الأول، القاهرة، 1983، ص270.
-
انظر عبد الملك مرتاض، في نظرية النص الأدبي، مجلة الموقف الأدبي، دمشق، 1989، ص201.
-
انظر عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، جريدة الرياض العدد 298، نوفمبر 2003، ص38.
-
فاضل ثامر، اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح، المركز الثقافي العربي بيروت، 1994، ص135.
-
عبد الله الغذامي، ثقافة الأسئلة، الكويت، دار سعاد الصباح، 1993، ص205.
-
فاضل ثامر، اللغة الثانية، ص114.





