البنيوية التكوينية في النقد الأدبي-المصطفى عبدون
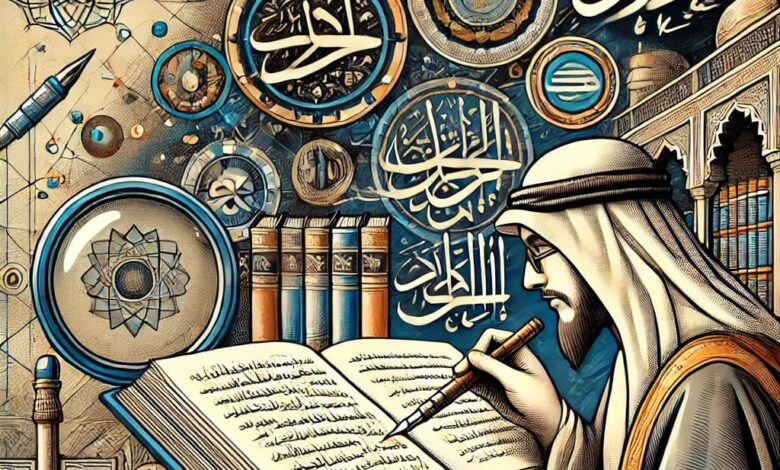
البنيوية هي منهجية نقدية تحليلية تستخدم في عدة تخصصات علمية. تقوم البنيوية على دراسة العلاقات المتبادلة بين العناصر الأساسية المكونة لبُنى يمكن أن تكون عقلية مجردة، أو لغوية، أو اجتماعية، أو ثقافية. فهي تدرس مجموع النظريات المطبقة في علوم ومجالات مختلفة مثل الإنسانيات والعلوم الاجتماعية والاقتصاد. لكن ما يجمع جميع هذه النظريات، هو تأكيدها على أن العلاقات البنيوية الداخلية للعناصر الأساسية والمكونات تختلف حسب المجال المعرفي والتخصص الأكاديمي وأن هذه العلاقات يمكن كشفها ودراستها.
البنيوية هي مقاربة أو طريقة (منهج) تتضمن دراسات لتركيب “شبكات بنيوية” كالبنى العقلية العليا أو الاجتماعية أو اللغوية أو الثقافية بشكل خاص، مما يجعلها على صلة وثيقة بعلم الإنسان الذي يُعنى بدراسة الثقافات المختلفة وكذلك بالنقد الأدبي، تستخدم بشكل عام لاستكشاف العلاقات في اللغة، والأدب. عبر هذه الشبكات البنيوية، يتم إنتاج ما يسمى ب”المعنى” من خلال شخص معين أو نظام معين أو ثقافة معينة. البنيوية كاختصاص أكاديمي أو مدرسة فلسفية، بدأت حوالي 1958 وبلغت ذروتها في الستينات والسبعينات.
- المنهج البنيوي في النقد الأدبي
البنيويّة لغةً من بَنى يبني بناءً، أيّ صورة أو هيئة البناء، والعناصر التي أدت إلى تكوينه، والبنيوية اصطلاحًا هو منهج نقدي، يعتمد على قراءة النص وفق مبادئ وأسس مضبوطة، إذ ينظر هذا المنهج إلى النص على أنّه بنية لها قواعدها التي تُنظم عناصر الخاصة على نسق واحد، وتستقل دلالتها عن الخارج، فالمفاهيم والأفكار والدلالات تُستخرج من خلال قراءة النص. اتسم المنهج البنيوي بعدة خصائص ميزته عن باقي المناهج الحديثة في النقد الأدبي، وهذه الخصائص تتمثل فيما يأتي:
الكلية أو الشمولية: تعني خضوع العناصر التي تُشكّل البنية لقوانين تُميّز المجموعة كمجموعة، أو الكل ككلّ واحد، وهذه الخاصية انطلقت منها البنيوية في نقدها للأدب من المُسَلَّمة القائلة إنّ البنية تكتفي بذاتها، ولا يتطلب إدراكها اللجوء إلى عناصر غريبة عنها وعن طبيعتها.
إنّ العمل الأدبي إذًا يخضع لعدة قواعد وقوانين تطبع هذه العناصر بصفات تختص بها عن غيرها، أيّ أنّ البنيوية تُضيف طابعًا من التركيبة على العمل الأدبي، مثل: خاصية شمولية البنية وكليتها التي لا تسمح بالاكتفاء بأجزاء منها عند الدراسة، ولا تسمح بإدخال ما ليس منها؛ لأنّ ذلك يُؤدي إلى تغيير في البنية.
التحوّل: يعني أنّ هناك قانونًا داخليًّا يقوم بالتغيرات داخل البنية التي لا تبقى في حالة ثابتة، فهي دائمة التغير، فكلّ عنصر من عناصر المنهج يتضمن جزءًا من البناء الداخلي للعمل الأدبي وله دور في البناء الهيكلي للعمل، وهو ما يُعطي النص عملية التجدد لكون النّص الخاضع للتحولات الداخلية حاملًا لأفكار في داخله ومنتجًا لأفكار جديدة إذا ما دخلت على البنية التحوّلات.
الانتظام الذاتي: أي أنّ البنية تستطيع تنظيم ذاتها بذاتها لتُحافظ على وحدتها واستمراريتها، فكما يقول “بياجي” إنّ أيّ بنية باستطاعتها ضبط نفسها ضبطًا ذاتيًّا يُؤدي للحفاظ عليها، ويضمن لها نوعًا من الانغلاق الإيجابي، وهو ما يجعل البنية تحكم الذاتية بمكوناتها، بحيث لا تحتاج إلى شيء آخر يلجأ المُتلقي ليستعين به على فهمها ودراستها وتذوقها. (خلود المعاويد .https://mawdoo3.com)
1-1 تاريخ البنيوية
برزت البنيوية في بدايتها في مطلع القرن التاسع عشر ضمن حقل علم النفس، لكن سطع نجمها في منتصف القرن العشرين حين اخترقت جميع أنواع العلوم والتخصصات. ظهرت البنيوية كمنهج ومذهب فكري، على أنها ردة فعل على الوضع الذري الذي ساد العالم الغربي في بداية القرن العشرين، وانعكس على مجالات المعرفة وتفرعها إلى تخصصات دقيقة متعددة حيث تم عزل بعضها عن بعض لتجسد من ثم مقولة الوجوديين حول عزلة الإنسان وانفصامه عن واقعه والعالم من حوله، وشعوره بالإحباط والضياع والعبثية. ولذلك ظهرت أصوات تنادي بالنظام الكلي المتكامل والمتناسق الذي يوحد ويربط العلوم بعضها ببعض، ومن ثم يفسر العالم والوجود ويجعله مرة أخرى بيئة مناسبة للإنسان.
ولا شك أن هذا المطلب مطلب (عقدي) إيماني، إذ أن الإنسان بطبعه بحاجة إلى (الإيمان) مهما كان نوعه. ولم يشبع هذه الرغبة ما كان وما زال سائدا من المعتقدات الإيديولوجية، خاصة الماركسية والنظرية النفسية الفرودية، فقد افتقرت مثل تلك المذاهب إلى الشمول الكافي لتفسير الظواهر عامة، وكذلك إلى العلمية المقنعة، ظهرت البنيوية كمنهجية لها إيحاءاتها الإيديولوجية بما أنها تسعى لأن تكون منهجية شاملة توحد جميع العلوم في نظام جديد من شأنه أن يفسر علميا الظواهر الإنسانية كافة، علمية كانت أو غير علمية.
فاستحوذت علاقة الذات الإنسانية بلغتها وبالكون من حولها على اهتمام الطرح البنيوي في عموم مجالات المعرفة: الفيزياء، والرياضيات، والانثروبولوجيا، وعلم الاجتماع، والفلسفة والأدب. وركزت المعرفة البنيوية على أن العالم حقيقة واقعة يمكن للإنسان إدراكها. ولذلك توجهت البنيوية توجها شموليا إدماجيا يعالج العالم بأكمله بما فيه الإنسان. أبرز من عمل ضمن إطارها وعمل على تطويرها: “فريديناند دي سوسير” و”كلود ليفي شتراوس”.
1-2 أنواع البنيوية:
إذا تأملنا البنيوية جيدا وبعمق دقيق باعتبارها مقاربة ومنهجا وتصورا، فإننا سنجد بنيويات عدة وليس بنيوية واحدة: فهناك البنيوية اللسانية مع دوسوسور ومارتنيه وهلمسليف وجاكبسون وتروبوتسكوي وهاريس وهوكيت وبلومفيلد، والبنيوية السردية Narratologie مع رولان بارت وكلود بريمون وجيرار جنيت، والبنيوية الأسلوبية stylistique مع ريفاتير وليو سبيتزر وماروزو وبيير غيرو، وبنيوية الشعر مع جان كوهن ومولينو وجوليا كريستيفا ولوتمان.، والبنيوية الدراماتورجية أو المسرحية Dramaturgie مع هيلبو. أو البنيوية السينمائية مع كريستيان ميتز.، والبنيوية السيميوطيقية مع غريماس وفيليب هامون وجوزيف كورتيس.، والبنيوية النفسية مع جاك لاكان وشارل مورون، والبنيوية الأنثروبولوجية خاصة مع كلود ليڤي شتراوس الفرنسي وفلاديمير بروب الروسي، والبنيوية الفلسفية مع جان بياجيه وميشيل فوكو وجاك دريدا ولوي ألتوسير.
- البنيوية التكوينية
البنيوية التكوينية، أو التوليدية (المحجوب المحجوبي البنيوية التكوينية وقراءة النص الأدبي)، هي فرع من فروع البنيوية نشأ استجابة لسعي بعض المفكرين والنقاد الماركسيين للتوفيق بين طروحات البنيوية، في صيغتها الشكلانية، وأسس الفكر الماركسي أو الجدلي، كما يسمى أحيانا، في تركيزه على التفسير المادي الواقعي للفكر والثقافة عموما. أسهم عدد من المفكرين في صياغة هذا الاتجاه منهم المجري “جورج لوكاش”، والفرنسي “بيير بورديو”. غير أن المفكر الأكثر إسهاما من غيره في تلك الصياغة هو الفرنسي الروماني الأصل “لوسيان غولدمان”.
كانت طروحات “غولدمان” نابعة وبشكل أكثر وضوحا من طروحات المفكر والناقد المجري “جورج لوكاش” الذي طور النظرية النقدية الماركسية باتجاهات سمحت لتيار كالبنيوية التكوينية بالظهور وعلى النحو الذي ظهرت به، في الوقت الذي استفاد فيه أيضا من دراسات عالم النفس السويسري “جان بياجيه”، وقد أشار “غولدمان” إلى تأثير “بياجيه” تحديدا في استعماله لمصطلح البنيوية التكوينية. قامت البنيوية التكوينية في مقاربتها للنص الأدبي على مجموعة من المفاهيم الأساسية أهمها:
2-1 الفهم والتفسير:
يعتبر الفهم مرحلة وصفية تفكيكية تقوم على الاستقراء والملاحظة، يهدف إلى تحديد بنية دالة تشمل كلية النص، فيحيط بمجمله بدون إضافة أي شيء. إنه مسألة تتعلق بالتماسك الباطني للنص حيث يفترض “غولدمان” أن نتناول النص حرفيا، كل النص ولا شيء سوى النص، وأن نبحث داخله عن بنية شاملة ذات دلالة، أي أن الفهم عملية تقتصر على النص الأدبي معزولا عن المؤشرات الخارجية التي لا شك أنها تلعب دورا تأثيريا فيه، وتتوجه أساسا إلى الكشف عن توضيح بنائه الداخلي أو بنيته الدالة.
أما التفسير فمسألة تتعلق بالبحث في الذات الفردية أو الجماعية التي تمتلك البنية الذهنية المنتظمة للنتاج الأدبي الذي يحمل طابعا وظيفيا ذا دلالة. فهو عملية ثانية تنظر إلى العمل الأدبي في مستوى آخر خارجي، فتربطه ببنية أوسع وأشمل. إلا أن ما سبق لا يعني دائما أن الفهم يستبد بالبنية الداخلية للنصوص، والتفسير يقتصر على ما هو خارجي عنها، فـ”غولدمان” يشير إلى حقيقتين أساسيتين ترتبطان بالقوانين الخاصة بالفهم والتفسير، تم الكشف عنهما بفضل أعمال علم الاجتماع البنيوي التكويني ومجابهتهما للأعمال النفسية وهما:
أن النظام الأساسي لطريقتي البحث هاتين ليس واحدا في كلا المنظورين، فالفهم والتفسير رغم النقاشات الموسعة التي دارت خاصة في الجامعة الألمانية حول طريقتي البحث هاتين، لا يختلف أحدهما عن الآخر، فبالنسبة للنقطة الأولى يشير”غولدمان” إلى أنه يستحيل فصل الفهم عن التفسير، سواء إبان فترة البحث أو بعد الانتهاء منها، لكن هذا الفصل يكون ممكنا في التحليل السوسيولوجي، فهما في نظره طريقتان ذهنيتان غير مختلفتين، بل إنهما طريقة واحدة، فالفهم – كما أشار- هو الكشف عن بنية دالة، أما التفسير فإنه يدرج تلك البنية في بنية شاملة مباشرة.
وما يمكن أن نشير إليه هنا، هو أن العلاقة التي تربط الفهم بالتفسير هي علاقة تكامل وترابط، فالفهم أضيق من التفسير، والتفسير يتضمن الفهم بل ويتعداه. ويضرب “غولدمان” لهذا الجانب أمثلة توضيحية إذ يقول: وعلى سبيل المثال نذكر كيف أن فهم الخواطر أو مآسي “راسين”، هو نفسه الكشف عن الرؤية المأساوية المكونة للبنية الدالة المنتظمة لكل من هذه الأعمال في جملته وأن فهم تاريخ النبالة المثقفة للقرن السابع عشر، هو ذاته عنصر للتفسير، كما أن فهم العلاقات الطبقية في المجتمع الفرنسي للقرن السابع عشر، هو تفسير لتطوير النبالة المثقفة وهكذا.
2-2 البنية الدالـة:
إن البنية الدالة تقوم بتحقيق هدفين اثنين: يتعلق الأول بفهم الأعمال الأدبية من حيث طبيعتها ثم الكشف عن دلالتها، وهذا هدف يبدو أكثر ارتباطا بعملية الفهم، أما الثاني فيتعلق بالحكم على القيم الفلسفية والأدبية والجمالية. والرواية في إطار التصور البنيوي التكويني تحتوي على بنية دالة، تقابلها بنية فكرية خارجية هي بنية إحدى رؤى العالم لدى جماعة بشرية معينة. وهذه البنية الدالة لا يمكن إدراكها، إلا حين تجاوز المظهر الخارجي للعمل الروائي، وقد يكون هذا المظهر ذا شكل خرافي أسطوري، لكن دلالته العميقة قد تكشف عن بنية دالة لها علاقة مع أحد التصورات الموجودة عن الواقع، فإنه على مستوى المحتوى الأدبي تكون للمبدع حرية كاملة في التصرف والاستفادة من تجاربه الشخصية وذكائه لخلق عالم خيالي، وهذا العالم هو نفسه البنية السطحية حيث يجب تفكيكه بهدف الوصول إلى النظام الفكري الذي يحكمه، وهذا النظام هو البنية الدالة.
وإذا كانت المناهج السوسيولوجية التقليدية في دراستها للأدب لم تهتم ببنية العمل الأدبي حين تركيزها على العلاقة القائمة بين مضمون العمل الأدبي ومضمون الوعي الجماعي، فان منهج “غولدمان” ركز على البنية انطلاقا من الوظائف التي تؤديها في العمل الأدبي. وأشار “غولدمان” إلى الكيفية التي يتوصل بها لاكتشاف البنية الدالة، فعلى الباحث – في نظره – لكي يفهم العمل الذي هو بصدد دراسته أن يتقيد في المقام الأول بالبحث عن البنية التي تكاد تشمل كلية النص، وذلك استنادا إلى قاعدة أساسية نادرا ما يحترمها المختصون في الأدب، وهي أن على الباحث أن يحيط بمجمل النص وأن لا يضيف إليه أي شيء وأن يفسر تكوينه. فاستخلاص البنية الدالة في العمل الأدبي عامة والرواية خاصة، لا يكون إلا عبر قراءة جزئيات النص في ضوء مجموع النص ذاته، مع التركيز على ماله دلالة وظيفية أساسية في العالـم. وقد ترك “غولدمان” مجال البحث عن البنية الدالة في العمل الروائي رهينا بقدرات الناقد الحدسية.
ومفهوم البنية الدالة لا يفترض فقط وحدة الأجزاء ضمن كلية النص والعلاقة الداخلية بين العناصر، بل يفترض في نفس الوقت الانتقال من رؤية سكونية إلى رؤية دينامية، أي وحدة النشأة مع الوظيفة. وألح “غولدمان” على الانسجام بين البنيات، والذي يمكن أن يجد تعبيره عن طريق مضامين خيالية تخالف أشد الاختلاف المحتوى الواقعي والحقيقي للوعي الجمعي. وهذا التناسق بين البنيات يخالف التصور السوسيولوجي الكلاسيكي الذي يقيم علاقة انعكاس ميكانيكي بين الوعي الجمعي والعمل الأدبي.
2-3 الوعي القائـم والوعـي الممكــن:
إن الوعي من المفاهيم التي يصعب تحديدها تحديدا دقيقا، ورغم ذلك فقد عرفه “غولدمان” بأنه مظهر معين لكل سلوك بشري يستتبع العمل. وإن كلمة مظهر تفرض وجود ذات عارفة وموضوعا للمعرفة، وهذه الذات العارفة ليست لا فردا معزولا ولا جماعة بدون زيادة، بل هي بنية جد متغيرة ينضوي تحتها في آنٍ الفرد والجماعة أو عدد معين من الجماعات. من هنا يمكن القول بأن كل واقعة اجتماعية هي واقعة وعي من بعض جوانبها، وكل وعي هو قبل كل شيء تمثيل لقطاع معين من الواقع على وجه التقريب، وهكذا، فإذا كانت كل واقعة اجتماعية تستتبع وقائع وعي، فان العنصر البنيوي الأساسي لوقائع الوعي تلك، هو درجة تلاؤمها أو درجة اللاتلاؤم مع الواقع.
يميز “غولدمان” بين نمطين من الوعي: “الوعي الواقع” و”الوعي الممكن”. و”الوعي الواقع” هو وعي بسيط لا يتوفر صاحبه على إمكانية التأمل فيه، فيفكر بالسلوك أكثر مما يفكر بالذهن، أما الوعي الممكن لا يصله الفرد إلا عندما يستطيع التأمل بفضل ثقافته وخبرته في المعطيات الفكرية لجماعته، من أجل أن يبني بواسطتها مستوى متبلورا لمصالح الجماعة وأهدافها، آنذاك يرفع في ذاته “الوعي الواقع” إلى مستوى “الوعي الممكن”. وهذا الوعي هو أساس الوعي القائم الذي يعتبر نتيجة العديد من المعوقات والتحريفات التي تعيق تحقيق الوعي الممكن من جراء مختلف عناصر الواقع التجريبي.
والنتاج الأدبي ومنه الرواية ليس انعكاسا بسيطا للوعي الجمعي، ولكنه تعبير راق عن هذا الوعي، بمعنى أنه لا يرتبط بأفكار عامة الناس، وإنما يرتبط بالإيديولوجيا والفكر النظري اللذين يصوغهما الأعضاء للجماعة. من هنا تبرز أهمية الوعي الممكن، إذ بواسطته يمكن تحديد الرؤية بشكل جيد وخاصة في الأعمال الكبرى.
2-4 رؤيـة العالـم:
إن مفهوم ” رؤية العالم”، يعتبر من أهم العناصر التي تنبني عليها البنيوية التكوينية كما صاغها “غولدمان”، وهذا المفهوم استعمله كثير من المفكرين السابقين لـ”غولدمان” أمثال: “ديلثي”، “ياسبرز”، “لوكاتش”، “كارل مانهايم” و”ماكس فيبر”. وهؤلاء جميعا ينتمون إلى مختلف فروع العلوم الإنسانية. وتباينت مفاهيم هؤلاء لرؤية العالم، فهذا المفهوم لا يشكل عند “ديلثي” مفهوما إجرائيا بل مكونا فعالا لما يعانيه الفرد ويعيشه، وبناء على ذلك فهو يبدو من اختصاص علم النفس، فإن كل كائن يرد على ما يتولد عن موقفه في المجتمع من مشاكل بواسطة نموذج يبنيه بشكل تدريجي، وحينئذ لا يبدو التحديد المجتمعي إلا عاملا ثانويا يضفي صبغة الوحدة على تنوع النظرات كما هي عند الأفراد. أما “كارل مانهايم”، فالمفهوم عنده يوافق المفهوم الكلي للإيديولوجيا، وهكذا فالإيديولوجيا بما هي كذلك، تتخذ بعدا ضيقا، ومن ثمة يقصد “مانهايم” إلى التفريق بين النظرة إلى العالم والإيديولوجيا، فيوضح بذلك الالتباسات التي تقع فيها الماركسية، حيث تتخذ نظرية الإيديولوجيا معاني متعددة.
وإذا كان تحديد” ديلثي” لمفهوم “رؤية العالم” منطلقا من مرجع سيكولوجي، فان “كارل مانهايم” حدده من خلال منظور إبستيمولوجي. أما عند “ماكس فيبر”، فالنموذج الذهني الذي يشترك مع النظرة إلى العالم في نقاط متعددة، هو نموذج نواجهه بالواقع كي نقيس مدى ابتعاده عنه، ونقيمه انطلاقا من بعض العناصر التي نستقيها من الواقع، ولكي ننتقيها بدلالة السؤال الذي يطرحه الباحث. ورغم هذا التعدد في مفهوم “رؤية العالم” لدى هؤلاء الدارسين، فقد وجد بينهم عنصر مشترك هو مفهوم الكلية كما تحددت في مرجعها الهيغيلي، و”غولدمان” نفسه قد لجأ إلى هذا المفهوم.
وما يمكن ملاحظته هو أن استعمال مفهوم “رؤية العالم” في الدراسات السابقة ل”ـلوكاتش” و”غولدمان ” قد اتسم بالغموض، ووظف في غير مجاله في الفلسفة وعلم النفس والتاريخ. إلا أن “جورج لوكاتش” كان إيجابيا في استخدامه له، إذ استعمله بكيفية دقيقة في مجال النقد الأدبي. يؤكد هذا ما ذهب إليه ” لوسيان غولدمان” حين أشار إلى أن المفهوم ليس من أصل جدلي، استعمله “ديلثي” ومدرسته بكثرة، لكن بشكل غامض وفج، دون أن ينجحوا في إعطائه وضعا إيجابيا صارما. وإن الفضل في استعماله بالدقة اللازمة، لتصبح أداة عمل، يرجع بالدرجة الأولى إلى “جورج لوكاتش”، وأعطى “غولدمان” لهذا المفهوم اهتماما خاصا في مختلف ما كتبه، إلا أنه ركز عليه في مؤلفه” الإله الخفي”.
يعرف “غولدمان” “رؤية العالم” بقوله: إن الرؤية للعالم هي بالتحديد، هذه المجموعة من التطلعات والإحساسات والأفكار التي توحد أعضاء مجموعة اجتماعية، وفي الغالب أعضاء طبقة اجتماعية، وتجعلهم في تعارض مع المجموعات الأخرى، إنها بلا شك خُطاطة تعميمية للمؤرخ، ولكنها تعميمية لتيار حقيقي لدى أعضاء مجموعة يحققون جميعا هذا الوعي بطريقة واعية ومنسجمة إلى حد ما. ويقدم تعريفا آخر لنفس المفهوم قائلا: إنه التقدير الاستقرائي التصويري إلى أعمق مدى التحام الأحاسيس المتحركة لأفراد فئة اجتماعية ما، ومجموعة مترابطة من القضايا والحلول التي يتم التعبير عنها على المستوى الأدبي عن طريق الإبداع، بواسطة الألفاظ وبواسطة كون محسوس من المخلوقات والأشياء.
وانطلاقا مما سبق يمكن القول بأن “رؤية العالم” تبدو متعارضة مع مفهوم الرؤية الفردية، بمعنى آخر، إن هذه الرؤية تبتعد عن أن تكون نسقا فرديا لتتخذ طابعها الاجتماعي التاريخي. ويذهب “غولدمان” إلى أن “رؤية العالم” في العمل الأدبي ليست من إبداع الأفراد، ويرى في منظور مادي جدلي، أن الأدب والفلسفة من حيث إنهما تعبيران عن رؤية للعالم – في مستويين مختلفين – فإن هذه الرؤية ليست واقعة فردية، بل واقعة اجتماعية تنتمي إلى مجموعة وإلى طبقة. وإن ما يمكن أن نشير إليه، هو أن الفرد المبدع لا يمكن أن يخلق من تلقاء نفسه بنية فكرية منسجمة تستطيع أن تمثل رؤية للعالم، فهذا الأمر يكون من إبداع الجماعة. أما ما يقوم به الفرد المبدع هو الارتقاء بتلك البنية إلى درجة عالية من الانسجام حتى ترقى إلى مستوى الإبداع الخيالي.
إلا أن هذا لا يعني نفي الفرد المبدع نهائيا، فدوره رغم كل شيء يبقى حاضرا في الإبداع وخاصة الإبداع الروائي، وهذا الوجود يتحقق في صياغة “رؤية العالم”، إذ بمقدوره أن يبلور تلك الرؤية بشكل واضح ومنسجم. والفرد المبدع يختلف عن أفراد الجماعة العاديين الذين لا يتجاوز وعيهم مستوى “الوعي الواقع”. وبذلك فكبار الأدباء والفلاسفة وغيرهم من المنظرين، هم الذين يستطيعون دون غيرهم التعبير عن مشاعر وأفكار الجماعة التي يتكلمون باسمها. إن “غولدمان” لا يأخذ مقولة “رؤية العالم” في معناها التقليدي، الذي يشبهها بتصور واع للعالم، تصور إرادي، أو النسق الفكري الذي يسبق عملية تحقق النتاج. إن ما هو حاسم، ليس هو نوايا المؤلف، بل الدلالة الموضوعية التي اكتسبها النتاج، بمعزل عن رغبة مبدعه، وأحيانا ضد رغبته. وهكذا فالفرد قد يحقق “رؤية العالم” بصورة لا شعورية، ومن ثم قد تترسخ في ذهنه وربما ضد رغبته الخاصة. ويبقى كدليل حي على ذلك، ما يوجد من تفاوت بين النوايا الإبداعية للمبدع والأفكار التي يعبر عنها من خلال عمله الإبداعي.
إذن فـ”رؤية العالم” لا يمكنها في رأي “غولدمان” أن تتكون إلا في إطار الجماعة، فعلى الرغم من انتسابها إلى الكاتب، فإنها ليست من إبداعه الخاص، فهي في الرواية ترتبط بنظرة الكاتب العامة إلى الواقع الموضوعي، وكل رواية لابد أن تحمل تصورا معينا عن هذا الواقع. وهذه الرؤية تختلف مستوياتها وتتفاوت من رواية إلى أخرى، وذلك تماشيا مع طبيعة هذه الرؤية، فقد تكون شمولية وقد تكون دون ذلك. والرواية يمكن أن تفقد انسجام الرؤية إلى العالم لتسقط فيما يسمى بالوعي الواقع، وذلك حين تتقلص الرؤية الشمولية. من هنا يمكن القول إن “رؤية العالم” تتجاوز ما هو واقع إلى ما هو مستقبلي، وما دامت الأعمال الروائية الكبرى تتميز بشمولية الرؤية، فإنها هي وحدها التي تمتلك “رؤية العالم”. هذه الرؤية التي تعتبر في الواقع تعبيرا كليا وشموليا عن قيم وطموحات ومشاعر الجماعة التي تؤمن بها.
خاتمة
وفي الختام يمكن القول أن البنيوية تستند إلى مجموعة من المصطلحات والمفاهيم الإجرائية في عملية الوصف والملاحظة والتحليل وهي أساسية في تفكيك النص وتركيبه كنسق ونظام وبنية داخلية، يتشكل من عناصر وشبكة وعلاقات وثنائيات ومستويات وبنيات التعارض والاختلاف والمحايثة والسانكرونية والدياكرونية والدال والمدلول والمحور التركيبي والمحور الدلالي والمجاورة والاستبدال والفونيم والمورفيم والمونيم والتفاعل، والتقرير والإيحاء، والتمفصل المزوج… هذه المفاهيم ستشتغل عليها فيما بعد كثير من المناهج النقدية ولاسيما السيميوطيقا الأدبية والأنثروبولوجيا والتفكيكية والتداوليات وجمالية القراءة والأسلوبية والموضوعاتية.
المراجع
- ابراهيم حجاج الحوار المتمدن-العدد: 3812 – 2012 / 8 / 7 – 23:18 المحور: الادب والفن
- ويكيبيديا، الموسوعة الحرة http://ar.wikipedia.org/wiki
- أزمة المعرفة التاريخية – فوكو وثورة في المنهج. تأليف: بول فيين تاريخ النشر: 01/01/1993. ترجمة: ابراهيم فتحي. الناشر: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع
- المحجوب المحجوبي البنيوية التكوينية وقراءة النص الأدبي http://diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=40422






