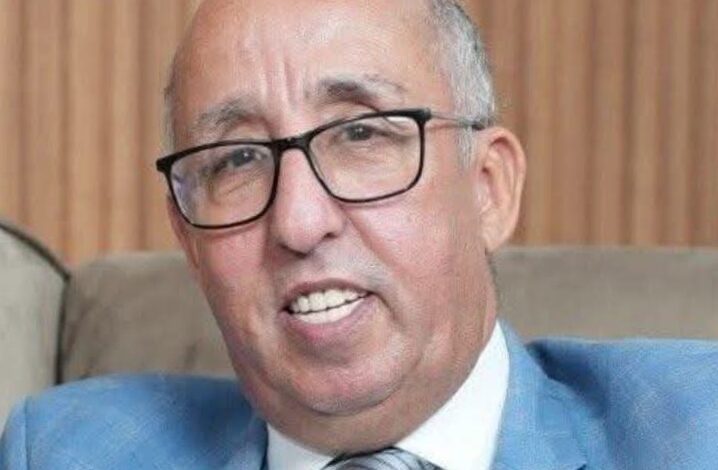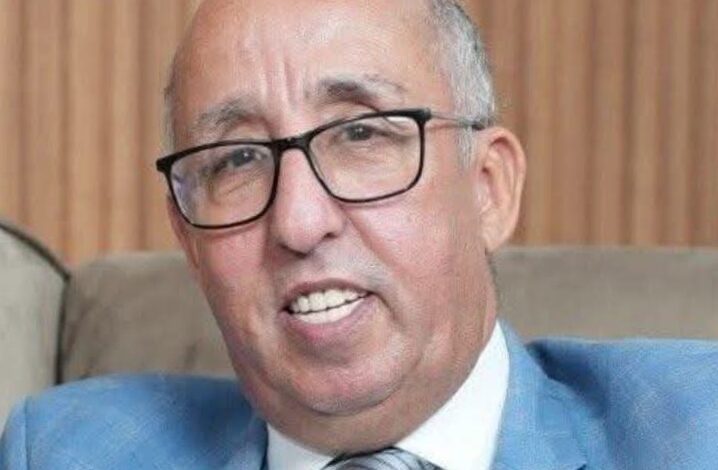بقلم: الأستاذ مصطفى المنوزي
تقديم إشكالي
إذا كان بوسع المؤسسات القانونية والقضائية أن تفحص شرعية الممارسات والقرارات الإدارية استنادًا إلى مقتضيات القانون، فإن المجال الثقافي والمعرفي يظل محرومًا من آلية مماثلة. هنا يطرح سؤال حرج: من يفتحص من، أو ماذا؟
لم يعد مشكل الأمية والجهل التقليدي هو التحدي الوحيد؛ إذ برزت معضلة جديدة أكثر خطورة تتمثل في الغش والتدليس وبيع الشهادات، ما أدى إلى تضخم نخب شكلية تملك أوراق اعتماد فارغة من المحتوى الفعلي. هذه الظاهرة تهدد مصداقية المؤسسات التربوية والجامعية، وتُلقي بظلالها الثقيلة على الأداء المؤسساتي للدولة والمجتمع.
أولاً – المفارقة القائمة
القانون يراقب السلوك الظاهر (قرارات، ممارسات، إجراءات).
بينما يتطلب المجال المعرفي آلية تقيس المصداقية، الكفاءة، والنزاهة العلمية.
النتيجة هي حضور “أمية مقنّعة” أخطر من الأمية التقليدية، لأنها تضفي الشرعية على زيف الكفاءة، وتمسّ بمبدأ العدالة المعرفية داخل المجتمع.
ثانياً – الرأسمال اللامادي وحماية المال العمومي
لقد أصبح واضحًا أن الرأسمال اللامادي والمعرفي لا يقل أهمية عن الرأسمال المادي والمالي. فغياب النزاهة العلمية وتفشي الشهادات المزورة لا يؤدي فقط إلى إضعاف الثقة في المؤسسات، بل يترجم عمليًا إلى هدر للمال العمومي المخصص للتعليم، التكوين، والبحث العلمي.
إن أي استثمار عمومي في مشاريع تنموية يفقد قيمته ما لم يكن مؤطرًا بكفاءات حقيقية ومعرفة صادقة، لأن غياب ذلك يقود إلى قرارات غير رشيدة وإلى فشل استراتيجيات التنمية.
ثالثاً – المساس بمبدأ تكافؤ الفرص الدستوري
إن تضخم الشهادات المزيفة ومنح الاعتراف لأشخاص لا يملكون كفاءة فعلية يشكل خرقًا مباشرًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يضمنه الدستور، ويُفرغ مبدأ الاستحقاق من محتواه.
فالذين تعبوا واجتهدوا للحصول على كفاءات حقيقية يجدون أنفسهم في موقع تمييز سلبي أمام من “اشتروا” مكانتهم. وهذا الوضع يضعف الثقة في المؤسسات ويقوّض العدالة الاجتماعية.
رابعاً – من يملك حق الإفتحاص؟
الدولة وحدها لا تكفي، لأن صلاحياتها محصورة في ضبط الفساد الإداري والمالي.
الحاجة قائمة لإشراك الجامعات، المجالس العلمية والثقافية، هيئات المهن الفكرية، إضافة إلى المجتمع المدني، ضمن منظومة افتحاص معرفي وثقافي مستقل.
خامساً – المداخل الممكنة
1. آلية افتحاص معرفي:
إنشاء لجان مستقلة لتقييم الكفاءات والإنتاجات، ليس على أساس الشهادات فقط، بل اعتمادًا على المردودية العلمية والإبداعية.
2. مساءلة المؤسسات التعليمية والجامعية:
تدقيق مساطر منح الشهادات والاعتماد.
نشر تقارير دورية عن جودة البحث العلمي.
3. ترسيخ ثقافة الاعتراف:
جعل التقدير الاجتماعي مرتبطًا بالإنتاج الفكري والمهني لا بالألقاب الورقية.
4. مسؤولية الدولة:
تطوير سياسات عمومية لمكافحة “الفساد المعرفي” على غرار الفساد المالي، وحماية الفضاء العام من التضليل الثقافي والفكري.
خلاصة
إن حماية الرأسمال اللامادي والمعرفي ليست مجرد قضية ثقافية أو أكاديمية، بل هي شرط أساسي لحماية المال العمومي وضمان تكافؤ الفرص الدستوري.
ومن ثم بات ضرورياً إرساء رقابة مضاعفة:
* رقابة قانونية لضبط الفساد الإداري والمالي.
* رقابة معرفية لفرز القيمة الحقيقية من الزيف.
إن الرهان اليوم هو الانتقال من منطق شرعية القرار إلى منطق شرعية المعرفة، بما يضمن مصداقية النخب، ويحمي الاستثمارات العمومية من الهدر، ويحصّن المجتمع والدولة من عواقب “التضليل الأكاديمي” و”التزييف الثقافي”.