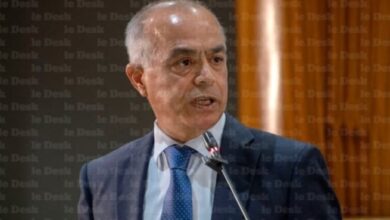أرضية ندوة ” الاقتصاد المغربي وإشكالية الربط بين السلطة والمال “
ينظم الحزب الاشتراكي الموحد فرع الصخيرات-تمارة ندوة بعنوان : الاقتصاد الوطني واشكالية الربط بين السلطة و المال بمشاركة الأساتذة:
-الاستاذ عبد الواحد حمزة أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الحسن الثاني المحمدية .
-الاستاذ و الخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني .
الندوة من تسيير العلمي الحروني عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد.
يوم السبت 23 أبريل 2022 على الساعة التاسعة مساء بمقر الحزب الاشتراكي تمارة .
في ما يلي أرضية الندوة السياسية المفتوحة :
كل معالجة سليمة لمكان ووظيفة وبنية الاقتصاد المغربي تتطلب وضعه في إطار ماكروقتصادي – سياسي وتاريخي، الظرفي منه والهيكلي، إذ أن تلك الخصائص لا يمكنها أن تقتصر على أثر الحالة الراهنة لجائحة كورونا 19 وتحوراتها المتعددة فقط، ولكنها تطول إلى قياس الأثر الذي يسببه انتماءها لنظام اقتصادي –اجتماعي- ثقافي سياسي متأخر وتابع لدوائر القرار الرأسمالي- العولمي. وذلك فضلا عن الثقل الذي يأتي للإنتاج والتسويق والتوزيع من صلب التاريخ والواقع المتخلف، وإن بأشكال ودرجات جديدة ومتراكبة توصم سلوك الفاعلين في الدورة الاقتصادية والاجتماعية بسلوكات بعيدة عن العقلانية الليبرالية الاقتصادية والسياسية، وتؤثر بالسلب على دوام التوازن الاقتصادي والاستقرار.
وتجدر الإشارة إلى العلاقة الخاصة والمتميزة بين الدولة–المخزن والمقاولات، فضلا عن بنيات وأقسام الرأسمال والعلائق فيما بينها، إذ لتلك السلطات باع في الأمر والنهي والمراجعات الضريبية والحَرْكات والتتريك، وتهريب المعادن والعملات، وغير ذلك. أليست هي الفاعل الاقتصادي والسياسي، المركزي، الجابي والزبون الأول، المبادرة والحامية والمشجعة والمصاحبة (…) ما يعج به تاريخ وواقع الأحداث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبلادنا؟
ومعروف أن القطاع الغير المهيكل في المغرب يكتسح نسبة طاغية، كما أنه منفلت من أداء الضرائب ومن بروتوكول مراقبة الجودة، الخ. وللعلم فهو موجود ليس فقط في الأنشطة المعيشية الصغيرة والأصغر، وإنما أيضا وأساسا في الأنشطة الكبرى المدرة لأرباح خيالية وفي شبكات وطنية وعابرة للحدود ومفترسة في مجال صرف العملات وتهريب الأقمشة المستعملة وقطع الغيار المستعمل/ الخردة. إنها تحول المعونات والمساعدات الخيرية إلى بضائع تنافس المنتوج القانوني، محليا كان أوأجنبيا، خاضعا لحقوق الديوانة.
وفي أحسن الحالات يكون “اقتصاد الليل” والرشوة والفساد والتهريب أداة موصوفة ومعتمدة لضبط الأسواق ولتمكين “الاقتصاد- التجارة الدولية والمحلية” من توازنات للنظام الرأسمالي- الكوكبي. ومن غريب الأمور أن يسمح تبييض الأموال ببناءعمارات/ منشآت تضل مقفلة إلى حين أو دور رفاه تنشط في مجال الدعارة وخدمات السياحة المتنوعة والمشبوهة! وغريب أن تقدم -عن حق أ وباطل- هذه العروض “دفعة أكسجين” للدورة الاقتصادية – التجارية المغربية والعالمية! وغريب أن يشوب جزء من “الرأسماليين” من رجال ونساء أعمالنا – في مجال التهريب بمسوخ وشبهات “الوطنيون الجدد”!
بشكل خاص وضعت ظرفية كوفيد 19 كافة قوى الإنتاج على المحك، إذ أوجدت فرصا غير منتظرة ومدرة لأرباح كبرى. وهو ما يستدعي التمييز بين مقاولات وطنية/ مواطنة “حقة” وأخرى تلعب في الماء العكر، وبين نوع المقاولات، قطاعاتها وأنشطتهاالواضحة والمستورة، وأحجام شباكتها وامتداداتها المختلفة، الخ. ذلك أن أنشطة اقتصادية واجتماعية بعينها تضررت، كأنشطة السياحة والترفيه والاستهلاك الباذخ، وما يحيط بها، في الحاشية، من مأكولات خفيفة ومقاهي ومطاعم (…). هكذا فالمقارنة الحدية للإفلاس، هنا وهناك، ستسمح نسبيا باستصدار ملاحظات حول فوائض أو مسالب معدل الخلق للمقاولات. فهناك من الخبراء من شكك حتى في أن تعبّر أرقام المكتب عن تطور حقيقي للاقتصاد المغربي، رغم ظروف الجائحة.
إن الذي يدعو إلى الاعتبار صراحة هو الإطار العام الذي يربط بين المقاولة الخاصة، ذاتية كانت أو معنوية، والدولة (ولعلو فتح الله، 2001). إننا نرى أنها تقوم وتفعل على وقع تعامل “الدولة- المخزن” معها، وكل المشكل يكمن في غياب الوضوح الكافي لهذا التعامل وكذا نقاط الظل التي يُبقى عليها فيه، وذلك عبر الزمكان المغربي والإقليمي والدولي العميق والطويل. هكذا فبقدر ما يجب أن يهتم به التقييم/ التحليل بخلق المقاولات يجب عليه أيضا الاهتمام بإفلاس بعضها.
كما يجب أيضا التساؤل عن أسباب ذلك، وهوما يمكن أن نجده في الظرفية الحالية لكوفيد 19، لكن بالأخص يمكن تعقبه في بنية الاقتصاد والمجتمع العميقة الممتدة في التاريخ القريب والبعيد، نسبيا، أي في الاختيارات الكبرى لبلادنا. إن الأمر يدعو صراحة إلى التساؤل عن مكانة المقاولة في النسيج الاقتصادي المغربي وفي أبعاد السياسة الاقتصاديةلـ”دولة –المخزن”، أو ضمن الاقتصاد المخزني، وكذا هل من إرادة سياسية حقيقية لإطلاق سراحها الليبرالي من عقال سلطة مشدّدة !؟
والملحوظ أن الحوار والنقاش الوطني لم يولي حقيقة اهتماما خاصا للمقاولة الخاصة إلا بداية الثمانينات، مع اعتماد التقويم الهيكلي ومسلسل الخصخصة وإبداء رغبة في الاندماج في العولمة، بتشجيع الحرية الاقتصادية والمبادرة الحرة، الخ. لقد جاءت ظرفية كوفيد 19 لتضع هذا الاختيار/ الادعاء الهش تحت المحك ولتسائل جدوى التدخليةللـ”دولة/ المخزن” في تحريك الاقتصاد والمجتمع.
ومن هنا يمكن إيعاز فشل اقتصاد السوق على مستوى رهانين: المستوى الهيكلي المرتبط بالاختيارات الأساسية لبلادنا ومدى إنجاحها، والمستوى الآني المرتبط بالجائحة وعولمتها وأثر الحروب (أوكرانيا – روسيا)، وسابق التوترات في الشرق الأوسط والعالم (…). فكثيرا ما نربط إفلاس مقاولاتنا الخاصة بطبيعة المحيط الاقتصادي والسياسي والثقافي للمقاولة الحرة (تتريك – حَرْكات – رشاوي – ريوع، تبييض، قرصنة، صعلكة ومروق، ابتزاز و”خلق ملفات”،…)،أو في سوء التدبير والمصارفة، أو إلى انخفاض هوامش المردودية (غلاء الموارد…) لدى بعض الشركات الهشة وانخفاض النشاط الاقتصادي –عموما- تحت طائلة الأزمةالنيوليبرالية العالمية منذ 2008، على الأقل.
ويمكن الإشارة إلى طائلة كوفيد 19، وضعف السيولة وما ارتبط بكل هذا من أسباب غير منتظرة ولا يقينية تعاظمت مع غياب الوضوح في الأفق المنظور، وطنيا ودوليا، والتمادي في إشعال التوترات في إفريقيا وشمالها والشرق الأوسط وآسيا، حول مناطق النفوذ وملكية الأرض والطاقة والمعادن في العالم (أوكرانيا، اليمن والعراق وسوريا وفلسطين…). والحقيقة أن هناك أسبابا عميقة لإفلاس المقاولات الحرة مرتبطة بطبيعة النظام المخزني للاقتصاد والمحاصصة والزبونية والفساد، ومدى قدرتها الفعلية للاندراج الناجع في السوق الدولية والعولمة المتوحشة.
على مستوى الاقتصاد العام (وليس العمومي فقط)، يمكن التساؤل عن مكانة/بنية/ وظيفة المقاولة المغربية في الترسيمة الاقتصادية الكلية ومدى إعاقة تحررها ودرجة تخلفها أو تبعيتها ومدى انخراط “الدولة – المخزن” في تنشيط الاقتصاد في شموليته، وذلك ما يتطلب مساءلة الفاعلين الاقتصاديين – الاجتماعيين: الدولة نفسها والمقاولات والعائلات وعالم المال، وكذا الخارج، إذ لكل منها وظيفته البنيوية التاريخية الخاصة والمرتبطة بباقي سلوك الفاعلين، وطنيا ودوليا، وهي بالتالي، من حيث النموذج النظري جلب الضرائب وصرفها للصالح العام، الإنتاج، الاستهلاك وتحصيل الفوائد والقروض والتسويق الداخلي والدولي (…). أما واقع الأمر فيشهد على ركود هائل للدورة العصرية، ولكثير من الاختلالات الوظيفية ولتراكب وضعف الإلتقائية والإنتاجية الوطنية.
أراد المغرب أن يجعل المقاولة – القطاع الخاص في صلب العملية الاقتصادية لكن على ما يبدو فقد اعترت إرادته الكثير من المعوقات الموضوعية والذاتية، مما جعل الاقتصاد السياسي المغربي في المدى الطويل يشكو من “متلازمة النمو والثقة والريبة” (المصباحي كمال، 2017)، والحال أن النمو عانى ولا زال من تأثير الإصلاحات الاقتصادية النيوليبرالية (السعيدي سعيد محمد، 2013). ذلك ما يجعل المغرب في حاجة ماسة مستمرة إلى الاستثمار لتوطيد أواصر الثقة/ الصورة، وهو ما يتطلب إرادة سياسية واضحة (المصباحي كمال، نفس المرجع)، وسيؤثر على طبيعة وأنواع وأشكال نسبة الاستثمار الوطنيفي الناتج الداخلي الخام.
وعلى ما يبدو أيضا فإن جائحة كورونا أرجأت التعويل عليها، مرة أخرى، إلى حين آخر، وكأن بها “لعنة أصلية” واكبتها منذ الولادة، ثم أن ذلك به نوع من الالتباس والتردد في سلوك “الدولة – المخزن”، من حيث المساعدات المالية، والحديث المتلعثم عن “دخل الكرامة” (…)، وعن الدولة الاجتماعية – ولو عبر مدخلها الأساس/ الحماية الاجتماعية، درءً لتغول الرأسمالية المتوحشة ورفعا لحائط أو خيط يحمي المقاولات الصغرى والأصغر وباقي أصحاب الأنشطة الغير المهيكلة من شرها، إيذانا بإعمال “دولة الحق والقانون”، وليس بالأداة السافرة لخدمة طبقة/ طغمة مهيمنة بعينها!
ففي الماضي كانت المقاولة غائبة تماما، بالرغم من الطابع الليبرالي للخطاب الرسمي المصاحب للسياسة الاقتصادية لبلادنا. والحقيقة أنها لم تأخذ المكانة اللازمة لها منذ الاستقلال، مرورا بحقبة الحماية الفرنسية/ الاستعمار، إلى اليوم، والذي صراحة ساهم منذ انغراسه في تربة المغرب في نشأتها وتطورها.
ويجب التأكيد على المنعطف النيوليبرالي الذي وصل إلى الباب المسدود بعد أن شجع الدولة في البداية من الانسحاب من السياسات الاجتماعية، مما جعل النيوليبرالية تدخل مرحلة ثانية في التسعينات، بإعادة الاعتبار للدولة كعامل للتنمية وأداة ضرورية لخلق إطار مناسب لها (بيك. ج Peck J وبرينرن.ن 1999، العولمة كإعادة أقلمة…).
فمنذ الاستقلال إلى الآن، ومع الجائحة بالذات، كانت “الدولة – المخزن” بالذات ولا زالت هي المبادرة وهي المؤطرة، وخاصة هي الحامية للاقتصاد ككل، وهي المهيمنة عليه تماما. فكم من تفويتات للقطاع الخاص تمت مقابل درهم رمزي، وهوما ساهم حقيقة في صعود وتوسع وتنوع مجالات تدخل المقاولة المغربية الشبه – عصرية، ولوظلت تحت هذا الغطاء الزجاجي/ الوصاية الذي يحد من انطلاقها وإطلاق مغامراتها وتسْييدلبراليتها (…) وتطورها.
وكثيرا ما تورطت السلطات المحلية في خدمة المصالح الخاصة، وهو أمر ليس بنادر وإنما هو متواتر (كما لاحظت ذلك بوشانين نافيز.ف 2002) وكثيرا ما ينفضح أمر ادعاء خدمة الصالح العام، فيما لا يخدم “الخطاب الاجتماعي”/ “الدولة الاجتماعية” إلا مصالح الخصخصة وثلة من المحظوظين وطمس الحقائق وغضب الناس وإقصاء الفقراء من ذوي الحقوق وقمعهم وجرهم إلى المحاكم (…).
وكم من مرة عملت وزارة الداخلية على تيسير صيرورة تلك الخصخصة وبيع الأراضي العقارية، دون موافقة أهلها وفي إرغام تام للنواب على قبول الأمر الواقع. وذلك قصد تفكيك المجموعات الإثنية المقاومة والصامدة، وجعلها في حل من أمرها مع مرور الزمن. وهكذا يتم تحويلها – بعد نزع ملكياتها المشاعية وفكّ اعتصاماتها واحتلالاتها لأراضيها بالقوة – إلى قوة عاملة وغلى سلعة سائغة لعملية التحديث الحضري والاقتصادي النيوليبرالي (انظر هارفي ديفيد 2003، في الامبريالية الجديدة، فرنسا)، وذلك وفقا للخطاطة الرأسمالية المألوفة (كارل ماركس، الرأسمال، المنشورات الاجتماعية فرنسا).
وقد تأتى ذلك لانخراط بلادنا في العولمة، منذ بداية الثمانينات،وذلك في بحث محموم لخلق دينامية لإنتاج ثابت للثورة في المدن (استخلاص الفائض، نزع ملكية الفلاحين الصغار، خاصة منهم داخل المدن الكبرى أو على مشارف الطرق السيارة). والحال أن التغذية متبادلة بين المشروع النيوليبرالي العولمي – ككل، والمُؤطر بتعليمات الهيئات الدولية والسوق المعولم من جهة، وخصوصيات الفضاء المحلي المغربي الهش والمقاوم والموصوم بالتأخر من جهة أخرى، (انظر بوغارت. ك Bogaert. k (سيصدر قريبا)، عولمة السلطوية، المشاريع الكبرى، الأحياء الفقيرة والعلاقات الطبقية الجديدة بالمغرب، منشورات جامعة مينيوسا.
هكذا فخلافا للاعتقاد الشائع فإن دور الدولة – المخزن ليس في تراجع أبدا، بل إنها فاعل أساسي في المشاريع الكبرى، الحضرية منها على الخصوص (إنشاء أو توسيع المدن، مشاريع تسويقية حضرية كبرى لجذب المستثمرين والنخب الدولية، مسجد الحسن الثاني 1986-1993…)، لاسيما من خلال تطوير الوكالات شبه الحكومية التي غالبا ما تشرف على الشراكات بين القطاع العام والخاص.
وبالتالي فإن هدف الدولة – المخزن ليس هو إطلاق العنان للسوق دون تدخل، وإنما هي تهدف إلى دعمه، ومن خلال ذلك الانتقال إلى موقع الفاعل الرئيسي في خلق الأسواق.
إلا أن هذا الشكل المؤسساتي الجديد يقوم بتركيز حقيقي للسلطة لدى وكالات شبه عامة أو خاصة، التي يمكن أن تتوفر على كافة السلطات التقريرية. وبالتالي، فإن إقامة حكامة نخبوية/بيروقراطية على هذا النحو، يثير مسألة الشرعية الديمقراطية لتلك الهيئات التي لا تحترم شرط التمثيل الشعبي ولا توفر أي إمكانية للمراقبة الديمقراطية (انظر سوينجداون وآخرون في كتاب التحضر النيوليبرالي في أوروبا، مذكور في مقال سورية الكحلاوي (2018)، “باسم الحداثة، سلب أراضي الفلاحين الصغار والتحضر…”.
وفي الأخير، لا شك أن هناك أواليات تمكن الديمقراطية والمصلحة العامة من أن تراقبا الرأسمالية والنزوع نحو المصالح الخاصة (بيكيتي طوماس، 2013)، فهل استطاع اعتماد “الخيار الديمقراطي”، رابع ثوابت الدستور المغربي (2011)، أن يراقب ويلجم وينزع عن اقتصادنا الوطني آفة/ آليات الحكم بالريع والقطاع الغير مهيكل ونزوع النظام السياسي نحو خلط أوراق السلطة / النفوذ بالمال والأعمال والاقتصاد المخزني؟